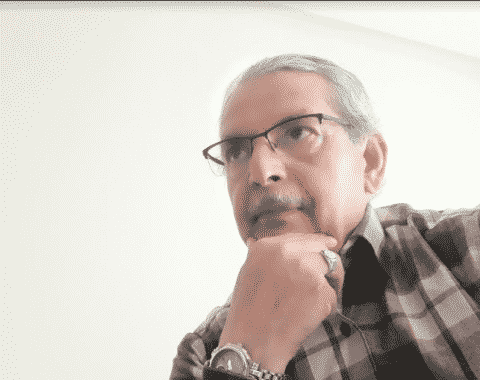بعد تعليقِ أضحيةِ عيد الأضحى في المغرب لهذه السنة (2025ه1446م) كما جاء في الإهابة التي تَوَجّهتْ بها الدولة بتاريخ 26 فبراير إلى عموم الشعب المغربي وقد استند القرارُ الذي تلاه وزير الأوقاف على التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، بَرَزَتْ للعيان الكثير من السلوكيّات الغرائبيةِ التي تطرح تحدِّيا كبيرا في اعتقادنا أمام النظريات الاجتماعية، والحقول المعرفية الإنسانية والأنتثروبولوجية وما تراكم داخلها من أدوات إجرائية لفهم وتفسير هذه السلوكيات النفسية والاجتماعية المغربية التي أصبحت تنغرس شيئا فشيئا في السلوك اليومي وفي دنيا الناس. ففي الوقت الذي استجابت فيه شرائح اجتماعية عريضة لنداء الوطن، ورحبت بالقرار لأنه يخفف عن جيوبهم وطأة الأثمنة السّاعرة لرؤوس الأضاحي وما يستتبع ذلك من ضيق واستدانة ولاسيما مع اقتراب الصيف، أصرّت فئات أخرى عن سَبْقِ شهوةٍ اجتماعية على ممارسة “شعيرة الكبش” إن جازت تسميتها كذلك، فالذي يظهرُ من خلال الفيديوهات والصور التي انتشرت في وسائل التواصل أن “نداء الدوارة” انتصر على “نداء الدولة”، وغَلَّبَ الناسُ منطق العادة المستحكمة على صوت العقل، فقد تحولت العادة إلى عقيدة اجتماعية لا تسقط بالتقادم رغم الظروف الاقتصادية الخانقة التي تَمُرُّ بها غالبية الطبقات الاجتماعية المغربية وهو ما يدعو فعلا لدقّ ناقوس الخطر أمام هذا التحول القيمي الكبير للمغاربة الذين تحولوا لكائنات استهلاكية بامتياز في زمن العولمة. نتساءل: هل تسعفنا اليوم النظريات السوسيولوجية لفهم هذه الظواهر العصية والمعطيات الاجتماعية “الساخنة” التي تتسم بالكثير من الغرائبية والتركيب في الإنسية المغربية؟ هل مظاهر اللهفة اللاعقلانية التي تتبعناها جميعا هي سلوكيات قديمة عرّتها (السوشل ميديا) وخرجت من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل بالتعبير الأرسطي زمن الرقمنة والصورة بعدما صَيَّرتنا الرقمنة والسيبيرانية الحديثة كائنات عارية على حد تعبير السيميائي المغربي سعيد بنكراد؟ ألا يؤشر الأمر عن خلل ما في البُنَى الذهنية لهذه الإنسية المغربية وهو ما يستوجب –لا شك- نقاشا أخلاقيا وتربويا وحقوقيا عموميا مفتوحا وجريئا من أجل النقد والتشريح والتقويم؟ ألا تتصادمُ السلطةُ الاجتماعيةُ والدينيةُ والسياسيةُ من خلال ما طبع سلوك بعض المغاربة في هذه المناسبة؟ هل نعيش أزمة وعي؟ أم أننا ضحايا عادات ترسّخت حتى غلبت كل حكمة وتعقّل؟ في كل الأحول يبدو أن شعيرة الكبش انتصرت، وفقدنا جميعا جولة جديدة أمام “دوارة العيد”.
إن هذه السلوكياتِ الغرائبيّةِ التي برزت من خلالِ تَهَافُتِ الكثير من الفئاتِ الاجتماعية ولاسيّما الهشّةِ منها على أحشاء الخروف (الدوارة)؛ من خلال ما رصدناه من مشاهدَ حية، بل والبحث عن الخروف وذبحه قبل حلول وقت الشعيرة الدينية الإبراهيمية يطرح الكثير من التساؤلات حول حقيقة التدين في السلوك المغربي وجوهره الروحاني الحقّ. وإشكالية ممارسة الشعائر الدينية.
إن هذا السلوك الاجتماعي (الازدحام عن الدوارة وذبح الخرفان قبل العيد) يطرح تداخلا معقدا في نظرنا بين الطقوسي والاجتماعي والديني والرمزي والأنتروبولوجي والاقتصادي، ويؤكد أن الفرد في حاجة وجودية للطقس والرمز ليحيا ويستمر ويثبت انتماءه رغم الهشاشة الاقتصادية التي قد يعيشها. ولعل هذه اللهفة المحمومة من أجل توفير اللحم في العيد هناك من استغلها من تجار الأزمات لبيع لحم الحمير في مشاهد في منتهى الفداحة والتقزز.
⦁ علاقة المغاربة بالعيد :
إن العلاقة السيكولوجية التي تربط المغاربة “بالعيد الكبير” هي أكثر من علاقة دينية، وأداء شعيرة بوصفها سُنّة مؤكدة تسقط عن غير القادر. وتسميته بالكبير فيه أكثر من دلالة، فما يجمع المغاربة بهذه المناسبة من طقوس رمزية، واحتفالات اجتماعية يجعل منها فرصة للالتحام والاحتفال والاجتماع العائلي، فهي علاقة تتسم بالكثير من التعقيد والتركيب. ولعلها المناسبة الدينية التي لا زال المغاربة يقطعون من أجلها مئات الكلمترات من أجل اللمة العائلية، كما أنها فرصة كذلك “للتباهي الاجتماعي” وإثبات الذات رغم العِوَز، فالذي لا يستطيع إحضار الكبش لعياله ليس رجلا، بحيث يتداخل الطقس الديني بمعنى اجتماعي حساس وهو “الرجولة” والقدرة والشرف، فالعاجز “معندوش”. ولذلك سجلنا في أكثر من مناسبة تَكَلّف المغاربة، وبيعهم لأثاثهم المنزلي، ولضرورياتهم اليومية من أجل شراء كبش العيد ولاسيما الأب ذو العيال. كما رُصدت أرقام تؤشر بقوة على تنامي “ظاهرة الانتحار” عند اقتراب هذه المناسبة بسبب العجز عن توفير خروف العيد. وكأن العجز صار مقرونا وموسوما “بالعار الاجتماعي” !
فما نرصده من خلال هذا التتبع بالصورة التي -أصبحنا نتنفسها كما نتفس الأكسجين كما قال أحد خبراء علم التواصل – لهذه السلوكات الاجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي التي صارت كَشّافَة تفضح وتعري الكثير من المستور، يتضح أن الأضحية ليست مجرد واجبٍ دينيّ فحسب، يُمَارَسُ من باب الامتثال الدينيّ، وتطبيقا للسنة الخليلية، بل صارت طقسا اجتماعيا مُترعًا بالدِّلالات، ومُثْخَناً بالمجازات والحمولات الرمزية والطقوسية، ويؤسّس للحظة استثنائية في المخيال الجمعي المغربي، فزمن العيد في الوعي الاجتماعي يمنح للأسرة موقعها داخل النسيج الاجتماعي، وهو ما يمكن أن نفسر به هذا “التهافت اللاعقلاني” من أجل امتلاك الخروف، أو شيء من الخروف: كبده أو كرشه حتى تجاوز ثمن أحشائه 700 درهم. وهو ثمن غير مسبوق في السوق بسبب هذه “اللهطة”.
⦁ كبش العيد، أكثر من مجرد حيوان للذبح:
إن ما يتناسل من سلوكيات في هذه المناسبات وغيرها يؤكد عنصرا بنيويا ثابتا في “الهندسة الاجتماعية”- إذا استعرنا هنا تعبير الراحلة فاطمة المرنيسي من إحدى كتبها- وهو أن الإنسان كائن رامز كما عرّفه الفيلسوف كاسيرر، بوصفه الكائن الوحيد الذي يوظف الرمز ويتواصل من خلاله، كما يعيش بالرموز، ويبدو أنه من الصعوبة بمكان أن يتخلى الإنسان عن طقوسه ورموزه ولاسيما الدينية منها التي انغرست في كيانه وبنياته العميقة والوجدانية للحدّ الذي لا يمكن القفز عنها بسهولة أمام كل قراءة أو تحليل.
إن هذا الكائن البشري القادم من بعيد وهو يحمل فأسه بعدما كان يلتقط الثمار، ويعيش حالته الطبيعية وصولا إلى الحضارة الذكية اليوم ظل يحمل على ظهره لحظاته التاريخية بعبارة فيلسوف الجدل هيكل، وظل متأبطاً لرموزه، بل لم يتوقف عن خلق هذه الرموز. وتبقى “للرمز سلطته” كما أكد ذلك السوسيولوجي الفرنسي بير بورديو؛ من خلاله كتابه “الرمز والسلطة”؛ سلطة الرمز التي تصير قاهرة في الكثير من الأحيان، ولذلك يمكن أن نقول بالكثير من المجازفة أن المغاربة -والحالة هذه- تصادمت وتصارعت هذه السلطة الرمزية الاجتماعية، وما تعنيه الأضحية في مخيالهم الجمعي بعدما صارت ضاغطة على الأسر وربما خوفا على الهوية والانتماء، وخوفا من الوصم والعار والعجز كما مرّ، وقد سجلنا الكثير من حالات الطلاق في سياقات سابقة بسبب هذا العجز الاجتماعي، ولعل المشاهد السوريالية التي لا زالت تحتفظ بها ذاكرتنا الجماعية في هذا الباب كثيرة يكفي التمثيل لها فقط بما حدث في السنة الماضية في إحدى أحياء مارتيل بعدما أخذ أحد الأفراد كبش العيد ورماه من أعلى سطح المنزل وسط ذهول الجميع، عندما تشاجرت معه زوجته لأن خروف العيد لم يرقها لصغره. فالسلطة الاجتماعية للطقس حاضرة وضاغطة ولا يمكن أن ينكرها أحد.
⦁ سلطة الرمز فوق كل السلط:
إن الكبش/ الرمز يحمل أبعادا اجتماعية وثقافية وروحية عميقة وهو الأمر الذي يجعل التخلي عنه أمرا صعبا حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة وهو ما يجعل منه سلطة اجتماعية تمارس ضغطها الرمزي الخفي، هذه السلطة يبدو أنها تتصادم مع السلطة الدينية كذلك، فمن منظور ديني تبقى هذه الشعيرة الابراهيمية سنة مؤكدة على المستطيع، أما غير القادر فتسقط عليه تلقائيا ويرفع عنه الحرج، دون أن يحتاج لمن يمنح له الرخصة السياسية أو الدينية. فهل امتثل المغاربة للجانب الديني في أضحية العيد في حالة العوز وعدم الاستطاعة؟
كما أن السلطة الاجتماعية الضاغطة لخروف العيد في -هذه الحالة- يبدو أنها تصادمت مع السلطة السياسية كذلك التي دعت إلى التعليق بعد سنوات الجفاف المتتالية للتخفيف على جيوب المغاربة كما تَقَدَّم.