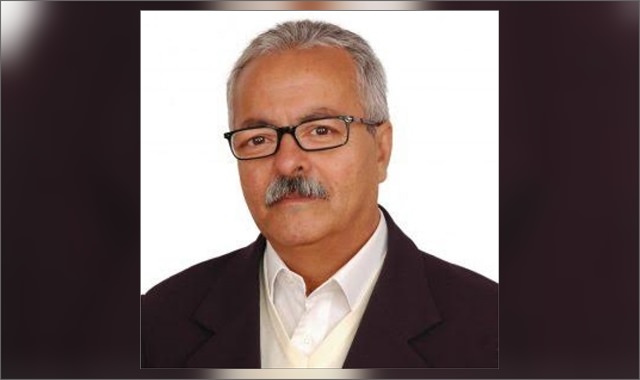لطالما شكّلت الفوارق المجالية واحدة من أبرز الإشكالات التي تواجه السياسات التنموية في المغرب، حيث ظلّ التفاوت بين المدن الكبرى والمناطق النائية قائما على مستويات متعددة: من البنية التحتية، إلى فرص الشغل، إلى الخدمات الأساسية. وفي ظلّ استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، يُطرح سؤال استراتيجي: هل يمكن للمونديال أن يُصبح مدخلًا حقيقيًا لتقليص الفجوة المجالية بين الجهات؟
إنّ عدالة توزيع عوائد المونديال ليست ترفًا تنمويًا، بل شرط من شروط نجاح هذا الحدث على المدى البعيد. فكيف يمكن جعل هذا الحدث الرياضي العالمي مشروعًا مجاليًا مندمجًا؟ ما السبل الكفيلة بربط القرى والمناطق الطرفية بدينامية الحدث؟ وكيف نضمن ألا تظل الاستثمارات الكبرى حكرًا على المراكز الحضرية وحدها؟
أسئلة جوهرية تفتح الباب أمام نقاش واسع، تتقاطع فيه الرياضة بالتنمية، والبنية التحتية بالعدالة الترابية.
أولًا: تنظيم متعدد الأقطاب .. لا مركزية الحدث وعدالة التوزيع
إن إحدى نقاط القوة في مشروع تنظيم مونديال 2030 بالمغرب تكمن في تعدد المدن المحتضنة للمباريات، ما يُتيح من الناحية النظرية إمكانية توزيع الاستثمارات على عدة جهات. لكن التحدي الحقيقي لا يكمُن في مجرد التعدد الجغرافي، بل في تحقيق لا مركزية حقيقية للحدث، تكون منسجمة مع مقومات كل جهة.
فالرهان يكمن في ألا يُختزل التنظيم في مدن الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، وفاس، ومراكش، وأگادير، وإنما يمتد ليشمل مدنًا ذات إمكانات متوسطة، أو حتى قرى محيطة بالملاعب، من خلال استثمارات داعمة للبنية التحتية المحلية، وتشجيع السياحة القروية، وإنشاء منشآت مجتمعية تستفيد منها الساكنة قبل وبعد الحدث.
تكمن أهمية هذه الرؤية في كونها تُرسّخ منطق العدالة الترابية، حيث لا يُنظر إلى الجهة فقط بوصفها فضاءً لتمرير التظاهرات الرياضية، بل ككيان اجتماعي واقتصادي يتطلب تعزيز قدراته وتمكينه من أدوات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تبرز ضرورة إشراك الجماعات الترابية في مراحل التخطيط المسبق للحدث، وتمكينها من الآليات المالية والمؤسساتية التي تجعلها فاعلًا رئيسيًا في تحقيق التحول المجالي المنشود، وتعزيز التملك المحلي لمخرجاته التنموية.
ثانيًا: البنية التحتية القروية .. من الهامش إلى الواجهة
عادةً ما تركز التظاهرات العالمية على المراكز الكبرى من حيث شبكات الربط الطرقي، والبنيات الفندقية، والمرافق الرياضية، في حين تظل المناطق القروية والجبلية أو الصحراوية على الهامش، تؤدي دور الخلفية الصامتة في مشهد الحدث. إلا أن تنظيم مونديال 2030، بالنظر إلى الخصوصيات الجغرافية للمغرب، يتيح فرصة لاعتماد مقاربة تنموية شمولية تضع البنية التحتية القروية في صلب الاهتمام، باعتبارها رافعة استراتيجية لتقليص التفاوتات المجالية وتحقيق عدالة ترابية فعلية.
فعلى سبيل المثال، يمكن إدماج القرى المتاخمة للمدن المحتضنة للمونديال من خلال تعزيز شبكات النقل الجهوي، وتحسين الربط الرقمي، وتوسيع شبكات الماء والكهرباء، بما يضمن تكاملًا مجاليًا فعّالًا. كما يُمكن استثمار الدّينامية التمويلية التي يتيحها الحدث لإحداث مؤسسات تربوية وتكوينية في الأوساط القروية، تُعنى بمجالات الرياضة، والسياحة الإيكولوجية، والتكوين المهني، بما يساهم في خلق فرص تنموية مستدامة وتعزيز الجاذبية المجالية لهذه المناطق.
إن هذا التحول يقتضي توفر إرادة سياسية صادقة، ورؤية تنموية شمولية تتجاوز اختزال المونديال في كونه مجرد لحظة احتفالية عالمية، لتُعيد توجيه السياسات نحو أولويات أكثر عمقًا واستدامة. فالاستثمار في الوسط القروي لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره عبئًا ماليًا أو مجاملة ظرفية، بل يجب إدراكه كخيار استراتيجي محوري، إذ إن تنمية القاعدة المجالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز صلابة البنيان الوطني وتحقيق تنمية متوازنة وعادلة.
ثالثًا: الإدماج الثقافي والرمزي للهوامش .. من تهميش الواقع إلى تمثيل الذاكرة
لا تقتصر العدالة المجالية على الأبعاد البنيوية والاقتصادية فحسب، بل تنطوي أيضًا على أبعاد رمزية وثقافية. فالعديد من المناطق المهمشة تعاني من الغياب أو التمثيل النمطي في وسائل الإعلام، وفي السرديات الرسمية، وفي مظاهر الاحتفال بالهوية الوطنية. وفي هذا السياق، يُمكن أن يشكّل مونديال 2030 مناسبة استراتيجية لإعادة إدماج هذه الفضاءات ضمن التعبيرات الثقافية والفنية المرافقة للحدث، بما يعزز حضورها الرمزي ويُسهم في تصحيح تمثلاتها داخل الوعي الجماعي، بوصفها مكونات أصيلة من الذاكرة الوطنية المشتركة.
فمن خلال تنظيم مهرجانات فنية وثقافية في القرى والمناطق النائية، وإدراج التراث المحلي ضمن البرامج الرسمية المرافقة للحدث، إضافة إلى تمكين الحرفيين والصناع التقليديين من عرض منتوجاتهم أمام جمهور عالمي متنوع، يمكن فتح آفاق جديدة للتعبير الثقافي والاقتصادي. هذا التوجه لا يسهم فقط في إبراز غنى الهوية المحلية، بل يساهم أيضًا في إعادة تعريف موقع “الهامش” داخل النسيج الوطني، بوصفه فضاءً فاعلًا ومُنتجًا، لا مجرد ملحق صامت لمراكز القرار والتنظيم.
كما يمكن تعزيز حضور الهوية القروية العربية والأمازيغية والصحراوية، من خلال إدماج رموزها الثقافية والمعمارية في تصميم الملاعب، وتوظيف موسيقاها وتعبيراتها الفنية في الأعمال الرسمية للحدث، ولا سيما خلال حفلي الافتتاح والاختتام. بذلك، يتحول المونديال إلى لحظة اعتراف جماعي بالثراء الرمزي للمغرب العميق، وبالتنوع الثقافي الذي يُشكّل جوهر الهوية الوطنية. ومن هذا المنظور، تُصبح العدالة المجالية ليست مجرد آلية لتوزيع البنى التحتية، بل فعلًا رمزيًا يكرّس توزيعًا للاعتراف، واعترافًا بالحق في الوجود، والمشاركة، والتأثير في سردية الوطن ومكانته على الساحة الدولية.
ختاما .. حين تُنصف الكرة الخريطة
ليس من السهل تحويل حدث رياضي ضخم إلى رافعة حقيقية لتنمية متوازنة وشاملة، لكن التحديات الكبرى لا تُواجه بالحلول الجزئية أو المؤقتة. فمونديال 2030 يُمكن أن يُمثّل لحظة مفصلية في مسار التنمية المجالية بالمغرب، شريطة أن يُؤطَّر منذ البداية برؤية عادلة ومنصفة، تُراعي التفاوتات المجالية، وتُثمّن الخصوصيات الثقافية والجغرافية، وتُوزّع العائدات والمكتسبات بما يُعيد رسم خريطة أكثر توازنًا وعدالة.
ولذلك، لا يكفي أن تصل الكرة إلى الشباك؛ بل يجب أن تصل ثمارها إلى أعالي الجبال، وعمق الصحارى، وسهول القرى المنسية. فالتنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بما يُشيَّد من ملاعب وبنيات، بل بما يُستعاد من كرامة، ويُزرع من أمل، في حياة الإنسان حيثما كان.
كما عبّر المنظر الاجتماعي والجغرافي ديفيد هارفي في مقاله الشهير “The Right to the City”، فإن: “الحق في المدينة ليس فقط حرية الوصول إلى مواردها؛ بل هو حق تغيير أنفسنا عبر تغيير المدينة.”
وبالمثل، فإن الحق في الوطن هو الحق في المساهمة في تشكيله، وفي أن يكون كل فضاء، مهما كان هامشيًا، جزءًا فاعلًا من مستقبله المشترك.