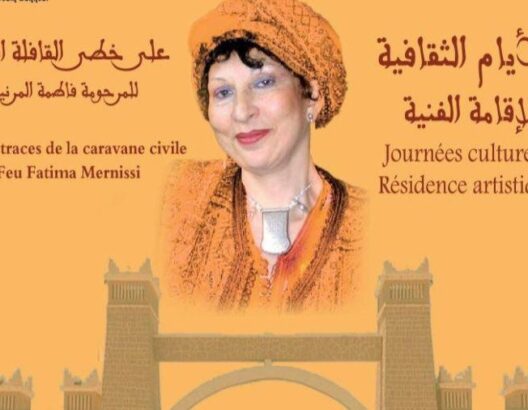بين رجع الماء وهمس الحجارة، تطفو أزمور كذاكرة بعيدة، مدينة في الزاوية الرطبة من التاريخ، عالقة بين أطلال منسية ودفق زمني بلا ملامح، في خاصرتها يجري نهر أم الربيع ببطء، كأنه لا يريد أن يصل.
هنا، في هذه المدينة ذات الصمت العميق، وُلد الفنان التشكيلي بوشعيب الهبولي سنة 1945. لم يكن الطفل يعلم أن الطيف الذي يسكن الجدران، ويحرس أبواب الزوايا، كان يعدّه ليكون واحدا من أكثر الأسماء غرابة وإشراقا في سماء التشكيل المغربي.
طفل يتيم من ملامح الأم، مربوط بيد الأب البنّاء، حيٌّ بكامله يحمل اسم العائلة، “درب الهبولي”، لكن الطفل لم يملك من كل هذا الإرث سوى شعور الغربة، وسؤال الفن المبكر. كان عليه أن يخلع معطف الأب قبل أن يرتدي قميص الفنان، وأن ينزع الطوب عن يديه، ليضع أصابعه في الطلاء، في القلق، وفي المجاز.
كان يمكن لهذا الفتى أن ينام كل مساء على وسادة من يقين، لكنه اختار المجهول. وجاء خبر موت أبيه ليقطع آخر خيط يشده إلى الطاعة. تخلى عن وظيفة التدريس، وعن البيوت، واحدًا تلو الآخر، حتى لم يبق له سوى جسده المتعب، ودفتره القديم، وريشته التي ستقوده إلى المتحف الداخلي للعالم.
بعد سنوات قضاها غائبا عن مدينته أزمور، عاد إليها غريبًا، بهيئة هيبي، وشَعر مرسل، عاد ليصطدم بمدينة لا تعرف معنى أن يُولد فنان في بيتٍ للبنّائين. قالوا عنه مجنون، لكنهم لم يفهموا أن الجنون، أحيانًا، ليس سوى وجه آخر من وجوه الإخلاص للحلم.
وبين سنتي 1958 و1963، أشرف على ورشات للرسم التلقائي في مدينته الأم، واضعًا الأسس الأولى لمسيرته الفنية. وفي عام 1970، نظم بوشعيب الهبولي أول معرض فردي له، معلنًا بذلك انطلاق مسيرته داخل المشهد الفني المغربي.
قرر أن يعيش للفن التشكيلي ومنه، ويخيط من الوجوه المشوهة بورتريهًا للإنسان المعاصر. لم يتلق تكوينا أكاديميا، لكنه حجز لنفسه مقعدًا في ركن مهمل من الضوء، وبدأ رحلته في تفكيك الجمال كما قد يفعل مجنون بقفل صدئ.
وجوهه ليست جميلة. لكنها صادقة. فيها شيء من المرضى في المستشفيات العمومية، من البؤساء في زوايا الأزقة، من النساء المتروكات، والأولاد التائهين، والشعراء الحمقى الهائمين الذين لم يعد لهم ربما وجود في عالمنا اليوم.
من يطالع هذه اللوحات سيلاحظ فورًا ولع بوشعيب الهبولي بالوجه البشري، مشوّهًا، مضغوطًا، سائلا، مكفهرا، بملامح ناقصة، وفم مقطوع أو محذوف، مع خطوط تشبه آثار التعذيب. وكأنه يقول، إن الإنسان كما نعرفه ليس هو ما نراه، بل ما نتهيب من رؤيته.
ورث حيًّا بأكمله، “درب الهبولي”، نسبة لعائلته، وهو من الأحياء المعروفة جدا في مدينة أزمور، كما هو الشأن بالنسبة لـ”درب العروي”بأزمور دائما، نسبة لعائلة المفكر المغربي الكبير عبد الله العروي، لكن بوشعيب الهبولي بدّد هذا الإرث كما تُبدد الحكايات العتيقة. ثم وجد نفسه شريدا بين الرباط والدار البيضاء، يسير حافيًا على حافة الجنون، نائمًا في حضن الأرصفة، مطاردًا بلعنة الذكرى. أصدقاؤه يحكون عنه هذا الفصل بصوت خافت، بعضهم يقول إن هذا السقوط كان ضرورياً، إذ منه انبثقت وجوهه، وألوانه الباهتة، وطائر الحمام. وآخرون يكتفون بالصمت، مع ألم في الوجه والقلب حين يتذكرون ذلك.
من رحم هذه الخسارات، وُلد الهبولي الحقيقي. فنان لا يطلب الاعتراف، لأنه لا يعترف بشيء. كمن يرسم على الماء، متجردًا، خفيفًا. لم يسع إلى الخلود، لكنه صار أيقونة. لا لأنه أراد، بل لأنه لم يرد.
استخدم الأصباغ التي اخترعها بنفسه، مسحوق الجوز، والحبر…، اشتغل على الورق، والحلي، والنحاس، وأي شيء يمكن أن يصير حقلًا للحيرة.
إنه رجل يعيش على حافة الانفجار، يصالح الوجع بالفرشاة، ويخلط كُحل الذاكرة برماد العالم، وبضجيج الصور التي لا تهدأ في رأسه.
في مرسمه المتواضع بأزمور، يستقبل الحياة كما هي، جريحة، نازفة، لكن قابلة للرسم.
يقول الهبولي إن اللوحة ليست مرآة، بل نافذة. ومن ينظر إليها، عليه أن يتورط.
وفي إحدى مقابلاته النادرة، صرح بأنه لا يثق في الفنانين الذين لا يغيرون أدواتهم. فالفن، بالنسبة له، لا يحتمل التكرار.
وفي معرضه الأخير، في ماي 2025، الذي احتضنته قاعة “ألما” في الدار البيضاء، تعرف الجمهور على بوشعيب الهبولي من جديد وبشكل آخر، وكأنه قد رمى بنفسه في بركة ألوان، لقد انبهر المتابعون لمسيرته وطريقة اشتغاله من استعماله للألوان بطريقة لم تعرف عنه أبدا، ألوان زاهية تشمل الأزرق البحري والوردي الحالم، والأخضر الفيروزي … وكأن بوشعيب الهبولي قد تعرف على نفسه من جديد، أو تحرر من شيء ما، أو أقبل عليه. ربما هي مصالحة مع الحياة أو القدر، وربما استسلام للجمال، أو نقده.
أزمور، المدينة التي أنجبته، صارت في النهاية ملجأه الأخير. فيها يقيم الآن، بين النهر والجداريات، بين الحكايات القديمة ومواعيد الورق.
وفي الركن القصيّ من عزلته، اختار رفيقته في الهشاشة، في الصمت، في التأمل الطويل للعالم وهو ينكسر ببطء. حضورها يشبه شبحًا لطيفًا يمرّ بين لوحاته، بين ضوءٍ خافت وظلٍ مرتعش.
تضع يدها على كتفه حين يهبط عليه المساء، وتنسحب حين يستيقظ فيه اللون كريحٍ قديمة. ذرة نورٍ صغيرة، تضيء له المعبر بين الحياة والفن. وتحفظ التوازن الهش بين الجرح والسكينة.
إنه تجربة، حالة، شظية من زمنٍ جريح. فنان عصامي شقّ طريقه خارج المعاهد، اختار أن يظل وفِيًّا لنفسه، وأن يدفع ثمن ذلك وحيدًا.
بوشعيب الهبولي لا يرسم الوجوه فقط، بل يواجه وجهه كل يوم. لا يتوقف عن العمل، ربما لأنه يعلم أن الفن هو نجدته الوحيدة.
إنه الفنان الذي خسر كل شيء وربح الوجوه المشوهة.
(الصورة بعدسة جمال محساني)