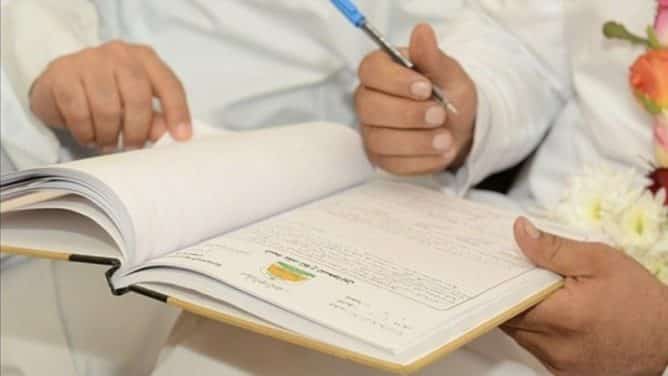منذ فجر الوعي الإنساني، ظلّ السؤال عن أصل المعرفة حاضرًا بإلحاح: من أين يبدأ الإدراك؟ أمن العين التي ترى؟ أم من الأذن التي تسمع؟ أم من القلب الذي يعقل ويتدبّر؟
جاء اللسانيون المحدثون – من فردينان دو سوسير إلى تشارلز ساندرس بيرس – ليؤكّدوا أن اللغة هي مركز الإدراك، وأن الإنسان لا يُفكّر إلا عبر منظومة العلامات التي يتلقّاها ويتداولها.
غير أن القرآن الكريم سبقهم بقرون، إذ صاغ نظامًا معرفيًا محكمًا في ترتيبٍ لا يتبدّل: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 36].
هذا الترتيب الإلهي يمثل نسقا معرفيا دقيقا يضع السمع في مقدّمة أدوات الإدراك، يليه البصر، ثم الفؤاد بوصفه موطن الفهم والتأمل.
في هذا المقال، نسعى إلى قراءة لسانية فلسفية لهذه الآية، تستضيء بنظرية العَلَامة عند سوسير، ومفاهيم السيميولوجيا الحديثة، لنبيّن كيف سبق الوحيُ الفكرَ اللساني في ترتيب الحواس وبناء المعرفة.
السمع بوصفه الأصل اللساني للمعرفة
يرى فردينان دي سوسير أن العلامة اللغوية هي اتحادٌ بين دالٍّ ومدلول، أي بين شكلٍ لغوي (signifiant) وفكرةٍ ذهنية .(signifié)
وفي بدايات مشروعه اللساني، استخدم مصطلحي الصورة الأكوستيكية (الأثر السمعي النفسي) والتصور الذهني، لكنه تخلى لاحقًا عن هذا التحديد الصوتي، إذ أدرك أن الدالّ لا يقتصر على الصوت، بل يشمل كل شكل تعبيري داخل النظام اللغوي، سواء كان صوتًا، أو رسمًا، أو إشارة. فاللغة – في نظره – لا تُعرَّف بالوسيط المادي، بل بالعلاقة الاجتماعية بين العلامات.
وهنا تبرز أهمية التحوّل النظري في فكر دي سوسير نفسه:
تُظهر مخطوطاته (1907–1911)، التي جُمعت لاحقًا في كتابه الشهير Cours de linguistique générale (1916)، أنه انتقل من التصور النفسي الصوتي إلى التصور البنيوي المجرد.
ففي مرحلته الأولى، عرّف العلامة بأنها اتحاد بين “تصوّر ذهني” و”صورة أكوستيكية”، لكنه عاد لاحقًا ليسقط البُعد الفيزيائي للسمع، مكتفيًا بثنائية الدالّ/المدلول ضمن النسق الاجتماعي للغة.
لقد أدرك أن الصوت مجرّد وسيط، لا جوهر، وأن جوهر اللغة يكمن في العلاقة النسبية بين العلامات لا في مادتها الحسية. وبهذا التحوّل، أسّس دي سوسير المنظور البنيوي الحديث الذي جعل من اللغة نظامًا مغلقًا من العلاقات، ومن اللسانيات علمًا مستقلاً بذاته، لا تابعًا للفسيولوجيا ولا لعلم النفس.
مع ذلك، يظلّ السمع هو القناة الأولى التي يتلقّى الإنسان من خلالها الدوالّ، لأن الإدراك الصوتي أسبق من الإدراك البصري.
يولد الطفل فلا يرى العالم في تفاصيله بعد، لكنه يسمع النبرات والنغمات، ويبدأ عقله في تخزينها كبذور لغوية، تتطور لاحقًا إلى نسق دلالي مكتمل. فاللغة تُبنى على إيقاعٍ يُسمَع قبل أن يُرى، والإنسان يتعلم العالم صوتًا قبل أن يتعلّمه شكلًا.
وقد أشار تشارلز ساندرس بيرس إلى أن العلامة السمعية تمتاز بكونها “مستمرة في الزمن”، بينما العلامة البصرية “ثابتة في المكان”، والزمان – كما يقول – أسبق في الإدراك من المكان.
من هنا نفهم أن الترتيب القرآني في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ﴾ [الإسراء: 36] .. ليس ترتيبًا بلاغيًا فحسب، بل بناء معرفيًا دقيقًا؛ إذ يضع السمع في مقدّمة أدوات الإدراك، باعتباره الأسبق في التكوين البيولوجي (فالجنين يسمع قبل أن يرى)، والأسبق في التكوين المعرفي (فالكلمة تُدرَك صوتًا قبل أن تُدرَك شكلًا). إنه الباب الذي تدخل منه العلامة إلى الفؤاد؛ فالأذن هي قناة الوعي الأولى التي تُشعل شرارة الفكر.
ولذلك، لا عجب أن تكون أول علاقة بين الإنسان والسماء صوتًا مسموعًا لا صورة مرئية، كما في قوله تعالى:
﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: 1] .. ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: 164].
فالوحي كان صوتًا قبل أن يكون نصًّا، والكلمة الإلهية كانت تُسمع قبل أن تُرى. ومن السمع وُلدت اللغة، ومن اللغة وُلد الفكر، فكان السمع أصل الكلمة، وكانت الكلمة أصل الوعي.
استطراد لسانـي: ماذا عن الأصمّ؟
قد يسأل سائل: فماذا عن الذي لا يسمع؟ أليس فاقد السمع خارج هذا النظام المعرفي؟
والجواب – لسانياً وقرآنياً – أن “السمع” هنا ليس العضو الفيزيائي، بل القدرة الإدراكية على التلقّي والفهم. فالله تعالى لم يقل: الأذنين والعينين، بل قال: ﴿ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ﴾ .. أي أن المقصود هو الوظيفة المعرفية، لا الأداة الحسية.
ومن هذا المنطلق، فالأصمّ لا يُقصى عن اللغة، بل يُبدع سيميولوجية بديلة – لغة الإشارة – تقوم على المبادئ نفسها التي وصفها دي سوسير: الدالّ (حركة، إيماءة، وضع يد)، والمدلول (المعنى الذهني المصاحب)، والعلاقة بينهما اعتباطية اجتماعية تمامًا كما في اللغة المنطوقة.
فاللغة لا تنحصر في الصوت، بل في القدرة على إنشاء علاقة رمزية بين شكل ومعنى. وبالتالي، فإن فاقد السمع لا يفقد اللغة، بل يُحوّلها من وسيط صوتي إلى وسيط بصري. وهكذا يظلّ “السمع” – بالمعنى الرمزي – قائمًا في كل إنسان، لأن جوهره هو الاستقبال والتأويل، لا مجرّد استقبال الموجات الصوتية.
وهذا ما تؤكده علوم اللغة الحديثة وعلوم الأعصاب المعرفية، إذ تبيّن أن الدماغ البشري يُفعّل مناطق مماثلة عند سماع اللغة أو رؤيتها في شكل إشارات. فالسمع الحقيقي، في جوهره، هو سمع القلب والفهم. “ومن لم يسمع الصوت، قد يسمع المعنى”.
البصر .. من الإدراك الحسي إلى الرمز البصري
إذا كان السمع هو البوابة الأولى للغة، فإن البصر هو المختبر الثاني للمعنى. فالعين لا تنشئ العلامة، لكنها تترجمها إلى رموز محسوسة، وبذلك تُكمل عمل الأذن.
لقد وسع اللسانيون المعاصرون- من رولان بارت إلى أمبرتو إيكو – مفهوم العلامة ليشمل الصورة والأيقونة واللون، وسمّوا هذا الحقل بالسيميولوجيا البصرية (Visual Semiotics). فالعين لا تكتفي برؤية الأشياء، وإنما تُؤوّلها: ترى القمر فترمز به إلى الجمال، وترى الميزان فتراه تجسيدًا للعدل، وترى الحمامة فتُحمّلها دلالة السلام. إنها تشتغل بالدلالات لا بالمادة، تمامًا كما تفعل الأذن مع الأصوات.
غير أن الفارق الجوهري بين الحاستين، أن السمع زمني (يتدفّق في لحظة)، بينما البصر مكاني (يثبّت الصورة في إطار). وهذا الفرق يجعل اللغة السمعية أكثر ديناميكية وتتابعًا، بينما اللغة البصرية أكثر ثباتًا واستحضارًا.
في القرآن الكريم تُستخدم الرؤية غالبًا في سياق الإدراك التأملي، لا المشاهدة العابرة، كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [الغاشية: 17].. أي: تأملوا لا مجرد شاهدوا .. فالبصر هنا ليس حاسة مشاهدة، إنما هي أداة تفكّر وتأويل. من هنا تتكامل الحواس الثلاث في النسق القرآني: السمع يلقّن، والبصر يتأمل، والفؤاد يركّب المعنى ويولده.
وفي إطار السيميولوجيا الحديثة، تمثل هذه العلاقة انتقالًا من العلامة الصوتية إلى العلامة البصرية، ومن الدالّ الأكوستيكي إلى الدالّ المرئي، من غير أن تفقد اللغة وحدتها كنظامٍ دلالي متكامل.
الفؤاد .. مركز الوعي ولسان الباطن
حين يجتمع السمع والبصر، لا تكتمل المعرفة إلا بوسيط ثالث هو الفؤاد، الذي يدمج الإدراكين السمعي والبصري ويحوّلهما إلى فهمٍ ومعنى.
في ضوء علم الأعصاب الحديث، يُمثّل الفؤاد الوظيفة المعرفية العليا التي تربط الحواس بالعقل وتؤلّف بينها. وفي ضوء اللسانيات المعرفية، يمكن اعتبار الفؤاد المجال الذهني الذي تتحوّل فيه العلامة إلى فكر ومعنى. فالكلمة المسموعة أو الصورة المرئية، لا تُصبح “معنى” إلا بعد أن تمرّ عبر الفؤاد، الذي يُسند إليها القيم والدلالات. وقد أشار جاك دريدا في كتابه De la grammatologie (1967) إلى هذا التوتر الدلالي المستمر بقوله:
«Le sens est toujours en mouvement, différé, jamais présent dans une seule trace.»
أي: “المعنى دائم الحركة، مؤجّل، لا يحضر أبدًا في أثر واحد.”
وهذا يعني أن الفؤاد هو المجال الذي تتحرك فيه العلامات وتتفاعل، فيُنشئ المعنى من خلال الاختلاف والتشابك بين الدوالّ داخل الذهن.
لقد صاغ الوحي سلسلة معرفية متكاملة: السمع يستقبل الدالّ، والبصر يقدّم المرجع، والفؤاد ينتج المدلول النهائي: أي الفهم والإدراك.
إنه مركز التأويل، البُعد الداخلي في الإنسان، حيث تتحوّل العلامة – سواء كانت صوتًا أو صورة – إلى وعي وإيمان. فالفؤاد ليس عضوًا جسديًا، هو رمز معرفي لملكة الفهم التي بها يتحقق الاستخلاف الإنساني.
وقد لخّص القرآن هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: 46].
فالعقل، بحسب هذا النسق القرآني، ليس أداة تحليل منطقي فحسب، بل وظيفة قلبية تنبع من باطن الإنسان، حيث تتلاقى الحواس، وتتكثّف العلامات، ويتبلور الفهم.
في الختام .. من خلال هذا المسار – من السمع إلى البصر إلى الفؤاد – نرى أن القرآن قد رسم أقدم خريطة معرفية في تاريخ الفكر الإنساني، تتقاطع على نحوٍ مدهش مع ما وصلت إليه اللسانيات الحديثة.
فالسمع هو الأصل اللساني الأول الذي يولد به النظام الرمزي وتُبذر فيه بذور العلامة، والبصر هو الامتداد الحسي الذي يُغني العلامة ويجعلها مرئية، وقابلة للتأويل البصري؛ أما الفؤاد، فهو الحقل الفلسفي الداخلي، الذي يُوَحِّد الدلالات ويحوّل الإدراك إلى وعي ومعنى.
لقد جاء دي سوسير ليقول إن اللغة نظام من العلامات، لكن القرآن قال قبل ذلك بقرون: إن الإنسان نفسه نظامٌ من السمع والبصر والفؤاد، أي: من أدوات الإدراك والمعنى.
وهكذا، تتلاقى اللسانيات البنيوية وما بعدها، مع الوحي، في التأكيد على أن المعرفة رحلةٌ: من الحس إلى الفهم، ومن الصوت إلى النور، ومن العلامة إلى المعنى.
وقد لخّصت آيةٌ قرآنية هذا المسار باقتدارٍ بالغ: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: 46]. فالعين ترى، والأذن تسمع، ولكن الفؤاد وحده يفهم العلامة في ضوء الحقيقة .. فتأمّل.. !