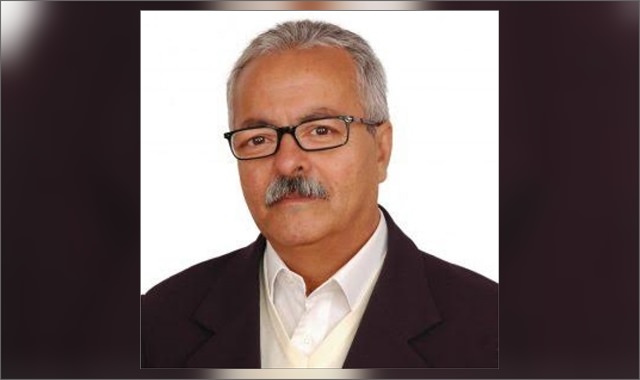ليست هذه هي المرة الأولى التي يعرف فيها المغرب الاحتجاج، بل يكاد يكون الاحتجاج هو القاعدة في تاريخه، نظرا أساسا للاختيارات السياسية غير الشعبية وغير الاجتماعية التي سرقت الاستقلال والحرية من المقاومين منذ مفاوضات اشتغلت فيها الآلة الاستعمارية لتؤبد مصالحها. لا يتسع هنا المجال لتأريخ الاحتجاج في المغرب، وهي حاجة معرفية ملحة، لكن الممكن في هذه العجالة هو محاولة تصنيف أشكال الاحتجاج من أجل الاقتراب أكثر من الوقائع، ومن أجل الفهم.
الاحتجاجات في المغرب انواع، منها المنظمة من طرف أحزاب سياسية معترف بها رسميا وتشارك في الحياة السياسية والانتخابات، وتعطي رأيها حتى في الاستحقاقات الكبرى مثل الاستفتاء، هي احتجاجات الأحزاب الوطنية التقليدية، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي سيصبح الاتحاد الاشتراكي، وكذلك الحزب الشيوعي المغربي الذي سمي بعد المنع بالتحرر والاشتراكية، ثم التقدم والاشتراكية، وإذا كان الحزب الأول يعبر عن مصالح البورجوازية الصغرى من المعلمين والموظفين والمثقفين المتنورين، وبقايا جيش التحرير والمقاومة، والتي انفصلت عن البورجوازية التجارية التقليدية، التي يمثلها حزب الاستقلال، فإن الحزب الثاني قريب من نقابة العمال، الاتحاد المغربي للشغل. هذه الأحزاب وهذه النقابة نظمت احتجاجات، خاصة أثناء الانتخابات، أو في انتفاضات كبرى لما تمس مصالح الشعب كما حدث في احداث 23 مارس 65، والتي خرجت إثرها منظمات أكثر راديكالية تدعو إلى الثورة وتغيير النظام السياسي، لعل أهمها منظمات إلى الأمام و23 مارس، والشبيبة الإسلامية.
إضافة إلى المحاولات الانقلابية، شكل الصراع حول الحكم، وعدم رؤية أي أفق إلا فيه، مناسبة للنظام حتى يحمي نفسه، وتستمر الملكية، وحتى يقوم بذلك شغل آليتين مكتملتين، القمع من جهة، وصناعة أحزاب سميت من طرف الأحزاب الوطنية إدارية. وقد بدأ الأمر مبكرا منذ فكر الملك الحسن الثاني مع مستشاره الليبرالي محمد ݣديرة في تأسيس حزب للنظام يدخل حلبة الانتخابات، وهو حزب لم ينجح في مهمته ولم يعمر طويلا، وذلك لحيوية البورجوازية الصغرى آنذاك، والتي استمر زخمها حتى ما بعد المسيرة الخضراء، خاصة مع ابداع نقابة المعلمين، التي كانت الدرع الاحتجاجي للقوات المعارضة، والتي تجاوزت مطالبها ماهو نقابي نحو سقف أعلى من السياسة، نحو مطلب ملك يسود ولا يحكم، الشعار الذي ادخل امينها العام نوبير الأموي للسجن، نفس الأمين العام الذي كان يدعو للإضراب العام وينجح في ذلك.
بعد الاحتجاجات السياسية والقمع المسلط على الجماهير والتنظيمات، وحتى ابداع النظام للمسيرة الخضراء، التي استطاع أن يلتف بها على المعارضة السياسية، نحو اجماع حول وحدة التراب الوطني، الذي استغل في الدخول فيما سمي آنذاك بالمسلسل الديمقراطي، الذي حاول أن يستقطب المعارضة التاريخية، ونجح في ذلك، ليس في أن ينتقل إلى الديمقراطية، ولكن في تحييد الاتحاد الاشتراكي، كأكبر خصم أصبح يهتم بالأصوات وكراسي البرلمان والمشاركة في حمل حقائب وزارية…
بعد هذا التهجين انتقلت الاحتجاجات إلى نوع آخر، يمكن أن نسميها احتجاجات اجتماعية وعفوية اثر كل إجراء للدولة يمس جيوب الجماهير، كما حدث سنة 1981 فيما سمي بانتفاضة الخبز، و1984. وبقي الاحتجاج السياسي في صفوف حزب غير معترف به هو العدل والاحسان، واليسار الأقصى، والطلبة، هذه الفئات وحدها تحملت وما زالت تتحمل النقد الجذري للنظام.
بعد الاحتجاجات السياسية تلتها الاحتجاجات الاجتماعية، نقابية في البداية ثم شعبية، ولسوء الحظ كما تعاملت الدولة مع المنتقدين السياسين لها والمنازعين لها في الحكم، تعاملت أيضا مع المنتقدين الاجتماعيين الذين لا يهمهم الحكم بقدر ما يهمهم حد أدنى من القدرة الشرائية والشغل وعدم الغلاء.
تعتبر حركة 20 فبراير تركيبا لما هو سياسي وما هو اجتماعي، كانت مطالبها متقدمة سياسيا، حيث طالبت بملكية برلمانية، ومحاكمة المفسدين، وكذلك حقوقيا ركزت على حرية التعبير، وصون الكرامة، أما اجتماعيا فقد ركزت على التشغيل وتحسين الخدمات العمومية. ونظرا لخطورة الموقف، ومشاهدة ما حدث في دول عربية شبيهة سارع النظام ولأول مرة إلى احتواء الأمر باقرار دستور جديد هو بمثابة تجميع لمطالب الفرقاء والفئات الفاعلة.
واستمرت الهدنة حتى حلت احداث الريف، والتي لم تكن في عمقها سياسية، وإنما اجتماعية، مرتبطة بمطلب مركزي هو مستشفى لعلاج السرطان في المنطقة التي تشهد أكبر معدل من الإصابات من هذا المرض، والتي هي نتيجة الحرب الكيماوية التي باشرتها قوات الاحتلال الاسباني على هذه المناطق المعروفة بمقاومتها الشرسة، احتجاجات الريف أيضا قمعت واعتقل قادتها.
ثم تلت هذه الأحداث احتجاجات هنا وهناك، في مدن معدنية، وحتى في قرى جبلية تحاول اسماع صوتها المعبر عن الحاجة إلى أبسط مقومات العيش الكريم.
الاحتجاجات المتحدث عنها لحد الآن سياسية أو اجتماعية اقتصادية، وبعوامل ومسببات تقليدية مرتبطة بالاختيارات السياسية والفساد.
الاحتجاجات الشبابية:
ثم حلت احتجاجات بطعم جديد ارتبط بعوامل مضافة لعل أهمها التواصل الرقمي…
كيف حدثت الوقائع؟ وما هي العوامل الفاعلة؟ وماهي الخصائص الظاهرة والخفية؟ وكيف تفاعل الطرف الحاكم معها؟ وما هي الآثار والمآلات؟
بعيد احتجاجات قوية في مدينة أكادير السياحية اثر وفيات في المستشفى الإقليمي، والتي جعلت الحكومة تسرع ليس لوجود حلول وإنما لإطفاء غضب الناس، ظهرت احتجاجات من نوع جديد في العاصمة ومدن أخرى، تبدو عفوية وغير منظمة ولا خلفية فكرية وسياسية لها، لكن الحكم بهذه الصفات يبدو متسرعا خاصة عندما خرجت وثيقة موجهة إلى الملك مباشرة تخبر بوعي سياسي، قد يبدو لنا طموحا أو حتى طوباويا، لكن مع المقارنة بمطالب نفس الجيل في مناطق أخرى من العالم مثل النيبال يجعلنا نتريث و نتعمق اكثر في هذه الاحتجاجات التي لا تشبه سابقاتها، لا في الشكل ولا حتى في المضمون، ولا في الأشكال النضالية والشعارات المرفوعة
نحن أمام ظاهرة تحمل خصوصيات دولية وأخرى محلية، يجب موقعتها فيما بعد بعد الاحتجاجات الاجتماعية التقليدية، أو إن صح التعبير فهي احتجاجات رقمية…دون ربطها بهذا العامل التكنولوجي وحده، وإن بدا أنه يتخذ بعدا سوسيولوجيا واضحا. منذ الربيع العربي، أو في الدعوات إلى مقاطعات بعض المواد الاستهلاكية، أو المساعدة على التنظيم والإستمرارية كما في احتجاجات رجال التعليم في المغرب
البعد الديمغرافي للاحتجاج
لا يمكن فهم وتحليل اصطباغ الاحتجاجات الحالية بفترة عمرية محددة هي الشباب، إلا في إطار الإنتقال الديمغرافي الذي يمر منه المغرب، والذي من سماته انخفاض معدل الخصوبة والوفيات، وتحسن كبير في مدى الحياة، انقلاب في الهرم السكاني يخير عن بداية شيخوخة المجتمع، وتحكم الشيوخ و الكهول في كل شيء، وتهميش الشباب، مثل هذه الأوضاع تذكرنا بالثورة الفرنسية، والتي لم يكن الثوار فيها في الغالب فقراء، ولا متشبعين بأي ايديولوجيا، وإنما شباب متعدد المشارب انحسرت آمالهم فانتفضوا. انتظار الانتفاض إذا في وضع الانتقال الديمغرافي أمر جد منتظر، خاصة مع انتقال المغرب من الأغلبية القروية إلى الأغلبية الحضرية، وسوء التدبير السياسي والفساد والقرارات غير الشعبية التي انتجت التضخم والبطالة.
الاحتجاجات كشباب
ساهم الشباب المغربي دوما في النقاش العمومي السياسي والثقافي، سواء من خلال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أو وداديات التلاميذ، بل وشهد العالم لهذا الشباب بتميز وحيوية، سواء بإمداد التنظيمات اليسارية بالأطر، أو حتى بتبني مواقف جد مشرفة، مثل اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية، ووضع القضية دوما في بداية كل جدول أعمال اللقاءات، أو شجب الآبارتايد، ومساندة قوى التحرر العالمية. غير أن قمع النظام للطلبة وللتلاميذ أكثر من مرة، وكذلك خلق فئات مخترقة للصفوف، كل ذلك جعل هذه الشبيبة تنزوي وتسقط في أحابيل اليأس، خاصة أن المغرب لم يعد ذلك المجتمع المنغلق التقليدي الذي يحلم فيه كل طفل أن يصبح كبيرا وراشدا حتى يعترف به، وعبر المهنة التي يراها قبل كل المهن، وهي مهنة أبيه( حرفة بوك لا يغلبوك)، لم يعد الشاب الآن يحجم طموحه ويوقفه عند عتبة الدار، وهو الذي يرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي امكانيات لا حدود لها للشباب في مثل سنه في بقع أخرى من العالم.
هذه الفئة التي تشكل تقريبا ثلث المغاربة اصطدمت أحلامها أمام عوامل أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية سردية وقيمية.
البعد السياسي:
لقد اقتنع الجميع الآن أن السياسة ماتت في المغرب، لقد استطاع النظام تحجيم كل المعارضات، الحزبية والنقابية والمدنية، وأصبح ينصب من يشاء ويقصي من يشاء، وفق معيار واحد وأوحد هو الولاء، الذي يجازى بالحماية، وكل النعم المادية والمعنوية، وتسهيل الفساد خاصة، وتغول الأمر إلى حدود لم يستطع النظام نفسه إيقافه، وانتقلنا إلى المأسسة وخلق كل المساطر المسهلة للفساد، كالتي تضع حواجز قانونية للتنديد أوالتبليغ أمام المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية.
السياسة الآن في المغرب حرفة من يريد الإثراء السريع، ذلك باتخاذ سلوك منحرف يعتمد العبودية الطوعية لمن هو أعلى، والاحتقار للشعب، الأحزاب لم تعد لها دلالات السياسة، وإنما دلالات الانتهاز واللعب على الحبال التي يصنعها قادة في مختبر تاحرميات بعيدا عن الفضيلة، والمعاني النبيلة وحتى العادية للسياسة. هذا الوضع جعل الشباب ينفر من حربائية السياسيين التي لا تفعل شيئا سوى إغلاق منافذ النجاة، نحن أمام مازق حقيقي للممارسة السياسية الديمقراطية في المغرب مع افلاس الأحزاب وافساد الممارسة السياسية.
البعد الاقتصادي للاحتجاجات
شيء ما يريد أن يجعل من الاختيارات الاقتصادية المغربية هروبا نحو الليبرالية المتوحشة، الأمر الذي اتضح في طبيعة الأغلبية الحاكمة التي ليست في الغالب سوى تجميعا لوليكارشيا اغتنت بالريع وانتهاز الفرص وركوب التسهيلات المسطرية من طرف الدولة كما في مشروع المغرب الأخضر، ومشاريع أخرى، مع أثرياء جدد استفادوا من العلاقات التي توفرها السياسة، نحن أمام حشد جديد من المنتهزين للفرص ولا علاقة لهم مع ابداع يساهم في خلق الثروة وفرص الشغل، هي ليست بورجازية بالمعنى المعتاد لهذه الطبقة، هي نوع من العودة إلى إقطاع بمعنييه، الذي يعني التحكم في رقاب الناس، ومحاولة تملك الخيرات، لكن دون نبل، لا حربي ولا نخبوي ثقافي… الاقتصاد المغربي الحالي غير مبدع وغير خلاق، ولا يشتغل إلا في القطاعات الآمنة مثل العقار والمال، واستثمار الدولة في البنيات التحتية التي لا تصل إلى كل الجهات، بذلك تبدى هذا الاقتصاد المغربي عاجز عن خلق الثروة وفرص الشغل.
البعد الاجتماعي
أن تصل البطالة إلى أرقام قياسية، وأن يشل التضخم القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وأن تغلق منافذ التعبير، وأن لا تفتح سوى أمام أشباه الاعلاميين من الوصوليين، وأن يحاصر الشرفاء من الصحافيين وذوي الخبرات، وأن تشل آليات التأطير، وأن تتردى حالة التعليم إلى أسوأ المستويات سواء في البنية التحتية أم في اعتبار الأستاذ وخلق وسائل احترامه، وأن توهب الصحة للمضاربين من ذوي الشكارات المكتنزة من طبق من ذهب….كل ذلك هو ما اوصل الناس إلى اليأس وفقدان الثقة. الرقمي ليس سوى وسيلة، الأوضاع صارخة والسياسيون يسخرون من الحالة، ويتبجحون بنجاحهم في نيل رضى أسيادهم من الداخل والخارج. ومن يستطيع أن يحتج ويقول باراكا سوى الشباب الذي فتح على عينيه على ورقة صفحتها الأولى مأساوية وصفحتها الثانية حرية تامة في النقاش مع أي كان من أي بقعة من العالم.
الشباب ليسوا فوضويين، ويفهمون أن هناك حاجة إلى ملكية تجمع ما تفرق من المغرب، لكن في الوقت نفسه يتشوفون إلى الحرية الفعلية، والتعبير دون خوف، وعدم التمييز في الفرص، وتغيير السياسة نحو اختيارات تفكر في ألا تغرق السفينة التي نركبها جميعا. سياسة بعقد اجتماعي يحترم كل المواطنين، ويخلق آليات حقيقية للابداع وخلق الأفكار، والمراقبة القبلية والمعية والبعدية، ببساطة لأن الوطن للجميع، وأن عهد الولاء والامتياز والحماية يجب أن ينتهي، وذلك في مصلحة الجميع لأن السفينة إذا خرقت في مستوى لا يمكن أن تنجو باقي المستويات…
البعد الثقافي والقيمي:
لا يمكن أن تتغير البنية الديمغرافية دون أن تتغير الثقافة والقيم واعتماد السرديات، أول ما يلاحظ عن الجيل زد اهتمامهم بالرقمي، والتعلم من خلاله، وأحيانا بعمق يصل إلى البرمجة وتحليل البيانات، وحتى القرصنة، وأمور أخرى كثيرة ترتبط بالذكاء الاصطناعي، والقدرة على التشفير وفكه، وصناعة الصور والرموز…
تفرض الرقمية التوجه نحو اللغة الانجليزية، وهو تحول كبير في الثقافة المغربية التي كانت تابعة بشكل كلي لدولة الاستعمار. تعلم الانجليزية يرتبط بتعلم ثقافة خفيفة وشعبية، وغير نخبوية كما هو الأمر في الموسيقى والشعر البسيط المرافق لها والتحدث عن الشارع واليومي.. هي كلها قيم شخصية متفتحة تدمج الجديد بسرعة، تعيش الحاضر وتنحو نحو المستقبل والتغاضي على بعض النقائص مثل المخدرات وعدم الوفاء بين الجنسين، وتفضيل خفة العلاقات، وغياب الانفعالات التقليدية مثل الغيرة والحسد والعتاب، هو جيل متحرر، لكنه أيضا سريع العطب نحو الاضطراب النفسي بانواعه الخفيفة والثقيلة، ربما نظرا للعلاقة المتوترة مع الأجيال الأخرى…
نحن هنا أمام قيم جديد لم ترسو بعد، وربما لن ترسو أبدا، لا أحد يعلم الآن، لكن هناك إشارات وملامح انتقال قيمي في الأفق يجب الاستعداد له بدون انتظارية…
خلاصة
نحن أمام انتقال اجتماعي، إن صح أن نسميه سوسيولوجيا كذلك، والاحتجاجات ليست سوى بوادر أمواجه الأولى.
نشر الثقافة الرقمية والذكاء العام والاصطناعي، وتعليم المنطق واللغة والحوار والنقد والابداع والتفكير منذ ماقبل المدرسي أصبح ضرورة اجتماعية ملحة…
منهجيا لا يجب خلط الاحتجاج بالحركة التي لها شروطها ومقوماتها التي لا تتوفر في الاحتجاج، والذي يجب أن ينظر إليه على أنه مؤقت مهما كبر زخمه وتضخمت عموميته. وهذا الاحتجاج، لا يجب أن يطلب منه أن ينتظم، وخاصة في الأشكال التقليدية التي لا يثق فيها سواء السياسية أو النقابية أو المدنية، بل هي التي ينتفض ضدها، وهي التي أوصلت الحال إلى ما هو عليه، ومطلب الحوار معها وبتمثيلية لا قيمة له، على الأقل الآن. ثم إن لم يكن من يحكم يأخذ بالجدية الكافية مطالبهم فإنه يمكن أن ينتظر سقفا أعلى يصل إلى حدود التساؤل حول جدوى الدولة نفسه.