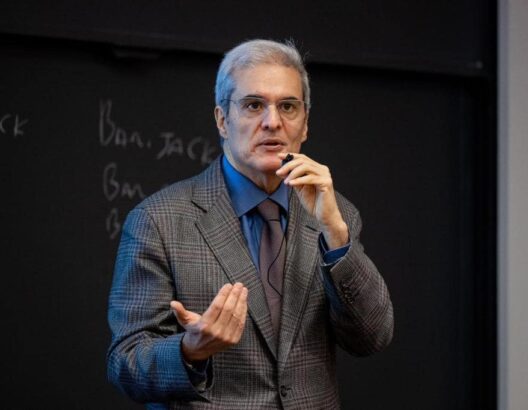نُشر سجال بين “الأستاذ” أحمد عصيد و”البروفيسور” طلال الحلو[1]، مع بروباغندا عالية الصوت بأن “البروفيسور” ألحق بالأستاذ شرَّ هزيمة. البروباغندا صادرة عن صفحات وشخصيات تُعلن انتماءها إلى التيار الإسلامي، بمختلف أطيافه. ويُعتبر الاعتداد بـ”البروفيسور” الناطق بلغة أجنبية، واجهة شكلية لتحولات حدثت في صلب الحركة الإسلامية بالمغرب، تحولات متأخرة، لأن المغرب غالبا ما يأتي دوما في مؤخرة التطور التاريخي مقارنة بالأمم الأخرى. فقد سبقت الحركاتُ الإسلامية ببلدان عربية أخرى في هذا “التقدُّم” أخواتها بالمغرب.
لكن ما تشترك فيه التيارات الإسلامية، مع كل التيارات اليمينية عبر العالم، هو أسلوب السجال المبني على اختراع “حقائق” وسجالها على أنها وقائع عينية. هذا هو مجمل أسلوب “البروفيسور” طلال الحلو، طيلة سجاله مع “الأستاذ” أحمد عصيد، إذ يعمد إلى ما يُطلق عليه مغالطات منطقية، فيقدِّم استنتاجاته “المنطقية” كأنها صادرة عن مقدمات “منطقية”، لكنها في التحليل الأخير من اختراع عقله هو. وهو ما يتناقض مع ما افتتح به كلمته: “أنا أحب تماما الدقة”، إلا إن كان يقصد “الدقةَ” في اختراع الوقائع ثم مهاجمتها وهدمها، وهو ما أفلح فيه تماما.
هل كل التقدمية جيدة؟
كان هذا سؤالا سجاليا حاول عبره “البروفيسور” حصر “الأستاذ” في الزاوية. لكن ما قدمه من حجج تدخل في إطار ما يُطلق عليه “مصادرة على المطلوب”، وهي حيلة “منطقية” تعتمد التسليمَ بالمسألة المطلوب البرهنةُ عليها من أجل البرهنة عليها! لذلك فهي غير منطقية في التحليل الأخير. وسنرى أن هذه الحيلة هي كل زاد “البروفيسور” العلمي/ السجالي.
قال البروفيسور: “المُسْلِمُ بطبيعته تقدميُّ، أي أنه في كل ما يتعلق بمجال الابتكار، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، المبدأ أن كل شيء مسموح به حتى يثبت العكس”.
“المسلم بطبيعته تقدمي”! لكن المسلم ليس كائنا مجرَّدا، إنه كائن تاريخي اجتماعي، ويعيش في مجتمع ينقسم إلى طبقات: طبقات مستغِلة وطبقات مستغَلة، شأنه شأن كافة “متديني” العالم و”لامتدينيه”. لذلك ليس من الجائر الحديث عن “المسلم” هكذا بالمطلق وبالتجريد. وليس هذا التجريد “الإسلامي” الخاص بالحلو، سوى استعادة لخرافة “المواطن الفرد”، الذي بشرت به “الحداثة البرجوازية” منذ نهاية القرن السابع عشر، مستقية من هذا الفرد كل تصورها للعالم. وفي الأخير اكتُشف أن ذلك الفرد المجرد، ليس سوى الفرد البرجوازي/ الرأسمالي الذي صاغ العالَم بناء على حاجياته وتطلعاته الطبقية/ المادية. لذلك فإن رفض طلال الحلو لـ”الحداثة”، ليس رفضا مطلقا، بل رفضا لمنشَئها الغربي العلماني، دون التضحية بأساسها التاريخي/ الاجتماعي: الاقتصاد الرأسمالي مع صبغه بطلاء ديني: “الاقتصاد البديل/ الاقتصاد الإسلامي”.
قال البروفيسور” “أي أنه في كل ما يتعلق بمجال الابتكار، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، المبدأ أن كل شيء مسموح به حتى يقبت العكس”. من هي الجهة التي “تسمح مبدئيا” بالابتكارات؟ إنها- حسب البروفيسور- هيئة رجال الدين، الذين وحدهم لهم “اختصاص” تفسير الدين وتأويله، كما للأطباء وحدهم “اختصاص” تفسير الطب وتأويله.
لكن هنا بالذات يدخل البروفيسور متاهته. إذا كان لكل اختصاصه، فكيف لرجال الدين أن يُعلنوا أن “ابتكارا اقتصاديا” ما “مسموحا به حتى يثبت العكس”؟ نفس الشيء بالنسبة للابتكارات الاجتماعية والسياسية؟
“أنا أحب الدقة تماما”، هذا ما صرح به البروفيسور. ولنكون دقيقين، فإن ما ثبت في التاريخ هو عكس ما صرح به البروفيسور، أي أن “التحريم” هو الأصل إلى أن يثبت العكس، آنذاك فقط يصبح “المبدأ هو أن كل شيء مسموح به”.
لنأخذ مثالا عن “ابتكار” دخل الاستهلاك الشعبي بسرعة في تقاليد المغاربة “المسلمين”، وهو شرب الشاي. لم يكن الشاي مشروبا معروفا لدى المغاربة، بل أدخله الإنجليز في بدايات القرن الثامن عشر. لا لأحد يجادل في أن الشاي حاليا مشروب شعبي، بل مشروب الكادحين- ات المغاربة. لكن قبل أن “يكون مسموحا به كمبدأ”، نال تحريم الفقهاء المغاربة لأنه يشبه الخمر في هيئته وآنيته، ولأنه يشغل الناس عن العبادة، ويضر بالأجسام… إلخ. طبعا كان هناك فقهاء آخرون أكدوا أنه حلال، ولكن هذا “السجال” بين فقهاء يُحرمون وآخرون يُحللون، إنما ينفي “الحقيقة المخترَعة” من طرف البروفيسور التي أعلنت “كل مسلم تقدميا”، وأن التقدمية فطرة “كل مسلم”، وأن “المبدأ هو أن كل شيء مسموح إلى أن يثبت العكس”.
أما عن “الابتكار السياسي” المسمى “ديمقراطية”، فلم تكن مشمولة بمبدأ البروفيسور القائل: “المبدأ أن كل شيء مسموح به حتى يثبت العكس”، بل بالعكس تماما، فقد كانت “حراما” و”دخيلا غربيا”، حتى “ثبت عكس ذلك”، أي حتى أصبحت التيارات الإسلامية ترى في “الديمقراطية” (أي الانتخابات والأحزاب السياسية… إلخ) وسيلة للوصول إلى السلطة. والإسلاميون لا يقبلون الديمقراطية إلا إذا كانت تعني حُكمهم هم، وهو ما عناه عبد السلام ياسين في كتاب “حوار مع الفضلاء الديمقراطين” (صفحة 58): “كلمة ديمقراطية تعني حكم الشعب، واختيار الشعب، والاحتكام إلى الشعب. وهذا أمر ندعو إليه ولا نرضى بغيره، على يقين نحن من أن الشعب المسلم العميق الإسلام لن يختار إلا الحكم بما أنزل الله، وهو الحكم الإسلامي، وهو برنامجنا العام، وأفق مشروعنا للتغيير”. وعندما “يثبت العكس”، أي عندما “يختار الشعب”، مرجعية أخرى، فإن البديل الإسلامي واضح: اتهام المجتمع بالجاهلية والدعوة إلى الجهاد.
النكتة في سجال البروفيسور هي عندما قال: “هل التقدم دائما جيد؟”. وهي حيلة أكثرَ منها البروفيسور طيلة البرنامج الحوار: “ليست كل أشكال التمييز سلبية”، “هل نريد مساواة مطلقة”، وهي حيلة تترك المساجِل منزوع السلاح. لكن لن يكون كذلك إلا إذا كان منزوع السلاح أصلا، وهو ما انطبق على الأستاذ عصيد.
لنعد إلى سؤال “هل التقدم دائما جيد؟”، أجاب البروفيسور: “لا”، مبررا ذلك بقول: “يمكن أن يكون هناك تقدم في الخلايا السرطانية داخل الجسم وهذا ليس تقدما جيدا”. هنا يقتحم “الفقيه” ميدانا غير ميدان اختصاصه، متناقضا هكذا مع ما قاله بعظمة لسانه. نترك يوسف الشاوي يجيب البروفيسور: “ليست المقارنة بغيظة فحسب، بل هي أيضًا غبية بشكل مذهل من الناحية المنطقية. فالمساواة بين التقدم الاجتماعي (الحقوق والحريات والعلم)، الذي يهدف إلى تحسين الحالة الإنسانية، وبين الأمراض القاتلة، هو عدم أمانة فكرية تُسقط أهلية صاحبها. إنه نوع من السخرية التي لا يمكن أن تؤثر إلا على أولئك الذين تخلوا عن التفكير”[2]. ويبدو أن الكثيرين فعلا قد تحلوا عن التفكير، مهللين لقدرات البروفيسور العلمية، الذي يساوي التقدم في الحقوق والحريات مع تقدم الخلايا السرطانية.
ينتهي البروفيسور إلى جعل الأمراض حالة طبيعية يمكن اللجوء إليها “قياسا واجتهادا” لمساجلة الخصوم والحكم على الظواهر الاجتماعية. وليس هذا خاصا بالتقدمية، كما سنرى أدناه.
عن المساواة بين الجنسين
ندخل هنا الساحة المفضلة للإسلاميين، ليس فقط لأن جمهورهم متدينٌ، بل لأن قسما من ذكور المجتمع، أصبح يحس بالأرض تميد تحت رجليه، وأن النساء تركن “حصنهن الحصين” مقتحمات مجالات كانت حصرا على الذكور.
هنا يلتجأ البروفيسور إلى نفس الحيلة: “المصادرة على المطلوب” وطرح أسئلة تبدو لمنزوع السلاح أصلا أسئلة تعجيزية. أكثر من ذلك يريد البروفيسور أن يبدو للمستمع بمظهر العالِم الحديث، الذي يعتمد على الدراسات “الحديثة” من جامعات “الغرب”، هذا الغرب الذي أعلن البروفيسور إفلاسه الأخلاقي والقيمي في نفس البرنامج! مستمرا هكذا في متاهته اللانهائية.
قال البروفيسور: “للبقاء ضمن الدراسات العلمية هل هذه المساواة حقيقية من الناحية الكيميائية والبيولوجية؟ لا، فقد أظهرت علوم الأعصاب أن التفاعلات والهرومونات التي نفرزها مختلفة، كما أن تأثير الهرمونات على الدماغ، وحتى تكوين الدماغ نفسه مختلف. فعلى سبيل المثال، الرجل يفرز التستسترون بمقدار 14 مرة أكثر، وهو هرمون المخاطرة وهرمون الرغبة وهرمون بناء العضلات”.
ليست هذه أول مرة يُلجأ فيها إلى العلم لتبرير التفاوتات الاجتماعية (بله القمع السياسي والاستعمار) بناء على اختلافات بيولوجية أو عرقية، يتحول العلم هكذا إلى “أداة لسحق البؤساء والمستغلين” على حد تعبير أنطونيو غرامشي.
لا ندري أي منطق يسمح للبروفيسور بأن يستنتج من “الاختلافات الهرمونية والعصبية” بين الإناث والذكور، ضروروة التمييز الاجتماعي بينهما، والقول بضرورة تفوق القدرات العقلية للرجل مقارنة بالمرأة. هنا تتدخل عوامل أخرى مثل التأثيرات البيئية والاجتماعية. البروفيسور نفسه عندما وجد نفسه أمام هجمة مرتدة من الأستاذ عصيد، هجمة حول تفوق التلميذات على التلاميذ في نتائج الباكلوريا، وضع البروفيسور حجة “الهورمونات والتفاعلات” على الرف، واستجار بـ”علم البيئة الاجتماعية”، عندما قال: “في الواقع السبب في أن التلميذات يحققن نتائجا أفضل من الفتيان، هو أن الفتيات، ما زلن أكثر تمسكا بهذا التقليد من الفتيان، لا يُسمح للفتاة بالخروج ليلا لتفعل ما تشاء، بينما يسمح للفتى بالخروج ليلا ليفعل ما يشاء. لقد منحنا حرية أكبر بكثير”.
هنا تفسير تفوق الإناث على الذكور هي “عوامل اجتماعية”، بينما يفسَّر تفوق الذكور على الإناث بعوامل بيولوجية/ فيزيولوجية… إلخ. والحل بالنسبة للبروفيسور، هو إعادة الأمور إلى نصابها: أي تعديل البيئة الاجتماعية، بما يسمح لـ”الفروقات البيولوجية” بأن تفعل فعلها، وتعيد للذكور تفوقهم، إذ قال: “لقد منحنا للذكور حرية أكبر بكثير للخروج ليلا ليفعلوا ما يشاءون”، وهكذا فالسبيل لاستعادة تفوق الذكور في نتائج الباكلوريا هو “منعهم من الخروج ليلا”! ليس هذا إلا وجها من أوجه الحركات الإسلامية، كحركات تريد ضبط المجتمع بالدين، تماما كما يضبطه الاستبداد السياسي بالقمع (الجيش والشرطة). لكن التغيرات الاجتماعية أقوى بكثير من أي سلطة (دينية كانت أو علمانية)، وتتمكن دوما من فرض نفسها… وفي هذه الحالة فقط، أي عندما تنتصر التغيرات الاجتماعية وتفرض نفسها، يتقدم “الفقهاء” ليقولوا: “المبدأ هو أن كل شيء مسموح”، أي تماما بعد أن تهزمهم التغيرات الاجتماعية تلك.
وفي استعماله لـ”علم الأمراض”، “يتقدِّم” البروفيسور” ويلجأ إلى “علم الأمراض الاجتماعية” كي يقول لنا بأن المساواة ليست مطلقة، و”ليست كل مساواة جيدة” و”ليست كل أشكال التمييز سيئة”. حجة البروفيسور هي: “إذن هل نريد مساواة مطلقة بحيث يكون لدينا عدد النساء مساوِ لعدد الرجال في السجون وفي الأعمال الشاقة وفي الأعمال الخطرة وفي الجريمة”. هنا، تماما كما يعتبر البروفيسور السرطان أمرا طبيعيا يُرفض به “التقدم”، فإنه يعتبر “الجريمة والسجون والأعمال الشاقة” أمرا طبيعيا يقاس به، أو بالأحرى يرفضُ به، مطلب المساواة. بدل أن يدعو البروفيسور إلى “القضاء على الجذور الاجتماعية للجريمة والعقاب”، يدعو إلى جعلهما مجالا خاصا بالذكور. وبدلا من أن يدعو إلى جعل التقدم التكنولوجي وسيلة للتخلص من الأعمال الشاقة، يدعو إلى جعلها عملا خاصا بالذكور! إنها تقدمية عجيبة لدى البروفيسور.
ولرفض المساواة يقتبس البروفيسور من دراسة لستيفنسون من جامعة ميشغن سنة 2008: “مع زيادة المساواة مع الرجل والمرأة ينخفض مستوى سعادة النساء، أي أن النساء أصبحن أقل سعادة تدريجيا منذ سبعينات القرن الماضي”. من هي بوب ستيفنسون؟ إنها من دعاة “الاقتصاد القيمي/ الأخلاقي” (اقتصاد رأسمالي في التحليل الأخير)، وكانت شخصية بارزة في إدارة أوباما ومستشارة رفيعة المستوى في مجال السياسات الاقتصادية، بما في ذلك عملها في الفريق الانتقالي لإداراة بايدن وهاريس، وقد نالت تقدير صندوق النقد الدولي الذي نشرت “مجلة التمويل الدولية” التابعة له، مقالا[3] تنويهيا بستيفنسون، واصفا إياها بـ”رائدة في حركة إعادة التفكير في الاقتصاد”. كانت ستيفنسون إذن ضمن جوقة الاقتصاديين، ما بعد أزمة 2008- 2009، التي تقدمت لجعل الاقتصاد الرأسمالي أكثر قبولا من طرف “الناس العاديين”.
لكن مصيبة البروفيسور في متاهته، أن ستيفنسون، تقف على النقيض تماما من موقفه من “المساواة المطلقة” ومن أن “ليست كل أشكال التمييز سلبية”، فستيفنسون تدافع على “منح الفتيات إمكانية الوصول إلى الفرص في الألعاب الرياضية في المدارس الثانوية أدى إلى زيادة كبيرة في التحاق النساء بالجامعات، والمشاركة في القوى العاملة، والتقدم إلى مناصب الإدارة”، مفندة بذلك خرافة البروفيسور القائلة: “الرجل يفرز التستسترون بمقدار 14 مرة أكثر، وهو هرمون المخاطرة وهرمون الرغبة وهرمون بناء العضلات”.
عودة إلى الاستشهاد الذي يربط “انخفاض مستوى سعادة النساء” بـ”المساواة مع الرجل”، وهنا يظهر البروفيسور بمظهر محتال صغير، إذ أكدت ستيفنسون على العكس تماما: “[المرأة] تعاني بسبب الضغوط التي تواجهها في دخول سوق العمل في الوقت الذي كانت لا تزال فيه المرأة هي مقدم الرعاية الأساسي في المنزل”. منطق البروفيسور معكوس تماما لمنطق ستيفنسون، إذ الأخيرة تنادي بالتوازن بين المرأة العاملة والمرأة الراعية، بينما يدعو البروفيسور إلى تقليص دور المرأة العاملة وتقديس دور المرأة الراعية.
هكذا فالتفسير الصحيح لانخفاض السعادة ليست المساواة “المطلقة” بين الرجل والمرأة، بل البرامج النيوليبرالية، التي ألغت مكاسب “السنوات الثلاثين المجيدة” لما بعد الحرب العالمية الثانية، تلك المكاسب التي انتُزعت بفعل نضالات الحركة العمالية والحركة النسوية العالميتين، المكاسب التي تجعل من “الرعاية” وظيفة اجتماعية، وليس وظيفة “بيولوجية” لصيقة بالمرأة. أدت تلك البرامج إلى اقنطاعات رهيبة من الرعاية الصحية والتعليمية والاهتمام بالفئات الهشة: الشيوخ بالدرجة الأولى.
وهنا نصل إلى الجانب الذي يتخلى فيه البروفيسور عن مقولة “كل مسلم تقدمي”. لقد كانت رعاية الشيوخ وظيفة اجتماعية تضطلع به القبيلة أو الأسرة الممتدة في المجتمعات السابقة للرأسمالية. أدت الثورة الصناعية وظهور العمل المأجور، إلى تفكك تلك الأشكال التقليدية، ورُمي بالقسم غير المشتغل من الطبقة العاملة (العاطلون عن العمل والمتقاعدون) إلى لجة البؤس، لكن نضالات الطبقة العاملة فرضت على البرجوازيين أن يضطلع المجتمع بحماية ذلك القسم غير المشتغل منها، عبر برامج الرعاية الاجتماعية: تقاعد ودُور رعاية. كان هذا “تقدميا” للغاية وناتجا عن النضال. لكن البروفيسور “المسلم التقدمي” يعتبر الأمر عكس ذلك، ويدعو إلى “أخلاق” انقرض أساسها الاجتماعي (القبيلة والأسرة الممتدة)، قائلا: “هذا مخالف لقيمنا، نحن نكرم الوالدين وهم دائما في قلوبنا”. وكأن دُور الرعاية الاجتماعية التي يشرف عليها المجتمع ليست “تكريما للوالدين”. يكرر البروفيسور حجة قديما للحسن الثاني عندما رفض إنشاء دور العجزة، بقول “إذا كانت دور رعاية المسنين أمرا عاديا في البلدان الغربية، إلا أنها أمر دخيل على مجتمعنا المسلم، لأن الله تعالى أوصانا ببر الوالدين”[4]. لكن الاختلاف الفعلي هو أن “الغرب” قد تمكنت فيه الحركة العمالية، من انتزاع مكسب دور المسنين لمتقاعديها، بينما في المغرب الحركة العمالية متخلفة كثيرا ولا تطالب حتى بذلك. هكذا يُسمح للعجزة أن يتحولوا إلى متسولي صدقات وإحسان على أن تتولى الدولة رعايتهم في دور المسنين.
يطلب البروفيسور من “الأسرة النووية” التي يشتغل أفرادها 12 ساعة يوميا والقاطنة في سكن اقتصادي أن ترعى الوالدين. لكن السبيل الوحيد لذلك هو تخفيض جذري لوقت العمل وسكن عمومي وبرامج رعاية اجتماعية عمومية مجانية، وكل هذا لا يدخل في ذهن البروفيسور “المسلم التقدمي”.
يلتقي البروفيسور الإسلامي والنيوليبرالية على أرضية تقديس الأسرة، فهذه الأخيرة هي التي ستحل محل الدولة التي كفت عن أن تكون “دولة رعاية اجتماعية”، مُلقية بمهام ضخام (رعاية الأطفال والشيوخ، بما فيها الرعاية الصحية) على عاتق النواة الجزيئية للمجتمع، أي الأسرة. وهذا هن سبب التفكك الأسري (الطلاق والعزوف عن الزواج)، أي تحميل الأسرة النووية مهاما تدعي العقيدة النيوليبرالية أن المجتمع/ الدولة لم يعد قادرا على تقديمها، وليس “الحريات الفردية” و”المساواة المطلقة” كما يحلو للبروفيسور لحلو أن يردد.
الغرب: كل منسجم
حسب الإسلاميين الغرب كل منسجم، وهو منظور معكوس لنفس المنظور الاستشراقي القائل: “الشرق كل منسجم”. تناول صادق جلال العظم خرافة الاستشراق والاستشراق المعكوس في كتابه
ذهنية التحريم”، بما يغنينا عن بسط هذا النقاش هنا بالتفصيل. لذا سنقتصر على متاهة البروفيسور في هذا المضمار.
في سجاله ضد الحداثة، قال البروفيسور: “… غزة تُظهر لنا أننا أمام إبادة جماعية، كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والحقوق العالمية، حقوق المرأة، حقوق الطفل… وهؤالاء كلهم يمزَّقون إربا، والمؤسسات الدولية التي يُفترض فيها أن تحمل رسالة قيم حقوق الإنسان العالمية عاجزة عن فعل أي شيء”.
وهنا يجري تصوير الغرب الحداثي واختصاره في الغرب الرسمي (المؤسسات الدولية، والدول الغربية)، ليظهرَ لنا غربا منسجما في مواجهة شرق/ مسلم منسجم. لكن هذا الانسجام لا يوجد إلا في ذهن البروفيسور. لقد هزت الاضطرابات والإضرابات ومختلف أشكال التضامن الغرب بطريقة لم يشهدها الشرق المسلم. ولا يُفسَر هذا بنزعة إنسانية خاصة بالغرب، بل مرة خرى بـ”البيئة الاجتماعية”، أي بالسياق السياسي للشرق المسلم حيث حركة النضال أضعف من نظيرتها بـ”الغرب الحداثي”، وبالاستبداد السافر في الشرق/ المسلم أكثر منه في “الغرب الحداثي”.
تعج وسائل التواصل الاجتماعي بفيديوهات لمواطنين “غربيين” يطردون إسرائيليين من مقاه ومنتجعات سياحية، وبرامج حوارية حيث أمريكيون وأمريكيات “يهزمون صهاينةً شر هزيمة”، غير قابلين الابتزازَ بالهولوكوست لتبرير مذبحة غزة. الغرب ليس فقط حكوماته ومؤسساته الدولية، بل شعوبه وحركاته المناضلة، وضمنها الحركة العمالية والحركات النسوية التي تناضل ضد الصهيونية وضد راعيها الإمبريالي.
إن “حقوق الإنسان” ومؤسساتها التي يعلن البروفيسور، بزهو، أنهيارها، ليست إلا ردَّ فعل الغرب الإمبريالي على صعود الشيوعية (الخطر القادم من الشرق!) وعلى حركات التحرر الوطني التقدمية (التمرد المنبعث من الجنوب!) طيلة النصف الثاني من القرن العشرين. وآنذاك كانت قوى الإسلام السياسي (دولا وحركات) في تحالف مقدس مع الغرب الإمبريالي ضد الشيوعية حركات التحرر الوطني التقدمية.
الحداثة: البروفيسور نشال صغير للأفكار
رفضُ الحداثة بالنسبة للبروفيسور لا يجد سندا له في وقائع حرب غزة فقط، بل يمد جذوره في موقف فلسفي. قال البروفيسور: “يجب أن نخرج من هذه المرجعية المتجذرة في الماضي، والتي تعتمد على الحداثة . الحداثة اليوم أصبحت متجاوَة إنها مرجعية تعود إلى القرن الثامن عشر، الحداثة تيار فلسفي تم تأطيره منذ نهاية القرن الثامن عشر ويتوقف عند القرن العشرين…”.
ولأننا أقل دراية واطلاعا من البروفيسور، نستنجد بصادق جلال العظم، الذي ميز في كتابه “دفاعا عن المادية والتاريخ” بين مفهومين للحداثة: “المفهوم الأول هو الحداثة بمعنى “المودرنيتي” (Modernity) وهو يشير، باختصار شديد، إلى حركة التاريخ الأوروبي ونتاجاتها من عصر النهضة والإصلاح الديني اللوثري حتى اليوم ومحركه الأول صعود نمط الإنتاج الرأسمالي وتوسعه. المفهوم الثاني هو الحداثة بمعنى “المودنيزم” (Modernism)، وهو حركة فنية أدبية فكرية أوروبية بدأت في أواخر القرن التاسع عشر وازدهرت وسيطرت في القرن العشرين”. وحسب العظم “الحداثة بمعنى “المودرنيزم” تنطوي على ردة فعل قوية على الحداثة بمفهومها الأول “الموديرنيتي”، وعلى عملية نقد وتجريح وتسفيه لها تصل عند البعض إلى حد رفضها الكامل… لصالح حنين رومانسي شديد إلى أزمنة طوباوية غابرة سابقة على الحداثة بمعنى “الموديرنيتي”. بعض ممثلي الجناح اليميني في حركة الحداثة بمعنى “المودرنيزم” يميلون إلى الانسحاب الروحي من العالم الحديث بتبني مواقف ذاتية جمالية صرفة أو أخلاقية متعلية جدا أو دينية تصوفية خالصة في مواجهة الحداثة والتاريخ الحديث. إنهم الباحثون عن الخلاص- الفردي أحيانا، والجماعي في أحيان أخرى- في تجربة العودة إلى ماض مثالي لم يوجد قط إلا في مخيلتها، أو إلى صور طوباوية تماما عن الإغريق القدماء أو عن عصور الدفء والإيمان القروسطية أو عن روحانية الشرق المزعومة أو عن بدائية الإنسان الأول وبساطته أو عن أي شيء تحب تركيبه وتجميله في مخيلتك”.
ينتمي البروفيسور لحلو إلى الجناح اليميني من الحداثة بمفهوما الثاني “المودرنيزم”، رافضا المستتبعات الأيديولوجية والقيمية للحداثة بمفهومها الأول “المودرينيتي”. ولكن لأن المبدأ هو “الرفض إلى أن يثبت العكس”، فإن البروفيسور لا يرفض الحداثة بمعناها الاقتصادي الرأسمالي، ولا يدعو إلى “الانسجاب الروحي من العالم الحديث”، بل إلى الانخراط فيه والتفوق عليه بوسائله، ومن هنا دفاعه الشديد عن “التمويل الإسلامي” و”البنوك الإسلامية” و”الاقتصاد الإسلامي”… وهذه كلها تنويعات لشيء واحد: اقتصاد رأسمالي بغلاف ديني. وهذا ليس خاصا بالإسلاميين، فهناك أيضا بنوك مسيحية مثل “بنك المملكة” في بريطانيا، الذي يعزف نفس معزوفة البنوك الإسلامية: “لدينا تاريخ غني في تزويد الكنائس والوزارات المسيحية بحلول مالية لدعم رؤيتها ورسالتها”، وبنك “باكس بانك”، في ألمانيا وهو “هو مصرف ألماني يركز على التمويل المسيحي ومقره في مدينة كولونيا. يذكر البنك أنه (بالألمانية: Bank für Kirche und Caritas) أي مصرف الكنيسة والجمعيات الخيرية، وهو مصرف شامل كاثوليكي تعاوني. يتألف أعضاؤه من مؤسسات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وأفراد من المجال الديني. تأسس المصرف كمنظمة مساعدة ذاتية من قبل الكهنة ومن أجلهم في عام 1917 في كولونيا”.
هذه البنوك المسيحية أقدم من البنوك الإسلامية، وما يقوم به دعاة البنوك الإسلامية لا يتعدى اقتفاء أثر إخوانهم الغربيين/ المسيحيين. وليس هذا خاصا بالتمويل والاقتصاد، بل أيضا في ما يخص رفض الحداثة. فمُلهم رفض الحداثة في أوروبا هو الفيلسوف الوجودي هايدغر، وهو واحد “من أهم وأبرز المنظرين للجناح اليميني في الحداثة الأوروبية بمفهوم “الموديرنيزم” ومن أكثرهم عداء ورفضا للحداثة عموما أي بمفهوم “الموديرنيتي”، حسب صادق جلال العظم. يعتبر هايدجر كل التاريخ الأوروبي ما بعد الحضارة اليونانية (يُطلق عليه هايدجر الوحي اليوناني) “جاهلية”، وهو ما اقتبسه منه المنظرون الإسلاميون الأوائل (مثل أبو الأعلى المودودي في باكستان) الذين تأثر بهم الإسلاميون المغاربة، معتبرين كل التاريخ الإسلامي ما بعد النبوة “جاهلية”، وكما يدعو هايدجر إلى الرجوع إلى السلف اليوناني، يدعو الإسلاميون إلى الرجوع إلى السلف الصالح.
لم يكن السلفيون الأوائل رافضين للحداثة الأوروبية بالمفهوم الأول “المودرينيتي”، بل أعلنوا النهضة العربية مقتبسين من أوروبا وسائل اللحاق بها (محمد عبده، جمال الدين الأفغاني… إلخ). في أوروبا شهدت الحداثة بمعناها الثاني “مودرنيزم” ميلادها مع غرق الحضارة الأوروبية في وحل الحروب العالمية والدم والتضحيات البشرية الهائلة، فظهر التيار اليميني من المودرنيزم الرافض لكل حضارة مادية، داعيا إلى الرجوع إلى السلف الصالح/ اليوناني، ومقتفيا آثار هذا التيار الأوروبي، ظهر أيضا مُقَلِّدُهُ في العالم الإسلامي، رافضا كل الحداثة الأوروبية، داعيا إلى الرجوع إلى السلف الصالح/ الإسلامي. وصدق صادق جلال العظم عندما أعلن: “يبقى المعلم الأول ومصدر الوحي الأصلي في كل هذا هو مارتن هايدجر”، وهايدجر هو النبي الحقيقي ومصدر الوحي الأصلي الفعلي للبروفيسور طلال الحلو.
إما ما يسميه البروفيسور “تجاوز الحداثة”، ليس إلا ما يُطلق عليه في الغرب (خصوصا في الولايات المتحدة): “ما بعد الحداثوية/ Postmodernism)”، ومؤداها محاربة كل فكر علمي منهجي، وإحلال “الفوضوية المعرفية/ الابستمولوجية” محلها. وهذا هو ملخص مناظرة البروفيسور ضد الأستاذ أحمد عصيد. إذ ينتقي من كل “حديقة معرفية زهرة” تتيح له هزم الأستاذ. ولم تكن غاية البروفيسور إنتاج خطاب “علمي منسجم، بل هزم مساجله بالدرجة الأولى. هكذا ينتهي “تجاوز الحداثة” كما بشر به البروفيسور”، إلى خليط انتقائي من الفلسفات الغربية الشذرية لما بعد الحداثة والوجودية (اليمينة) مع بهارات دينية.
إن التجاوز الذي ندعو إليه، هو تجاوز الحداثة البرجوازية، أي تجاوز الاقتصادي الرأسمالي، وليس تجميله أخلاقيا (علمانية كان تلك الأخلاق أو دينية)، أي بناء اقتصاد تشاركي يكون فيه المنتجون- ات الفعليون- ات الحقيقيون- ات هم من يتحكمون بالإنتاج، أحرارا من كل إكراه ومن كل ضرورة، أحرارا من الأوهام كيفما كانت. مجتمع يضبط الإنتاج وفق خطة موجِّهة ومتصورة سلفا وبشكل “ديمقراطي” جماعي، وليس مجتمعا تسيره قوى السوق المجهولة، هذا السوق التي لا يسعى الإسلاميون، وضمنهم البروفيسور الحلو، إلى تجاوزها.
إسلاميو السوق
ليس البروفيسور سوى النسخة المغربية من إسلاميي السوق الذين ظهروا في الشرق منذ مدة بعيدة. وقدَّم عنهم باتريك هايني، دراسة عيانية صدرت في كتاب تحت عنوان “إسلام السوق”، معلنا أن “الصورة التقليدية للإسلام السياسي تُبدي… بعض مظاهر التراجع” عما كانت عليه سابقا، تحت وقع ظهور ومنافسة “مُتعهِّدين (Entrepreneurs) دينيين جدد مستقلين وأقل اهتماما بالنماذج السياسية الكبرى، تضم هذه القائمة دعاة جددا تخلصوا من الهاجس النضالي، ومثقفين تصالحوا مع نماذج الحداثة السياسية الغربية، وكتابا أخلاقيين متنوعين، ومقدمي برامج تلفزيونية جوارية يوصفون بالورع، وداعيات “الصالون الإسلامي” في الأحياء الراقية…”. وتكمن كبوة أحمد عصيد، في أنه تصوَّر أنه كان يساجل إسلاميا ينتمي إلى الإسلام السياسي التقليدي، وليس إسلاميا ينتمي إلى إسلام المنجمنت/ إسلام السوق.
تلقى الإسلاميون الجدد/ أسلاميو السوق تكوينهم الأكاديمي بأدبيات “المنجمنت”، خصوصا في جامعات العالم الأنجلوساكسوني (بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية)، وهو حال البروفيسيور طلال الحلو الذي حصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد بجامعة أستون البريطانية. وعكس الإسلاميين التقليديين الملتزمين سياسيا، لا يرفض إسلاميو السوق هؤلاء الاقتصاد الرأسمالي الغربي، بل يبشرون بأنه بالإمكان التفوق على الغرب في حلبته بالذات: الاقتصاد الرأسمالي الإسلامي. إنه حسب بارتيك هايني “الإسلام بالمشاريع” “الضامن لنيوليبرالية تتزامن، وبشكل مزدوج مع الواقع الذي يجتازه الإسلام السياسي حاليا: فمن جهة، إنه يكرس حالة من البرجزة التي تطال المنتمين، ومن جهة ثانية، يوفر لهؤلاء قاعدة أيديولوجية “هشة من الناحية السياسية” حيث لم تعد الدولة هي التحدي الأساس”، عكس الإسلاميين التقليديين، الذي كانوا يعتبرون الاستيلاء على السلطة هدفهم الأول ووسيلتهم لبناء مجتمع إسلامي بديل، “ليس شرقيا/ أي ليس شيوعيا، وليس غربيا/ أي ليس رأسماليا).
والأهم، حسب كتاب باتريك هايني، هو أن إسلاميي السوق هؤلاء أكثر تصالحا مع النموذج الرأسمالي الأنجلوساكسوني/ الأمريكي، الذي يولي أهمية أكبر للدين وللمؤسسات الدينية، بينما يعادون بشراسة النموذج الأوروبي/ الفرنسي أساسا، العلماني.
هذا هو المشروع الحضاري للبروفيسور طلال الحلو، مشروع رأسمالي يتدثر بإسلام غير صدامي، سواء مع السلطة السياسية أو مع الإمبريالية/ الأنجلوساكسونية بالخصوص. وهذا هو وجه “التقدم” الذي حصل في الإسلام السياسي الخاص بالبروفيسور طلال الحلو، وهو “تقدم مفيد”، تقدُّم من حركات تعلن شعارا عاما هو “الإسلام هو الحل” دون تفصيل برنامجي، ما يتيح لها خداع قسم مهم من الكادحين- ات، إلى إسلاميين يفصلون برنامجهم الاقتصادي بطريقة تُظهر حقيقة الإسلاميين كدعاة اقتصاد رأسمالي، ما يساعد إلى تبين حقيقتهم الطبقية من طرف الكادحين- ات.
عندما نرفض المشاريع السياسية لحركات الإسلام السياسي، فإن صلب رفضنا هو النظام الاقتصادي/ الاجتماعي الذي تبشر به تلك الحركات، وما النظام السياسي الديني إلا انعكاسا لنفس ذلك النظام، أي خدما له: استبداد سياسي ديني في لترسيخ اقتصاد رأسمالي قائم على اضطهاد أغلبية الشعب واستغلالها اقتصاديا.
[1]– 24-07-2025, https://www.youtube.com/watch?v=J5W-aQzrSiA.
[2]– Youssef Chaoui (28-07-2025), «Le projet de société du Dr. Lahlou : Chronique d’une régression», https://enass.ma/le-projet-de-societe-du-dr-lahlou-chronique-dune-regression.
[3]– https://www.imf.org/ar/Publications/fandd/issues/2024/03/PIE-the-accessibility-economist-Bob-Simison.
[4]– حسن البصري (11-07-2018)، “مولاي أحمد العلوي (وزير دولة سابق)الحسن الثاني يرفض مقترحا بتدشين دار للمسنين ويعتبرها ضربا لقيم التماسك الإنساني”، https://www.alakhbar.press.ma/مولاي-أحمد-العلوي-وزير-دولة-سابقالحسن-57533.html.