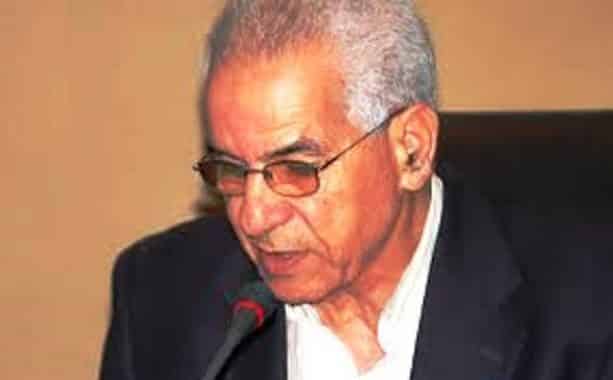مقدمة: النية التأسيسية وإغراء اليقين
يقدم الدكتور محمد البشاري في مقاله “النص الديني في حضرة الفلسفة”، المنشور في جريدة الاتحاد الإماراتية، محاولةً تستحق المساءلة؛ إذ يسعى إلى تأكيد مركزية النص الديني بوصفه مُنْتَجًا للعقل المسلم ومُؤَسِّسًا لاستقلاليته عن الموروث اليوناني. غير أن هذه النية التأسيسية، على نبْلِ مقصدها، تتحول إلى مأزق منهجي حين تُخضع التعددية التاريخية والجدل الفلسفي لرغبة في “الانسجام” تُخفي تناقضاتٍ جوهرية. فالسؤال الجوهري الذي يُطْرَح هنا ليس عن صحة الدور الذي لعبه النص، بل عن طبيعة هذا الدور في سياقه التاريخي المتشابك، وعن إمكانية قولبة علاقة النص بالعقل في إطار خطي وسلس.
الإشكالية المنهجية: التعميم وسوء فهم التاريخ
يسقط المقال في ما يمكن تسميته “مغالطة الكلية”، أي اعتبار أن ما يصح في بعض الحالات يصح دائمًا وفي كل السياقات، دون تمييز أو تفصيل. وهي مغالطة منهجية تقع حين يُعمّم حكم جزئي ليصبح قاعدة مطلقة، كما لو أن حضور النص الديني في بعض مراحل الفكر الإسلامي يعني بالضرورة حضوره الفاعل في جميع المراحل. وهذا يرتبط أيضًا بما يمكن تسميته “الضرورة التاريخية المطلقة”، أي الاعتقاد بأن التاريخ يسير في خط واحد حتمي، لا يتغير ولا يتناقض، وكأن النص كان دومًا محرّكًا للعقل، لا عائقًا له.
لكن هذا التصور لا يُعبّر عن طبيعة التاريخ كعلم، بل عن قراءة اختزالية له. فالتاريخ المعرفي، كما بيّن فوكو وباشلار، لا يسير دائمًا بالتراكم، بل يعرف قطائع إبستيمية تفصل بين أنظمة معرفية متباينة، وتُحدث تحولات جذرية في منطق التفكير ذاته. وفي الوقت نفسه، لا يخلو التاريخ من لحظات انسجام واستمرارية، لكن فهمه يتطلب وعيًا بالتعدد والتوتر، لا الاكتفاء بسردية واحدة.
كما رأى هيغل، الروح لا تتقدم إلا عبر الصراع والتناقض، لا عبر انسجام ثابت. إن تاريخ الفلسفة الإسلامية، في واقع الأمر، هو مسرح لهذا الجدل، حيث شكّل النص أحيانًا سلطةً مُقَوْلِبَةً تُقيّد العقل، وليس دائمًا مُحَرِّرَةً له. ومن هنا، فإن القول بأن النص كان “على الدوام طرفاً فاعلاً” يُغفل تعقيدات العلاقة بين النص والعقل، ويُسقط إمكانيات التأويل المتعددة التي عرفها الفكر الإسلامي في لحظاته الحرجة.
لحظات التوتر: حين يكون النص حاجزًا وليس جسرًا
إن التصور الهادئ لعلاقة النص بالفلسفة يتناقض مع الوقائع التاريخية التي تشهد على “صدمة اللقاء” بين سلطتين: سلطة الوحي وسلطة العقل. لقد أغفل المقال أن عملية “إنتاج” المعنى الفلسفي كانت تتم غالبًا في حالة من القلق التأويلي، وليس في حالة من اليقين التكاملي.
* محنة ابن رشد ليست مجرد حادثة عابرة، بل نموذج لصراع السلطات. فالنص، كما فُسِّرَ ومُوِّرَسَ سلطويًا من قبل الفقهاء، أصبح أداةً لإسكات صوت العقل الفلسفي، حتى وهو يدافع عن التوافق. وهذا يتطابق مع تحذير أنطونيو غرامشي من هيمنة الثقافة السائدة التي تستخدم الأدوات الرمزية، بما فيها النصوص المقدسة، للحفاظ على سلطتها.
* نقد الغزالي في “تهافت الفلاسفة” لا يمثل مجرد خلاف أكاديمي، بل هو هجوم منهجي على شرعية الفلسفة ذاتها في الاقتراب من “الحقيقة” المطلقة. الغزالي، بحجة حماية النص، قام بتأسيس حدود للمعقولية استبعَدَتْ ما يراه غير متوافق مع ظاهر النص، كما في مسألة “قدم العالم”. يقول:“وأما قدم العالم، فهو مخالف للشرع، ولا يجوز تأويله.”
* المقولات الفقهية المُعادية للمنطق مثل “من تمنطق فقد تزندق”، تظهر أن “النص” كمفهوم مُتَجَسِّد في المؤسسة الفقهية، لم يكن دائمًا حاضنًا للعقل، بل كان في لحظات كثيرة حاجزًا أمام أدواته الأساسية. وهذا يذكرنا بتمييز إمانويل كانط بين “استخدام العقل” و”إساءة استخدام العقل”، حيث تم اتهام الفلاسفة بإساءة استخدامه لمجرد خوضهم في مسائل اعتُبرت من محظورات النص.
الاختزال والتبسيط: إخفاء التعقيد تحت غطاء التأصيل
يقدم المقال قراءةً مبسطةً لأعمال كبار الفلاسفة، مجردًا إياهم من تعقيدات مشاريعهم التركيبية. فوصف مشروع الفارابي في آراء أهل المدينة الفاضلة بأنه مجرد إعادة تعريف للاجتماع الإنساني “في ضوء النبوة” هو اختزالٌ كبير. فالفارابي، المتأثر بـأفلاطون وأرسطو، يبني نسقًا وجوديًا ومعرفيًا معقدًا، حيث “العقل الفعال” هو مصدر الوحي، مما يضع الفيلسوف والنبي في مستوى إدراكي متقارب، بل وقد يفضل الفيلسوف أحيانًا. يقول الفارابي:
“الرئيس الأول هو الذي يتلقى عن العقل الفعال، وهو الذي يشرّع ويهدي.”
هذا التركيب بين الأفلاطونية والأرسطية والإسلامية هو لبّ الإبداع الفلسفي، وليس مجرد تبعية “لضوء النبوة”.
غياب الحفر المفاهيمي والاستشهاد النصي
يخلو المقال من الحفر المفاهيمي في مصطلحات محورية مثل “الأصيل” و”الآخر”. فما هو “الأصيل”؟ هل هو جوهر ثابت أم نتاج صيرورة تاريخية؟ هذا السؤال، الذي شغل فلاسفة مثل هايدغر في بحثه عن الكينونة، يُتْرك بدون إجابة. كما أن غياب الاقتباسات المباشرة من نصوص الكندي والفارابي وابن رشد يحوّل الطرح إلى خطاب إنشائي يفتقر إلى الدقة العلمية. مثلًا، الكندي يقول:
“ينبغي لنا ألا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى…”
وابن رشد يكتب:
“الشرع لا يخالف العقل الصريح، ولا الصريح يخالف ظاهر الشرع.”
هذه النصوص كانت ستمنح المقال عمقًا مرجعيًا وتحليليًا.
تجاهل التعددية الداخلية: وهم النص الموحد
يتعامل المقال مع “النص الديني” ككيان أحادي متجانس، متجاهلاً التعددية التأويلية الهائلة التي شكلت تاريخ الفكر الإسلامي. فالنص في قراءة المعتزلة العقلانية ليس هو النص في قراءة الأشاعرة أو الصوفية. لقد أظهر بول ريكور أن النص، بمجرد كتابته، ينفصل عن قائله ويصبح ملكًا لتعددية القراءات. يقول:
“النص لا يعود إلى نية المؤلف، بل إلى أفق القارئ.”
إغفال هذا “الكون من التأويلات” هو إغفال للطبيعة الأساسية للظاهرة النصية ذاتها.
قراءة انتقائية لتجربة ابن رشد: إغفال السياق والتأثير
يُقدّم ابن رشد كرمز للتوافق الناجح، لكن هذه القراءة تتجاهل السياق التراجيدي لمشروعه. ففكرة “الحقيقة المزدوجة” أو التوفيقية لم تُقبل في عصره، وتم إقصاؤها. الأهم من ذلك، أن تأثير ابن رشد كان أعظم خارج العالم الإسلامي، حيث شكّل “الرشدية اللاتينية” أساسًا للإيمان بالعقل في أوروبا، كما يظهر في فكر سيجر البرابانتي وتوما الأكويني. هذا يُظهر أن “فاعلية” النص لم تكن محكومة بنصانيته، بل بسياقات تأويله الاجتماعية والسياسية.
نحو منهجية تعددية نقدية: محاولات اجتهادية لها ما لها وعليها ما عليها
لتجاوز الإشكاليات المنهجية في قراءة النص الديني، يمكن التوقف عند بعض المحاولات الفكرية التي سعت إلى تقديم منهجيات بديلة أو مكملة لما هو متداول في الساحة الفكرية. وهي اجتهادات لها ما لها وعليها ما عليها، لكنها تفتح أفقًا للتفكير خارج النسق التقليدي، وتعيد مساءلة العلاقة بين النص والعقل ضمن رؤى متعددة:
* محمد أركون: في نقده لعقلانية الإسلام، حيث دعا إلى تجاوز القراءات الأرثوذكسية عبر مقاربة أنثروبولوجية وتاريخية للنصوص، مؤكدًا على ضرورة تحرير الفكر الإسلامي من سلطة الممنوعات المعرفية.
* طه عبد الرحمن: في مشروعه لتجديد المنهج، حيث حاول بناء أدوات نقدية داخلية تنطلق من روح التراث، دون الوقوع في التبعية للمناهج الغربية، مع الاعتراف بوجود “هجرات مفاهيمية” لا يمكن إنكارها.
* جورج طرابيشي: في منهجه التاريخي النقدي، الذي فكك تطور الأفكار في سياقاتها، ورفض القراءات التمجيدية التي تُغفل التناقضات الداخلية في الفكر العربي الإسلامي.
* عبد الكبير الخطيبي: في تفكيكه للذات والآخر، حيث اشتغل على الهوامش والمسكوت عنه، مؤكدًا أن الهوية لا تُبنى إلا عبر مساءلة مستمرة للذات في علاقتها بالتراث والحداثة.
ومن بين النماذج التي أثارت جدلًا واسعًا في تأويل النص الديني، يمكن الإشارة إلى:
* نصر حامد أبو زيد: الذي قرأ النص القرآني بوصفه “منتجًا ثقافيًا”، يخضع لقوانين اللغة والتاريخ، لا كيانًا فوق التاريخ. سعى إلى تحرير النص من سلطة التقديس المغلقة، دون أن ينكر قداسته، بل ليمنحه قابلية للتأويل المتعدد. وقد أثارت أطروحاته نقاشًا حادًا حول العلاقة بين النص والمعنى، بين الإيمان والتأويل، وانتهت إلى محاكمته قضائيًا في قضية “الردة”، مما يكشف حجم التوتر بين التأويل الحر والمؤسسة الدينية.
* محمد محمود طه (السوداني): صاحب “الرسالة الثانية من الإسلام”، الذي ميّز بين مستوى الرسالة المكية والمدنية، معتبرًا أن الأولى تمثل جوهر الدين من حيث الحرية والمساواة، بينما الثانية جاءت استجابة لواقع اجتماعي محدد. دعا إلى تجاوز الأحكام الفقهية التقليدية نحو فهم إنساني للنص، مما أدى إلى إعدامه عام 1985 بتهمة الردة، في واحدة من أكثر المحاكمات الفكرية مأساوية في العالم الإسلامي الحديث.
هذه المنهجيات لا تُطرح كبدائل نهائية، بل كمداخل متعددة لمساءلة النص من داخله، عبر أدوات معرفية متنوعة، تسمح بفتح أفق تأويلي جديد يعترف بالتاريخ، ويحتفي بالاختلاف، ويعيد الاعتبار للعقل دون أن ينفي الوحي.
خاتمة: خصوصية السياق الإسلامي واستعادة التوتر الخلاق
إن قراءة العلاقة بين النص الديني والفلسفة في السياق الإسلامي لا يمكن أن تُختزل في نماذج أوروبية نشأت في ظل سياق مسيحي مختلف جذريًا من حيث البنية اللاهوتية والتاريخية. فالنص الإسلامي، بخلاف النص المسيحي، يتمتع بسلطة تشريعية مباشرة، ويُقيد التأويل بجملة من الأصول المنهجية، مما يجعل العلاقة بين العقل والنص أكثر تعقيدًا وتركيبًا.
ومع ذلك، فإن هذا السياق لم يكن مغلقًا على ذاته، بل عرف لحظات توتر خلاق، كما في تجربة ابن رشد، الذي لم يسعَ إلى تجاوز النص، بل إلى تأويله عقلانيًا، مؤكدًا أن “الحق لا يضاد الحق”. فالفكر الإسلامي لا ينمو في ظل انسجام مصطنع، بل في فضاء نقدي يعترف بالتعدد، ويحتفي بالاختلاف، ويعيد مساءلة المفاهيم من داخل بنيتها.
الخلاصة ليست في نفي دور النص أو تقديسه، بل في فهمه كحقل دلالي مفتوح على إمكانيات تأويلية متعددة، دارسًا إياه في سياقه التاريخي بكل تعقيداته وتناقضاته. وحدها القراءة النقدية، المتشبعة بوعي فلسفي وإبستيمولوجي، قادرة على استعادة الإرث الفلسفي الإسلامي ليس كذكرى مجيدة، بل كمنبع حي لإلهام الحاضر وتأسيس مستقبل فكري لا يخشى السؤال ولا يهاب التعدد.
إن الفلسفة الإسلامية لا تُستعاد عبر التمجيد، بل تُبعث من جديد حين نعيد مساءلة النص، ونمنح العقل حقه في التأويل، ونفتح الباب أمام التفاعل الخلاق بين الأصول والتاريخ، بين الوحي والعقل، وبين الثابت والمتحول.