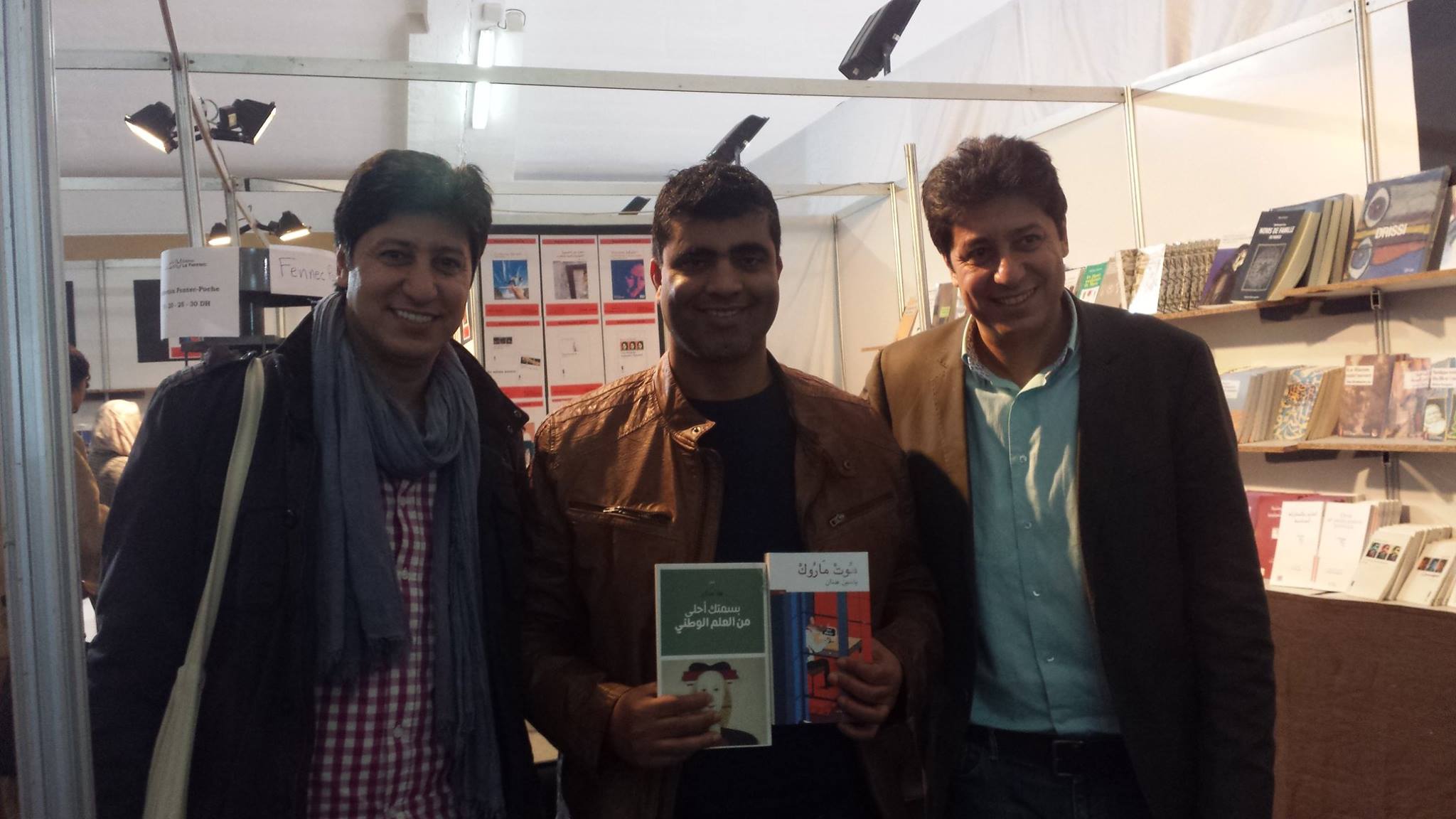
لم يمنعه التوقف عن تلقي تعليمه النظامي في سن صغيرة، لظروف خاصة، من التنقيب عن جمرة الإبداع داخله، والتي نفخ في شراراتها الأولى عبر المواظبة على التعليم الذاتي والتهام كل أنواع الكتب الأدبية والفكرية والسياسية، قبل أن يحرص على أن يحافظ عليها مُتَّقدة من خلال أولى محاولاته الشعرية والقصصية المنشورة في جرائد وطنية.
مصطفى الحمداوي الوكيلي، ابن جبال الريف، كاتب عصامي وروائي غزير الإنتاج، استطاع أن يجد لأدبه موضع قدم، وأن يتردد اسمه على منصات التتويج العربية، حائزا على جائزة الفجيرة للموندراما وجائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة أكيودي الصينية وجائزة الهجرة بأمستردام، وجائزة كاتارا للرواية العربية.
ولم تمنع الهجرة إلى الديار الهولندية الممتدة طيلة 25 عاما، الكاتب المغربي المنحدر من مدينة الدريوش من الحفاظ على رونق كتاباته وإصداراته باللغة العربية، مُبدعا رواية “غواية الجسد”، ورواية “حب دافئ تحت الثلج”، ورواية “الشيطان والورد” ورواية “ظل الأميرة” ورواية “مأساة الفتاة التي” وكتاب “غابرييل غارسيا ماركيز في دائرة الواقعية السحرية”.
أما آخر إصدارات الأديب المغربي، فرأت النور الأسبوع الأخير من العام المنصرم، أطلق عليها اسم “الكونتيسة” عن دار “الفاصلة” للنشر.
للحديث عن الرواية الجديدة وعن أدب مصطفى الحمداوي وتجربته في مجال الكتابة، كان لـ “العمق المغربي” الحوار التالي معه:
حدثنا عن روايتك الجديدة، لماذا ” الكونتيسة”؟
كما نعلم جميعاً فإن العنوان يعد عتبة أساسية للنص الروائي، ومن هذا المنطلق ينبغي نظريا انتقاء عنوان “مناسب” للرواية. كما أنه ليس بالضرورة أن يعكس العنوان دائما محتوى ومضمون الأحداث، ولكنه وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن يكون بعيداً عنها.
وبالعودة إلى “الكونتيسة” كبوابة أو كعنوان للرواية، يجب أن أوضح بأن الرواية تستند في الكثير من أحداثها على أسطورة “عيشة قنديشة”، ولكنها لا تتناول هذه الأسطورة على النحو التقليدي المتعارف عليه في المخيال الشعبي المغربي.
بل إن الرواية تحاول التأسيس، بطرق ومقاربات مبتكرة، لبناء على أنقاض هذه الأسطورة أحداثا يومية، بقوالب فيها نظرة ربما تكون مختلفة وجديدة نحو العشق والفن وطرق الحياة التي يختارها البعض لأنفسهم كمنهج وفلسفة يعيشونها عمليا في الحياة.
اسم قنديشة، كما هو معروف، اشتقاق من كلمة القديسة أو الكونتيسة، على الأقل كما يرجح بعض الباحثين، ومن هنا جاء العنوان.
تقيم خارج أرض الوطن منذ ربع قرن، ولا زلت وفيا للغة العربية والإبداع بها، لماذا هذا الاختيار؟
لأكون منسجما مع نفسي، يجب أن أقول بأنه لم يكن لدي أي خيار آخر سوى الكتابة باللغة العربية، لأن الإبداع بلغة أخرى يتطلب إلماما قويا باللغة وأسرارها وسحرها وجمالياتها، وهذا ما لم يتوفر لي منذ البداية.
ثم من جهة أخرى، وهنا أظل وفيا للصراحة والمصداقية، أنا عاشق للغة العربية إلى الدرجة التي جعلتني دائما أتساءل وأنا أقرأ نصوصا مترجمة إلى اللغة العربية من قِبل مترجمين متمكنين، “هل صاحب العمل هو الذي أجاد وأتقن في صنع لوحات لغوية زاخرة بالجمال والسحر، أم إعادة “تدوير” لغة النص إلى العربية هو السر في جعله يزخر بنكهة خاصة وخالصة ولها خصوصية متفردة وجميلة إلى أقصى حد”؟!
وأخيراً لا يمكنني أن أنفي أيضا انتمائي ووفائي وانعكاس ثقافتي العربية على هذا الاختيار، ولا شك أنه اختيار تضافرت فيه عناصر عدة لتحدد مصيره على النحو الذي هو عليه الآن.
كيف تتلقى ردود أفعال القراء على رواياتك؟
عندما يتعلق الأمر بالقراء، فإنني في الغالب، أتلقى ردود أفعال تحفزني أكثر على الكتابة والإبداع، ردود فعل مشجعة دائما تقريبا، وأشعر أنني أكتب شيئا يشكل إضافة للمشهد الروائي المغربي وربما العربي أيضا، لأنني أكتب وفق مدرسة خاصة.
وللصراحة، هناك قارئ من مستوى عال، صنف روايتي “ظل الأميرة” بأنها قد تكون أفضل رواية تناولت التاريخ الأمازيغي والشأن الأمازيغي في تيمتها والطريقة التي كتبت بها، وهذا في حد ذاته يعد بالنسبة لي تشجيعاً جميلا من قارئ ومبدع كبير يشرفني كثيرا أن أسمع منهُ مثل هذا الكلام.
والشيء نفسه يتعلق بروايات أخرى، خصوصا رواية “الشيطان والورد” التي قُرِأت على نطاق كبير في المغرب، وكانت أغلب ردود الفعل حولها إيجابية للغاية.
هل يقرأ لك مغاربة الخارج أكثر؟
قرائي في المهجر كثيرون، ولكن وبنظرة منطقية لا يمكنني أن أجزم بأنهم هم من يقرؤون أعمالي أكثر، فإلى جانب قلتهم نسبيا طبعاً، فهم لا يحصلون على رواياتي بسهولة، فهناك طرق عدة يصلون من خلالها إلى رواياتي، بعضها بالإهداء، وبعضها الآخر عبر اقتنائها، ولكن كل ذلك غير كاف إطلاقاً بسبب بعدهم عن موقع تواجد كتبي، ولكنهم يدعمونني ويحفزونني وألقى منهم دائما كامل التشجيع، وهذا هو الأهم بالنسبة إلي.
لمن يكتب مصطفى الحمداوي؟
كان يمكنني ببساطة أن أجيب على هذا السؤال بالجواب التقليدي المعروف، مثلا أنني أكتب للفئات المهمشة، أو أكتب للدفاع عن القضايا العادلة، أو الكثير من الإجابات المشابهة.
ولكن الحقيقة هي أنني أشعر دائما بحاجتي لأبدع شيئا جميلا، شيئا يستمتع به الناس، وهنا يجب أن نفرق بين الفرجة والمتعة، فالجمال قيمة تكمن في كونه يهذب المشاعر، ويمحو البشاعة من حياتنا اليومية، ويعطي طعما خاصا لوجودنا، وبالنتيجة نصل في النهاية إلى كل الأهداف التي نحاول توضيحها من خلال السؤال المتكرر دائما: لمن ولماذا نكتب؟
أجيب بأنني أكتب لمن يجد نفسه وذوقهُ فيما أكتب، ويتماهى إيجابا مع كتاباتي، ولا ضير في أن يختلف معي القارئ، لأنني أعتبر القارئ هو الناقد الثاني بعد الكاتب نفسه، قبل الناقد المحترف.
ما أو من الذي يلهم ويحفز الروائي داخلك للإبداع والكتابة؟
كل ما هو مستفز يلهمني لأكتب، أرى شيئا بغيضا، أشعر بالاستفزاز فأتصدى له لأمحوه بطريقة مناسبة، طريقة قد تتجلى في النقيض مثلا.
المرأة مصدر مستمر ولا يتوقف عن منح الإلهام، لأن المرأة هي الكائن الأجمل، والأكثر اكتمالا في الأرض، حتى العناصر الطبيعية فائقة الجمال لا تضاهي جمال المرأة.
وأخيراً هناك إلهام “محايد”، يعتمد على قوة خيال الكاتب واتساع رقعة تفكيره، لا أعتقد أن الأشياء الملموسة وحدها كافية لتلهم الكاتب، لا بد من خلق عوالم تشبه في ظاهرها الغيب كي نكتب ونستمر في الكتابة بنَفس أقوى وأجمل.
رؤيتنا لأي شيء ستكون مختلفة ومتناقضة غالباً، لأن الزاوية التي ينظر منها الكاتب، هي زاوية نائية وغير مرتبطة بالحسي والملموس، بل دائما ما تتوافق هذه الرؤية مع ذوق الكاتب ومقدرته على التقاط الجزئيات البسيطة في ظاهرها، ولكنها أكثر عمقا بكثير حينما يتم عرضها في قالب إبداعي محض. ولهذا فنظرتنا للمرأة هي نظرة فلسفية ووجودية وبعيدة عن الابتذال والتبسيط، إن المرأة محور الوجود، ومن خلالها نرى الوجود، ولأجلها تصبح لحياتنا جدوى وفعالية وقيمة.
هل أثرت الهجرة والغربة في اختيارات تيمات رواياتك وأحداثها؟
إلى حد ما نعم، أعتقد أن وجود أي شخص، وفي أي بيئة، بالضرورة الحتمية ستجعل هذه البيئة إبداعه يأخذ بشكل أو آخر من المحيط الذي يعيش داخله. أنا أقيم منذ سنوات في هولندا، وبالنتيجة أتأثر ثقافيا وعلى كافة المستويات سواء من الجانب الثقافي أو نمط عيش وطريقة التفكير.
وفي النهاية يخضع إنتاجي الإبداعي للكثير من شروط هذه الإقامة الطويلة وتأثيراتها، أعتقد أنني محظوظ لوجودي وسط ثقافة مختلفة ومتجذرة في التحضر والتاريخ، ومن هنا لا يمكنني إلا أن أُراكم الكثير من القيم والأخلاقيات التي تثري شخصيتي في الحياة اليومية، أو في مجال الإبداع.
وبعد كل هذه السنوات الطويلة لا يمكنني مطلقاً الحديث عن “غربة”، لقد استأنست بالمكان، وأصبحنا نتبادل الأدوار، حينما أكون فيه، أكون أنا في موطني الأصلي، وحينما أكون في موطني الأصلي، استحضر مكان إقامتي بكثير من الحنين والنوستالجيا.
حصلت على عدة جوائز عربية ودولية، هل تحفز ثقافة التقدير والاعتراف قريحة المبدع وتدفعه للإبداع أكثر؟
الجوائز تمنح الحافز لتكتب بحماس أكثر، ولتكتب بدوافع متعددة تجعلك تؤمن في النهاية أن لكتاباتك جدوى. إذ أن أكثر ما يحبط الكاتب هو “اللا جدوى”.
هناك كم هائل من المواهب تضيع باستمرار لأنها لا تجد العناية الواجبة، وفي ظل غياب اهتمام من الجهات المعنية بالكُتاب والإبداع بشكل خاص، تبقى للجوائز قيمة تتجاوز القيمة المادية التي تمنح لصاحبها، إنه اعتراف يحتاجه المبدع دائما ليستمر في الإبداع والخلق.
شخصيا أشعر بالاستياء من هؤلاء الذين يحاولون بيأس الحط من قدر الجوائز وظروف منحها، فكيفما كان الحال، علينا أن نعترف، بكل الجرأة الممكنة، أن الجوائز في مختلف ضروب الإبداع، استطاعت خلق حركية واضحة في مجالات نشر المعرفة والثقافة، ونرجو أن يستمر هذا التقليد المنتج، لأننا فقط، وفي غياب ثقافة الجوائز، سنشعر بفداحة هذا الغياب الكبير.





اترك تعليقاً