كيف أدت «فرنسة» تدريس المواد العلمية إلى تراجع مستويات التلاميذ؟

خلال السنوات الأخيرة عاد النقاش في المغرب بقوة إلى مسألة لغة التدريس، لا سيما ما سمي «فرنسة» المواد العلمية (الرياضيات، الفيزياء، العلوم الطبيعية…)، وجل ما أكتبه هنا رأي مبني على معطيات وطنية ودولية: فلستُ أزعم أن التغيير اللغوي هو السبب الوحيد للتراجع التربوي، لكن الأدلة والإحصاءات تشير إلى أن الانتقال السريع إلى الفرنسية —من دون بناء تدريجي ومحكم— كان له أثر سلبي ملموس على تعلم التلاميذ وعلى جودة اكتساب المعارف العلمية.
وإليكم أدلة ذلك بالتقارير الوطنية والدولية:
-أولا. أظهرت نتائج اختبارات دولية أداءً ضعيفاً في الرياضيات والعلوم مقارنة بدول أخرى — في تقييم TIMSS الأخير للصفوف الأساسية، سجَّل المغرب نتائج منخفضة (مثلاً مستوى 383 في إحدى دورات القياس)، ما يضعه قرب أسفل الترتيب الدولي في بعض المراحل.
-ثانيا. في تقييم PISA (القراءة/الرياضيات/العلوم) يظهر أن نسبة كبيرة من التلاميذ المغاربة تقع ضمن فئة «الأداء المنخفض»؛ في تقرير PISA 2022 لوحظت نسب مرتفعة من التلاميذ تحت مستوى الكفاءة (حصة كبيرة من المتعلمين دون المستوى 2). هذا يعكس ضعف إتقان أساسيات القراءة والتفكير الرياضي والعلمي.
-ثالثا. نتائج البكالوريا الوطنية شهدت تقلبات وقراءات متعددة: بالرغم من تسجيل نسب نجاح “منفوخة” في دورات بعينها، إلا أن مؤشرات التراكم (نقاط الضعف في الإعداديات والثانويات، وتوزيع النقط) أثارت مخاوف خبراء المنظومة.
———–
» لماذا قد تؤدي «فرنسة» المواد العلمية إلى تراجع مستوى المتعلمين؟
∆ أولا: وجود فجوة لغوية تفوق الكفاءة: كثير من التلاميذ يدخلون المدرسة الابتدائية بلغة عربية دارجة ثم يتوقع منهم تعلم مصطلحات علمية معقدة بلغة أجنبية (الفرنسية) بسرعة. هذا يضاعف عبء المعالجة المعرفية: التلميذ لا يتعلّم المفهوم فحسب، بل يضطر أولاً لفك رموز اللغة، والنتيجة: فهم سطحي أو حفظ آلي دون إدراك عميق.
∆ثانيا: نقص تكوين الأساتذة باللغة الفرنسية العلمية: تحويل المحتوى لا بد أن يقابله تكوين مستمر للمشتغلين: الأساتذة والمحضرون يحتاجون إلى صقل مهاراتهم في تدريس العلوم بالفرنسية (لا فقط إتقان لغوي بل طرائق شرح ومصطلحات علمية). غياب هذا التأهيل يؤدي إلى دروس تبدو «مترجمة» أو ركيكة وغير فعّالة.
∆ثالثا: المناهج والكتب المدرسية غير متكيّفة: بعض المناهج طُبعت أو عُدلت سريعاً دون مراعاة مستويات التلاميذ أو توفير موارد داعمة (كتاب مبسّط بالعربية، دفاتر تمارين تدريجية، موارد رقمية). هذا يُضعف مهارات التعلم الضرورية للانتقال اللغوي السليم.
∆ رابعا: تأثير على التحصيل على اللغة الفرنسية نفسها: استبدال اللغة العربية التعليمية بالفرنسية في المواد العلمية لم يؤدِ دائماً إلى رفع مستوى الفرنسية؛ بل في بعض الحالات لوحظ تراجع في تحصيل اللغة الفرنسية لأن التدريس يحدث بطريقة غير فعّالة، ما يضاعف العائق اللغوي بدل أن يذلله.
———–
» وبالتالي كمحصلة لذلك ظهرت المشاكل التالية
– ضعف التفكير النقدي والعلمي: عندما يكون التركيز على نقل المصطلح بدلاً من بناء المفهوم، يقلّ الإبداع العلمي والقدرة على حل المشكلات. وهذا يظهر في ضعف النتائج الدولية المحلية.
– زيادة تفاوت الفرص: الأسر التي تتحدث الفرنسية أو التي تستثمر في الدعم الخاص (دروس خصوصية بالفرنسية) يحصل أولادها على ميزة؛ بينما يتخلف تلاميذ المدارس العمومية المكتظة أو في البوادي.
– اضطراب اجتماعي وهوياتي: شعور بتهميش العربية الفصحى وتراجع ثقة التلاميذ في لغتهم الأم، وهو أثر ثقافي طويل الأمد قد ينعكس على انخراطهم المدرسي.
– هدر الموارد: إنفاق طائل على برامج تحويل لغوي سريع دون بنية تحتية (تكوين، كتب، تقييمات) يؤدي إلى نتائج دون المستوى ويشكل هدراً مالياً وبشرياً.
———–
» توصيات عملية واقتراحات
1. التدرج اللغوي: اعتماد استراتيجية انتقالية واضحة: تعليم المفاهيم العلمية أولاً بلغة يفهمها التلميذ (العربية الفصحى المبسطة)، ثم إدخال المصطلحات الفرنسية تدريجياً مع مواد داعمة ثنائية اللغة؛ كما جاء في القانون الإطار وليس استبدال العربية بشكل تام بالفرنسية.
2. مناهج وموارد ثنائية اللغة: إنتاج كتب ومراجع ومواد رقمية تشرح المفاهيم بالعربية ثم تقدم المصطلح الفرنسي مع أمثلة وتدريبات تطبيقية.
3. تقييمات مبكرة ومستمرة: اختبارات تشخيصية في المراحل الابتدائية لتحديد فوارق الفهم ومعالجتها قبل أن تتراكم.
4. عدالة مجالية وحوار مجتمعِي: إشراك الأساتذة، الأُسر، الجامعات، والباحثين في تطوير سياسة لغوية لا تهمل البعد الاجتماعي والهوية.
خلاصة:
إن فشل منظومة التعليم ونجاحها أكبر من مجرد مسألة اختيار لغة: هي مسألة تصميم تربوي كامل، ف«فرنسة» تدريس العلوم لم تكن خطأً محضاً، ولكن تطبيقها المتسرع وغير المصحوب ببناءٍ مؤسسي (تكوين، مناهج، موارد، تقييم) أدى إلى آثار سلبية ملموسة على تحصيل التلاميذ. أمامنا الآن فرصة لإعادة التفكير بطريقة علمية: ليس بإلغاء الفرنسية أو فرضها، بل ببناء مسار تربوي يضمن فهم المفاهيم أولاً، ويستخدم الفرنسية كأداة إضافية —لا كعقبة— في تكوين متعلمٍ قادرٍ على التفكير العلمي.
* عبد الحي الصالح، أستاذ وباحث في علوم التربية




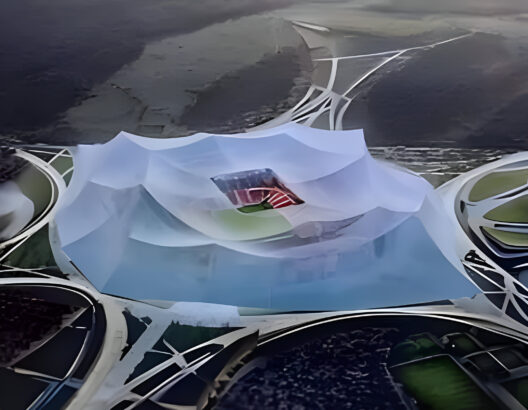
اترك تعليقاً