قراءة نقدية لرواية سحابة وبحيرة
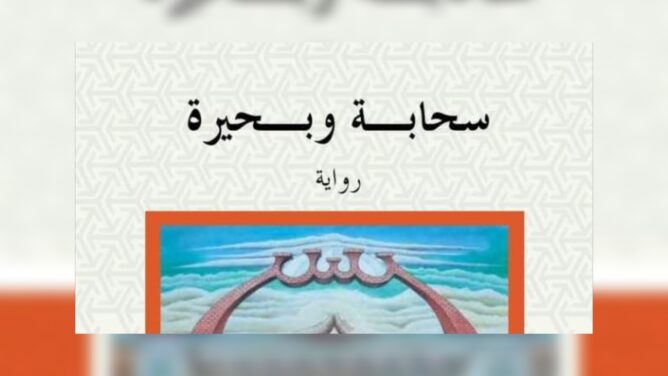
ليس من قبيل المغالاة الجزم بكون رواية سحابة وبحيرة لم تنسلخ قيد أنملة عن خصائص رواية التجريب، التي تنبني على معاينة الأشياء والغوص في أتون المجهول، من خلال الاستعاضة عن التقنيات السردية التي تتغيا نقل الحدث بأدوات تليدة استمرأ مرعاها رادة ودهاقنة الفن الروائي منذ إرهاصاته الأولى وانبجاس ينبوعه على يد حامل لواء الرواية الواقعية أونوريه ذو بلزاك، الذي اختط سننا لاحبا لم يكن بمكنة أي روائي دك حصونه، حتى تفتقت لهاة روزنامة من المبدعين بإضمامة من النصوص السردية، التي تخطت الحدود التي رسمها مقترعو هذا النمط الطريف من الكتابات الحكائية.
منذ المستهل يكسر الكاتب الألمعي أفق انتظار المتلقي من خلال الثريا التي وسم بها نصه، والتي جاءت في شكل مركب عطفي بين لفظين جردهما من أداة التعريف دلالة على التعميم بل والتعمية. فهو يريغ إلى مخاتلة القارئ متوسلا بالمواربة والتورية، إذ السحابة مرادف للديمة والمزنة والرهام والرباب، وهذه كلها ألفاظ تدل على الغيمة التي تجود بواكف الغيث وشؤبوب الرحمة، لكن المتصفح لثنايا الكتاب ما يعتم أن يفاجأ بذكر اللفظ ذاته في ثنايا الإهداء الذي وشح به صاحبنا طرة روايته، ليلفيه محيلا على اسم جدته التي ارتضع منها أفاويق الحكي وأشطره، معتبرا إياها ندا لكبار الروائيين ومن هنا تبدو مكابرة الكاتب بل وجسارته. مما يدفع القارئ إلى المضي قدما في الكرع من مناهل هذا السفر العجيب، الذي يرصد سفرا في خضم الحياة الرجاف ولسان حاله يقول تلك العصا من العصية. فلننظر ما تحفل به هذه الرواية مما يفجأ القارئ المتعطش للخوض في لعبة المخاتلة.
لنجد منذ الصفحة الأولى أن الناظم الذاتي للأحداث والمضطلع بنقل حصة الأسد من المبنى الحكائي للنص ليس سوى امرأة حصيفة تدعى الخالة سحابة، وهي في نفس الوقت فاعل ذاتي في المتن الحكائي بما هي زوج محمد سويلم أحد أبرز شخصيات الرواية. ولربتما كان هو الآخر سميا لجد الكاتب، لتتبدى التشاكلات بين الواقع والمتخيل خصوصا أن واشم الرواية منذ المفتتح يوقع بإضبارته على عقد مع القارئ، من خلاله يؤكد أنه استقى أحداث نصه واستلهمها مما كانت جدته الرؤوم تشنف به آذانه بمعية أتربائه وربائب مراتع صباه من صقيل الحكي، ولعمري ذاك هو نهج سحابة عرس سويلم في المؤلف.
تتتايع أحداث الرواية أخول أخول، وتنبعث جذوتها مع الحديث عن مطر غزير يهمي دون انقطاع مع الإلماع إلى كونه مبعث نشوء بحيرة تربض بحذاء قدم الهضبة المتاخمة لطود بولعلام الأشم، لتكتمل الثنائية التي توشح كلكل الرواية مشيرة إلى المكان الذي تعترك فيه الشخوص، ويشكل معتركا ومضمار للعبة القوى التي يستمي كل منها أن يكون فرس الرهان وسابق الحلبة بل وحائز قصب السبق. فهل نحن بصدد سيرة مكان؟ أم بصدد سيرة ذهنية لفئام من الناس هم ساكنة أمزدوغ لأجيال متلاحقة، بدءا بالسلف الصالح الذي يمتري جمامه في ماض تليد يعبق بعبق التاريخ، ويعد يحيى صلة الوصل بينه وبين جيل الأبناء بوبكر وصالح وفاطنة، وصولا إلى جيل الأحفاد رقية ومباركة وآخرين لم تند من الكاتب نأمة تشي بسهمتهم في الحدث في ذؤابتهم ابن سليلة الاسكافي وسليلة التاجر اليهودي من بعلهما صالح. أم نحن قبالة متغير للسيرة؟ أم يمثل أمام ناظرينا نوع من الرواية يعن للنقاد الاصطلاح عليه بالرواية السيرذاتية؟ لأن الكاتب قد يختفي وراء قناع شخص من الشخوص كما قد يكون رمزا للجيل الذي أعقب جيل حورية، وهي التي تسلمت الدفة من سحابة لترقم تاريخ أمزدوغ درءا لغبار النسيان أن يطاله، حتى يضحي كالصخرة العبوس التي تستعصي على غير الدهر أو بسمة وضاءة على ثغر الزمان. ولعل الحديث عن النسيان فيه الكثير من التلميح والإلماع إلى الحيف الذي طال المنطقة وخيم عليها لعقود، بل ودعوة إلى منحها حقها ومستحقها من العناية شأن باقي كور ومحلات ومداشر الجهة، التي ترفل في قشيب حلل العطايا والهبات، التي تغيب فيها أنصباء أمزدوغ التي ضربت بالسهمين ونالت الحسنين، من خلال صولات محاربيها الذين صدوا أعتى هجمات الاسبان، ولم ينالوا من ذاك معرسا ولم يحظوا بمتودك أو لؤوس، وقد قوبلوا بآذان مخزن أصيبت بوقر وجوارح أصابها الشلل فلا حسيس ولا مسيس.
يتبدى جليا على مستوى الحبكة تملص الكاتب من النمط الخطي وتنسمه عبير التجديد، انطلاقا من الاعتماد على خلخلة الزمن عبر الانثيالات السردية التي تهمي كسيل الحدور، من خلال التوسل بالانقلاب المفاجئ. إذ ما يعتم الكاتب أن يغير دفة السرد دون استئذان القارئ الذي تأسره تفاصيل المكان وخبايا الشخصيات، التي يمسك الكاتب بتلابيبها كأنه محلل نفسي يقل له النديد. وذلك عبر الاسترجاع أوالفلاش باك إذ يعود إلى الماضي السحيق خصوصا بالاتكاء على المخيال الشعبي، الذي ينبني على مداميك الحكايا العجائبية والخرافات التي تلوكها ألسنة الدهماء. كما يعتمد على تقنية المشاهد السينمائية التي تجعل بعض الفصول المتلاحقة منفصلة عن بعضها دون ماتة تذكر، ولعل مرد ذلك إلى مبدأ التوليد الذي استمده الكاتب من قراءاته التي خبرت مغابن الحكاية العجائبية التي يتعدد فيها الساردون والرواة. ويحضر الاستباق من خلال التنبؤ بالمستقبل وذلك ما امتطى فيه صهوة لغة الغيب، التي جاءت أحيانا في شكل قراءة للطالع على يد العرافة السعدية ومن مضى على شاكلتها، ثم رؤيا صالحة تتفتق عنها قرائح بعض الشخصيات التي وسمت بميسم التقوى وفي طليعتها علي الابن البكر لخديجة زوج يحيى.
يتملص الكاتب بألمعيته الفذة من أسر التاريخ وأحابيله ليأبق من مبدأ جعل الرواية خادمة له، فتأتي الشذرات التاريخية الموثقة في النص المسرود كأنها جزء من المتداول اليومي للشخوص بما هي مما اجترحه خيال الكاتب، وذلك ما يدركه القارئ الذي تربت نبعته في محلة أمزدوغ، لأنه الوحيد الذي يدرك الفاصل بين التاريخي والمتخيل في المؤلف، ولعل ما أسعفه في ذلك هو إحكامه لأدواته الإبداعية وتمكنه من ناصية اللغة حتى ليتبدى أحيانا بأسلوبه السامق الذي ينضح طلاوة وألقا، ويكأنه فطحل من فطاحلة البيان. وليت شعري بالغيب حاصل لقد نهل أسلوبه الصقيل ذا الرواء والرقراق من خلال التناص بداءة مع النص القرآني الذي يبدو أن محفوظه منه ليس بالهين، فلا تكاد تخلو الصفحة من العبارة أو الثنتين من قبس القرآن الكريم، على أنه يهيم أحيانا في ملكوت الشطحات الصوفية بأسلوب رائق يستعصي على غير الآخذ بضبع المقامات والحضرات السنية، مما يحتم على الطامح في فك رموزه القراءة المتعددة للسطر الواحد عودا على بدء بغية بلوغ الأرب. وتتعدد الأصوات بتعدد المحكيات فتتباين الرؤى السردية لتجمع بين رؤية من الخلف هي التي تحظى بالسهم المعلى والرقيب حيث يبدو السارد غير مشارك في الحدث لكنه عليم بخبايا الشخصيات، وبين الرؤية المصاحبة حين يهم أحد الشخوص بالإفصاح عما لا قاه من أحداث وذلك ما يمنح النص دينامية وانسيابية تستحث القارئ على المضي في التهام الصفحات.
وفي المتم يجر بنا الحديث إلى البنية السردية للنص فهي حلزونية دائرية مغلقة لأن البداية هي النهاية: وقف يحيى ليحفر قبر ابنه…. وهنا تجثم بجؤجئها ثنائية ضدية هي التي تخيم على النص: ثنائية حياة موت ومن ثم تتبدى ثنائية الخفاء والتجلي ويُلمع الكاتب حين يقصر عن أن يُسمع بكون أمزدوغ تعيش في دوامة ويضحي وكد ساكنتها وديدنها الذميل والتهادي في حلقة مفرغة لا فكاك منها.





اترك تعليقاً