النموذج الحضاري الغربي : بين فلسفة الهيمنة ورهانات التعددية

مقدمة :
يشهد العالم المعاصر تحولات عميقة في موازين القوة والنفوذ، في ظل تصاعد الأسئلة حول مستقبل النموذج الغربي الذي ساد – لما يزيد عن قرن – كمرجعية شبه كونية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة. غير أن الأزمة لم تعد مقتصرة على مستوى التطبيق والممارسة، بل امتدت إلى البنية الفلسفية لهذا النموذج نفسه، حيث أضحى محلّ نقد متزايد بتهمة تكريس الهيمنة، واستغلال الأزمات لإثارة الصراعات بين الشعوب، بل وتبرير العنف تحت غطاء “التحضّر”، خدمةً لمنطق السيطرة.
فهل نحن بصدد أفول حضاري للنموذج الغربي؟ وهل يمكن أن ينبثق البديل من الشرق، أم من أعماق أمة أخرى لا تزال تخوض رحلة بحث عن ذاتها وسط مشهد دولي مضطرب ومتفكك؟
النموذج الغربي الراهن… هيمنة ممهورة بعقيدة الأزمات
لا يمكن فهم النسق الغربي الحالي دون العودة إلى جذوره الفكرية، لا سيما في علاقته بالإصلاح الديني البروتستانتي، وبالقراءة الصهيونية الحديثة للعالم ولموازين القوى بوجه خاص. لقد تأسس هذا النموذج على البراديغم النفعي “paradigme utilitariste” يرى في الإنسان مجرد أداة للإنتاج والاستهلاك، وفي التاريخ ساحة صراع لا توازن، لتتسارع العديد من المدارس من مختلف المشارب المعرفية (علم الاجتماع، علم السياسة، علم الاقتصاد إلخ…) لتبرير وتطوير مفاهيم ومقاربات على ذات النهج.
فمن البروتستانتية الأنغلوساكسونية التي مجّدت العمل كعلامة على الخلاص الدنيوي، إلى الصهيونية السياسية التي شرعنت القوة كحق ديني وقومي، نشأ ما يمكن تسميته بـ”العقيدة الغربية للهيمنة”، التي تُجيز اللجوء إلى آليات استراتيجية، يمكن أن نستحضر ثلاثة منها :
أولا – الفوضى السياسية المنظمة : وهي حالة من الاضطراب السياسي التي يتم إنتاجها أو تغذيتها عمدًا، عبر سياسات أو قرارات أو تدخلات خارجية أو داخلية، بهدف إعادة ترتيب المشهد السياسي أو الاجتماعي أو الجغرافي، بما يخدم مصالح نخبة أو قوة معينة. وهذا المنهج نجده يتجلى في معادلة العلاقات الدولية، من خلال التدخل في دول معينة (كما حدث في العراق، ليبيا، اليمن، سوريا…) ، لا بهدف تحقيق الاستقرار، بل لإسقاط أنظمة سياسية ثم ترك فراغ سياسي يعج بالفوضى، مما يخلق مبررات للتقسيم، للتدخل، ولإعادة بناء نظام جديد على المقاس. كما يتجلى عبر سياقات داخلية في بعض الدول، من خلال تغذية النزاعات الهامشية أو الطائفية أو العرقية أو حتى النقابية، بغرض تشتيت الرأي العام وإضعاف قوى التغيير أو المعارضة، والسماح بتدهور خدمات الدولة أو مؤسساتها وانتشار الفساد العميق كوسيلة لإضعاف الثقة فيها، تمهيدًا لخوصصتها أو استبدالها بنظام أكثر خضوعًا.
يُعرف أحيانًا هذا المصطلح ب “الفوضى الخلاقة – Creative Chaos”، وهو تعبير استخدمه المحافظون الجدد في السياسة الأميركية (كوندوليزا رايس نموذجا). هذه الفوضى ليست عفوية أو ناتجة عن انهيار مفاجئ، بل نتيجة تخطيط مسبق أو تواطؤ صامت، ولها مستفيدون مباشرون من إعادة رسم موازين القوى أو تحويل الانتباه عن قضايا جوهرية.
على سبيل المثال، حينما تُترك مؤسسات التعليم أو الصحة تنهار تدريجيًا دون إصلاح حقيقي وجذري، مع ترويج إعلامي لفكرة فشل القطاع العمومي، فقد يكون الهدف ليس الفشل ذاته، بل خلق مبرر مقنع لتمرير حلول خوصصة، من خلال تفويت مؤسسات تعليمية وصحية عمومية إلى القطاع الخاص، بما يخدم فئة محدودة من المجتمع، ذات القدرة الشرائية الكافية، فيما تتجرع الشرائح العظمى من المجتمع مرارة الإقصاء والحرمان من خدمات أساسية، غير قادرين على تكلفتها، وبالتالي تعريضهم للتجهيل والموت البطيئ، فهذا يمكن اعتباره فشلا منظما، و هو شكل من أشكال الفوضى السياسية المنظمة.
ثانيا : صناعة العدو كأداة لاستمرار السيطرة : وهو أحد أخطر ميكانيزمات الهيمنة في الفكر السياسي الحديث، والمُستخدم بكثافة في النموذج الغربي النيوليبرالي والإمبريالي على وجه الخصوص، وأيضًا في أنظمة سلطوية في بلدان الجنوب. ويعتمد على صناعة عدو، كأداة مركزية لإعادة إنتاج السيطرة، فصناعة العدو لا تعني فقط اعتبار جهة ما خصمًا، بل تعني إنتاج العداوة ذاتها عن قصد، عبر التضخيم الإعلامي، الشيطنة الرمزية، والربط الذهني بين العدو وأزمات المجتمع (أمن، هوية، قيم الحداثة…)، وأحيانًا صناعة أحداث عنف وهمية أو محركة تنسب للعدو المزعوم. إنها عملية نفسية – إعلامية – سياسية تهدف إلى توحيد الجبهة الداخلية، وتبرير القمع والتوسع أو الاستثناء.
وصناعة العدو لها جذور فكرية قديمة (جمهورية أفلاطون نموذجا، حيث أن المدينة الفاضلة تحتاج إلى ضبط المجتمع عبر سرديات تعيد تشكيل الصديق والعدو، وتُوظف “الأسطورة النبيلة” كأساس للحفاظ على النظام الاجتماعي)، وحديثا، يمكن الاستعانة بأفكار كارل شميت في كتابه “la notion du politique” لفهم كيف أن أساس السياسة هو التمييز بين الصديق والعدو، وأن الدولة تحتاج دائمًا إلى عدو لتبرير سلطتها، وكذلك بأعمال ميشيل فوكو، التي شرح من خلالها كيف أن السلطة تنتج “التهديد” كمكون ضروري لممارسة المراقبة والتحكم في الأجساد والمجتمعات، وبأعمال الاستشرافي الأمريكي نعوم تسومسكي، التي فضحت وسائل الإعلام الأميركية، التي تصنع أعداء “حسب الطلب” لتوجيه الرأي العام الداخلي بما يدعم السياسات التوسعية.
ومن أهم الآليات التي تعتمدها الدول الاستبدادية في صناعة العدو : إعادة ترتيب الأولويات السياسية، بحيث حين يكون النظام عاجزًا عن تلبية المطالب الاجتماعية، يصرف الانتباه نحو عدو خارجي أو داخلي. من أجل توحيد الجماعة خلف السلطة، من خلال إشاعة كون المجتمع في خطر، إذن لا مجال للنقد أو المعارضة لتبرير سياسة الاستثناء. ثم هناك آلية أخرى، من خلال تبرير السياسات الأمنية والتدخلية، مثل قوانين الطوارئ، التوسع العسكري، التجسس، تكميم الإعلام، إلخ…، وأخيرا، ما يمكن أن نسميه ب تسليع الخوف، من خلال تحويل الخوف إلى ربح سياسي واقتصادي (عبر شركات الأمن، التسليح، الدعاية…).
لقد تم اختلاق أعداء على نطاق واسع خلال العقود الأخيرة، مثل الإرهاب الإسلامي، الذي بني عليه الخطاب العالمي ما بعد أحداث 11 سبتمبر لتبرير خوض حروب، فرض قوانين استثنائية، إحداث مراكز تعذيب (غوانتانامو)، وتشويه شعوب بأكملها. كما ثم تضخيم خطر روسيا والصين في الإعلام الغربي، كمصدر دائم للتهديد لتبرير ميزانيات عسكرية خيالية، وتقييد بعض الحريات بدعوى “الأمن القومي”. كما تستخدم الأنظمة الاستبدادية مصلطات مثل “الخيانة”، “العمالة”، “الطابور الخامس”، كمصطلحات لصناعة العدو الداخلي، وتبرير القمع السياسي أو الإعلامي.
على هذا النحو، صناعة العدو لم تعد خطابا للتسويق فحسب، بل أضحت استراتيجية سلطة، تقوم على تحويل الخوف إلى طاعة، تنتج مجتمعات دائمة الرهاب والتأهب، لكنها بلا وعي سياسي مستقل، تعيش على وهم الخطر الخارجي بينما العدو الحقيقي هو الاستغلال الداخلي، وغياب العدالة والكرامة.
ثالثا : الحرب الاقتصادية والمالية : ثمة أدوات متعددة في الحروب الاقتصادية والمالية، مثل العقوبات الاقتصادية، والتي تتجلى في تجميد الأصول التي تملكها الدول الخصوم في الخارج (إيران، فنزويلا، كوريا الشمالية، روسيا…)، منع التصدير والاستيراد، حظر التكنولوجيا، كما تتجلى في التحكم في النظام المالي العالمي مثل نظام سويفت للتحويلات المالية، مما يعطل قدرة الدول على التبادل التجاري، وهناك آلية خطيرة أخرى، تتعلق بهندسة الأزمات الاقتصادية المفتعلة، مثل التلاعب بأسعار النفط، الغذاء، أو المواد الأساسية، مع نشر الشائعات المالية لزعزعة الأسواق (كما يحدث في حرب العملات أو الهجمات على البنوك)، ودعم المضاربات في السوق السوداء كما وقع في لبنان أو فنزويلا.
علاوة على ذلك، يقدم كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي قروضا للدول المتخلفة المستهدفة، مشروطة ب”إصلاح هيكلي” تقضي على السيادة الاقتصادية للدول (خصخصة، تقشف، تحرير السوق…)، بحيث أن كثيرا من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية خضعت لحلقات متكررة من “الإنقاذ القاتل”. فالدول المستهدفة بالقروض تغرق في الديون لتصبح رهينة للقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يمكن أن نسميه “الاستعمار المالي”.
وتكمن الأهداف الكبرى من الحرب الاقتصادية في كسر الإرادة السياسية للدول دون تدخل عسكري مكلف، باعتبارها قوة ناعمة، غايتها إضعاف الفاعلين الصاعدين اقتصاديا وجيوسياسيا (مثل ما وقع لروسيا، إيران…)، وإعادة تشكيل الأسواق لصالح الشركات الكبرى التابعة للدول المهيمنة، ونهب الثروات وتفكيك القطاع العام بإسم تحرير الاقتصاد. وأمثلة ذلك عديدة، (مثل ما وقع للعراق ما بين سنة 1990 و 2003)، قبل غزوه عسكريًا، فقد تم إنهاكه اقتصاديًا بعقوبات دمرت البنية التحتية الصحية والغذائية، وأدت إلى وفاة مئات الآلاف من الأطفال. ولبنان الذي تعرض لانهيار مالي ممنهج، بفعل شبكة معقدة من الهندسة المالية، مع غياب للشفافية، وضغط خارجي غير مرئي. ثم فنزويلا، التي خاضت حربا نفطية، أعقبها حصار ثم تجميد أموال في البنوك الدولية وتهريب العملة. وأخيرا روسيا، التي تعرضت، بعد غزو أوكرانيا، لإخراجها من نظام سويفت، تجميد أموال البنك المركزي، ضرب عملتها، ومحاصرة الشركات الروسية.
لقد ساهم هذا التوجه في تكريس نمط رأسمالي متوحش، يستبطن لغزا مفاده أن الشر – إن أُتقن التحكم فيه – يصبح أداة للتفوق وإعادة إنتاج الامتياز الحضاري. هنا لا غرابة أن نجد الفكر الاستراتيجي الغربي، كما تعبر عنه مؤسسات مثل “مجلس العلاقات الخارجية” أو “البنتاغون”، يجاهر بأن الأزمات هي محرك النمو، وأن الفوضى الخلاقة ضرورة للتجدد، تماما مثل نظرية التخريب الخلاق (destruction créatrice) في اقتصاد الابتكار.
فلسفة التدمير الخلاق… حين تصبح الحرب طريقا للازدهار
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع الصعود المتسارع لما يعرف بـالمجمع الصناعي العسكري الأميركي، بدأ يتكرس تحول جذري في بنية الاقتصاد الغربي، حيث لم يعد يستمد نموه فقط من آليات السوق التقليدية، بل أصبح مرتهنا لمنطق العنف الموجه كأداة استراتيجية لإعادة إنتاج الهيمنة.
فمن الحرب الباردة التي شكلت بنية صراع دائم ومفتوح، إلى غزو العراق وأفغانستان بذريعة محاربة الإرهاب، مرورًا بدعم الانقلابات في دول الجنوب، ووصولا إلى تأجيج النزاعات الطائفية والإثنية في مناطق التماس الجيوسياسي، يتبين أن هذه الأحداث لم تكن مجرد ردود أفعال أو انزلاقات عسكرية عرضية، بل كانت في الغالب جزءا من استراتيجية مدروسة تعتبر الحرب شكلا من أشكال “الاستثمار” السياسي والاقتصادي.
في هذا السياق، تبرز أطروحة الكاتبة نعومي كلاين “Naomi Klein” في كتابها “عقيدة الصدمة : صعود رأسمالية الكوارث”، حيث توضح كيف تستغل الأزمات الكبرى – سواء كانت حروبا أو كوارث طبيعية أو أزمات مالية – لخلق فراغات تتيح للنخب الاقتصادية فرض سياسات اقتصادية متوحشة مثل الخصخصة، وتفكيك القطاع العام، وإعادة هندسة الأسواق وفق مصالحها.
وهكذا، لا تعود الحرب استثناء أو انحرافا، بل تصبح وظيفة بنيوية داخل النظام العالمي النيوليبرالي، حيث يعاد تشكيل خرائط النفوذ وتوزيع الثروات عبر الفوضى الموجّهة.
في هذا الإطار، يستحضر “الشر” لا كعنصر مرفوض، بل كأداة سياسية ضرورية لإدامة ما يسمى بالتوازن العالمي. ويعاد تأطيره ضمن خطاب حداثي مزيف يبرر التدخلات الاستعمارية الجديدة باسم “نشر الديمقراطية” أو “حقوق الإنسان”، بينما يمارس التدمير الممنهج للشعوب والبنى الوطنية خلف واجهات أخلاقية خادعة.
إننا بذلك أمام منطق معكوس للحداثة، يضفي المشروعية على العنف، ويحول الكارثة إلى فرصة، والفوضى إلى أداة لضبط النظام العالمي وفق مصالح نخب لا ترى في الحرب إلا امتدادا للسياسة بوسائل أخرى، أكثر ربحا.
القوى الصاعدة والبدائل المحتملة: بين تفكك النموذج الغربي وتعثر النماذج البديلة
مع اهتزاز أسس النظام الدولي الذي تقوده القوى الغربية، تتجه الأنظار إلى ما يسمى بـ”القوى الصاعدة”، باعتبارها مرشحة لإحداث تحوّل استراتيجي في بنية العلاقات الدولية، وفتح أفق لبدائل جديدة. غير أن هذه القوى، رغم صعودها الاقتصادي أو الجيوسياسي، لا تزال عاجزة – إلى حد الآن – عن إنتاج نموذج حضاري شامل يزاوج بين الفعالية والمنظومة القيمية. ثمة ثلاث نماذج محتملة :
النموذج الصيني، برغماتية بدون سردية : تعد الصين واحدة من أبرز الظواهر الجيوسياسية في التاريخ المعاصر، إذ تمكنت، في ظرف زمني قصير نسبيا، من التحول من دولة نامية تعاني من عزلة اقتصادية إلى قوة مركزية في النظام الدولي، تنافس على القيادة في مجالات متعددة. وقد بني هذا الصعود المذهل على أسس واضحة، يأتي في مقدمتها التمركز الصارم للقرار الاستراتيجي في يد الدولة المركزية، مما منحها مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات الكبرى دون الخضوع لدوامات التجاذب السياسي.
كما راهنت الصين على التخطيط طويل الأمد، مع اعتماد نهج “التراكم الهادئ”، بعيدا عن الضوضاء الإعلامية، الأمر الذي مكنها من ترسيخ قاعدة صناعية وتكنولوجية صلبة، وتوسيع نفوذها التجاري والمالي عالميا. ويضاف إلى ذلك رفضها تصدير أي نموذج أيديولوجي أو التدخل المباشر في شؤون الدول الأخرى، وهو ما منحها نوعًا من الحياد السياسي المقبول في العديد من مناطق العالم.
ورغم هذه النجاحات الملفتة، فإن النموذج الصيني لا يزال يتحرك ضمن أفق براغماتي صرف، يركز على الجدوى والمصالح دون أن يصوغ رؤية حضارية إنسانية متكاملة. فرغم التأثير الذي تمارسه الصين على الاقتصاد العالمي، إلا أن غياب خطاب أخلاقي عالمي أو مشروع حضاري قابل للتبني من طرف شعوب أخرى، يجعل من تأثيرها قوة تنافس، لكنها لا تقنع ولا تلهم، فهي تبني مصالح، لكنها لا تبني انتماءات.
وبذلك تبقى الصين قوة اقتصادية صاعدة، لكنها لم تتحول بعد إلى مرجعية حضارية قادرة على تشكيل وجدان عالمي أو تقديم بديل معنوي للنموذج الغربي المتصدع.
روسيا، الدفاع عن الدولة الحضارية : منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، شرعت روسيا في إعادة ترميم مكانتها كقوة عالمية، بعد عقد من التراجع والاضطراب أعقب انهيار الاتحاد السوفياتي. وقد تجلى هذا المسار من خلال استعادة خطاب السيادة والهوية الحضارية، في مواجهة ما اعتبر تغولا غربيا على المجال الجيوسياسي الروسي التقليدي. فالمشروع الروسي الحالي لا يقدّم نفسه كقوة عسكرية أو اقتصادية فقط، بل كـدولة حضارية تسعى إلى حماية تعددية العالم وتوازناته.
في هذا الإطار، تبنت موسكو رؤية أوراسية تقوم على رفض الأحادية القطبية، والتأكيد على التعدد الحضاري والثقافي كمبدأ ناظم للعلاقات الدولية. وتحاول من خلال ذلك بناء مجال نفوذ يدمج شعوبًا وثقافاتٍ متنوعة، مستندة إلى روابط التاريخ، والجغرافيا، والمصلحة المشتركة.
إلا أن هذا المشروع، رغم صلابته السياسية وجرأته الجيواستراتيجية، لا يزال محاصرًا على عدة مستويات. فهو لم ينجح بعد في تجاوز حدود المقاومة السياسية والعسكرية إلى بناء منظومة متكاملة من أدوات الهيمنة الناعمة، كالقوة الثقافية والمعرفية والتكنولوجية. فالإعلام الروسي، رغم توسعه، لم يتحول بعد إلى قوة روائية منافسة للسرديات الغربية، كما أن الجامعات الروسية، والمؤسسات الفكرية، ومراكز الابتكار، لا تزال بعيدة عن منافسة نظيراتها الغربية في التأثير العالمي.
وبهذا المعنى، تبقى روسيا قوة تعارض وتقاوم، لكنها لم ترتق بعد إلى مرتبة المرجعية الحضارية البديلة. إنها تملك الذاكرة والتاريخ والقوة، لكنها تفتقر إلى الحافز الرمزي الجامع والمشروع القيمي العابر للحدود، القادر على إلهام الشعوب الباحثة عن توازن جديد في عالم يتخبط في فوضى ما بعد الهيمنة الغربية.
الأمة الإسلامية، البديل المغيَّب : رغم ما تعانيه اليوم من هشاشة سياسية، وتشرذم جغرافي، وتبعية اقتصادية مزمنة، لا تزال الأمة الإسلامية، في جوهرها الحضاري، تحتفظ بإمكانات فكرية وروحية تؤهلها لتقديم بديل حضاري عالمي، لا يُقاس فقط بالقوة أو التكنولوجيا، بل بمنظومة قيمية تؤسس لمعنى مختلف للعمران والعلاقات الدولية والاقتصاد. هنا، علينا أن نستحضر نقطة غاية في الأهمية، وهي أن تخلف الواجهة المؤسساتية الرسمية في الأمة الإسلامية يقابله “نظريا بطبيعة الحال” مؤسسات غير رسمية غنية قيميا وإنسانيا على نحو منقطع النظير، لكنها لم تنل حظها من البروز والإعتراف، وبقيت كامنة تنتظر ساعة الصفر. فالحضارة الإسلامية، بخلاف كثير من النماذج المعاصرة، لا تُبنى على الهيمنة أو السيطرة، بل على أسس راسخة تجمع بين العدل باعتباره ناظمًا أساسياً للعلاقات بين الأفراد والمجتمعات والدول، والتكافل الذي يضع الاقتصاد في خدمة الإنسان، لا العكس، والمقاصد الشرعية كإطار موجّه للفعل السياسي والاجتماعي، ثم فلسفة الاستخلاف التي تمنح الإنسان دورًا أخلاقيًا ومسؤولًا في إدارة الثروة والعمران، دون انفصال عن البعد الروحي أو الكوني.
غير أن هذه الإمكانات، رغم عمقها التاريخي ووجاهتها النظرية، لا تزال مُغيَّبة أو غير مُفعّلة على مستوى الواقع، بسبب غياب مشروع معرفي ومؤسسي متكامل يُحوّل التراث إلى رؤية، والقيم إلى سياسات، ويُترجم التصورات الإسلامية إلى أدوات اشتغال معاصرة.
ولن يكون لهذا النموذج أي قدرة تنافسية حقيقية ما دام محصورًا في خطابات الهوية والانفعال العاطفي، أو مُجزأ بين مشاريع قطرية متضاربة ومصالح آنية قصيرة المدى. فالتحول من أمة مستهدفة ومفعول بها إلى أمة فاعلة ومؤثرة يقتضي تجاوز الانكفاء إلى التأسيس لبراديغم حضاري بديل، يقدم منطق المعنى والمصير المشترك في مواجهة منطق السوق والتفوق العدمي الذي تنتجه الحداثة الغربية.
إن العالم اليوم، المنهك من الحروب واللاعدالة، لا يبحث فقط عن قوى عظمى جديدة، بل عن معايير أخلاقية جديدة للعيش المشترك، وهنا تبرز فرصة الأمة الإسلامية – إن هي نهضت – لتقديم مساهمتها الكبرى في صياغة توازن حضاري جديد، أكثر عدلاً وإنسانية.
من نهاية الهيمنة إلى التعددية القيمية
نحن اليوم أمام مرحلة مفصلية في التاريخ العالمي، يمكن وصفها بمرحلة “اللايقين الاستراتيجي”، حيث لم يعد العالم يدور بثقة حول مركز واحد، ولا حول سردية كونية موحدة. فقد بدأ الخطاب الغربي حول الحداثة والتقدم وحقوق الإنسان يفقد بريقه وقدرته على الإقناع، بعد أن تكشفت تناقضاته على أكثر من صعيد، خاصة في الأزمات الدولية الكبرى مثل مأـساة الشعب الفلسطيني، أوكرانيا، السودان، وسابقا كوسوفا، بوروندي….
في هذه السياقات وغيرها، لم تعد ازدواجية المعايير مجرد حالة عابرة، بل أصبحت سلوكا مؤسسيا يعري التحيز البنيوي للنظام الدولي القائم. فالمؤسسات التي شيدت على أنقاض الحرب العالمية الثانية، مثل الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والبنك الدولي، فقدت شرعيتها الأخلاقية لدى جزء واسع من البشرية، بعدما تحولت من آليات للتعاون العالمي إلى أدوات للضبط والتحكم تخدم مصالح القوى الكبرى وتعيد إنتاج اختلال ميزان القوة باسم”الشرعية الدولية”.
لكن في مقابل تراجع الهيمنة الأحادية، لا يبدو أن البديل سيفرض نفسه بقوة السلاح أو منطق الغلبة، بل من خلال تحولات تراكمية عميقة، تقودها الشعوب والنخب الطلائعية في الجنوب العالمي.
إن استعادة السيادة الوطنية، سواء في القرار السياسي أو في التحكم بالموارد والخيارات التنموية، تعد الخطوة الأولى في هذا المسار، يليها صعود نخب فكرية واقتصادية مستقلة، تتجاوز التبعية المعرفية والسياسية، وتؤسس لخطابات نابعة من واقعها وتحدياتها، أما المحطة الأهم، فتتمثل في بناء كتل إقليمية متماسكة، متحررة من الهيمنة الجيوسياسية، وقادرة على التفاوض من موقع الندية والتكامل.
بهذا المعنى، فإن التحول الجاري لا يقود فقط إلى عالم متعدد الأقطاب سياسياً، بل إلى عالم متعدد القيم، متحرر من المركزية الغربية في تعريف التقدم والشرعية والمصالح.
إنه تحوّل طويل ومعقد، لكنه يحمل بذور نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنا، تصاغ فيه معايير القوة والتعاون على أسس من التنوع الثقافي والكرامة المشتركة، لا على إرث الهيمنة والتفوق التاريخي.
خاتمة : من صراع النفوذ إلى معركة المعنى : لحظة الانعطاف الحضاري
ما يشهده العالم اليوم لا يمكن اختزاله في مجرد صراع نفوذ بين قوى عظمى تتنازع على الموارد والمواقع، بل هو في جوهره صراع فلسفات وجودية تتباين في رؤيتها للإنسان، وللتاريخ، ولمفهوم الحضارة البشرية ذاته.
لقد بدأت الهيمنة الغربية تفقد قوتها لا بفعل تراجع عسكري أو اقتصادي فحسب، بل – وهذا هو الأعمق – لأنها لم تعد قادرة على إقناع الآخرين بشرعية سرديتها. فقد استهلكت تلك السردية كل أدواتها الخطابية، وأظهرت تناقضاتها الأخلاقية، لتتحول إلى منظومة تسعى للحفاظ على تفوقها بأي ثمن، حتى وإن كلف ذلك نسف القيم التي ادعت الدفاع عنها، وهو ما تفعله على أرض الواقع.
لكن انهيار المهيمن لا يعني تلقائيا بروز بديل مكتمل، فالقوى الصاعدة، وعلى رأسها الصين وروسيا، قد تعيد التوازن الجيوسياسي، لكنها لم تقدم بعد مشروعا حضاريا جامعا قادرا على إعادة تعريف العالم على أسس أكثر إنسانية.
إن ملامح البديل الحقيقي لن تنبع فقط من مراكز النفوذ التقليدية أو الطموحة، بل من ظهور رؤية حضارية جديدة، تؤمن بأن الشر ليس ضرورة تاريخية لتحقيق التفوق، وأنه يمكن بناء نظام عالمي قائم على السلام لا الصراع، وعلى التكافل لا التوحش، وعلى العدل لا الظلم وعلى انفتاح الفرص لا احتكارها.
وفي هذا المنعطف، تتبلور أكبر معركة في التاريخ المعاصر، ليست معركة الحدود ولا الأسواق، بل معركة المعنى، من يملك أن يعيد للإنسان كرامته، ويحرر الفكر من العدمية، ويقترح على العالم أفقا تتوازن فيه القوة بالقيم، والمصلحة بالمصير المشترك.
إن هذه المهمة التاريخية لا تقع على عاتق الدول فقط، بل على المثقفين، والباحثين، ونخب الأمة. أولئك الذين عليهم اليوم أن يتجاوزوا منطق التبعية والردة، ليعيدوا بناء مقاربة فكرية تحررية جامعة، تؤسس لنموذج عالمي جديد، لا يقصي أحدا، ولا يبنى على الغلبة، بل على الشراكة والاعتراف والكرامة.




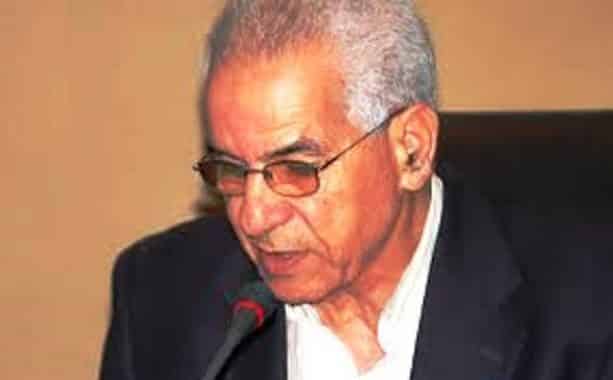
اترك تعليقاً