مراسلة الهيب هوب الوزارية.. تجديد تربوي أم رقص على أنقاض المدرسة المغربية

في خطوة وُصفت بأنها «تنويع للعرض التربوي»، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة رسمية إلى الأكاديميات الجهوية، تعلن فيها عن دورة تكوينية خاصة بأساتذة التربية البدنية، موضوعها: “الهيب هوب والبريكينغ”، وذلك بشراكة مع هيئات رياضية متخصصة، وتأطير خبير دولي. وذكرت المراسلة أن الهدف هو إعداد مكونين جهويين قادرين على تأطير زملائهم في هذا النوع من التعبير الحركي.
قد لا يُثير هذا الخبر الانتباه في بلد اختارت فيه المدرسة أن تواكب العصر، لولا أن السياق العام والتفاصيل الجزئية تقودنا إلى طرح أسئلة جوهرية، تتجاوز حدود المفارقة إلى صلب الرؤية التربوية التي يُعاد تشكيلها حاليًا في المغرب. ظاهريًا، يبدو الأمر بسيطًا: دورة تكوينية في نوع من التعبير الجسدي المعاصر. لكن، عند التوقف قليلًا أمام هذه الخطوة، يطفو على السطح سؤال تربوي مركزي: أي أفق تعليمي وتكويني تسعى إليه المدرسة المغربية؟ وهل مثل هذه المبادرات تعكس فعلًا رؤية استراتيجية عميقة، أم مجرد استجابة استعراضية لموجات ثقافية عابرة، لا تستند إلى دراسة تربوية أو تشخيص بيداغوجي دقيق؟
من الثقافة إلى الاستيراد الثقافي
من المعروف أن “الهيب هوب” ليس مجرد رقصة، بل هو تعبير احتجاجي نشأ في بيئة سوسيوثقافية مغايرة تمامًا، أي في أحياء نيويورك الهامشية، كرد فعل على العنصرية والتهميش. وإذا كان لهذا الشكل الفني ما يبرره في تلك السياقات، فإن نقله إلى المدرسة المغربية، خصوصًا في الوسط القروي، دون تكييف تربوي أو فهم عميق لمتطلباته الرمزية، ليس إلا نوعًا من الاستيراد الأعمى لفلكلور حضري دخيل لا صلة له بالواقع النفسي والثقافي والاجتماعي للتلميذ المغربي. والسؤال الأعمق هنا: هل يستطيع التلميذ المغربي التعبير بحرية أصلاً؟ أيعقل أن نلقنه شكلاً من أشكال “الاحتجاج الجسدي” بينما يُمنع من طرح سؤال فلسفي، أو التعبير عن رأي أدبي خارج المنهج، أو انتقاد مقرر دراسي في ورقة الامتحان؟ يبدو أننا أمام مفارقة سوريالية: حيث سنُدرّب الطفل على رقصة احتجاج، دون أن نُفسح له المجال ليحتج فعلًا. أليس التعبير في ذاته، بشتى أشكاله، مُصادَرا في بيئة يغلب عليها الطابع التلقيني والتأديبي؟
الأولويات المقلوبة
من المؤسف أن تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه التعليم المغربي من أزمات بنيوية واضحة، تتمثل في ضعف مهارات التلاميذ في اللغات الأساسية، وهشاشة الكفايات التواصلية، وغياب الحس الجمالي، وندرة الأنشطة المسرحية والفنية، وتراجع الوعي النقدي. فكيف يُبرر تخصيص موارد وجهود لتكوين أساتذة في “البريكينغ”، بينما لا يجد مدرسو اللغة، على سبيل المثال، ما يكفي من الوسائل لتأطير التلميذ على مجرد التعبير الشفهي السليم؟
إذا كان الهدف هو تفريغ طاقات التلميذ، أفلم يكن من الأجدى دعم الرياضات ذات القبول المجتمعي الواسع، ككرة القدم، التي تُمارَس يوميًا في الأزقة والدواوير، والتي تمتلك بنيات رمزية وواقعية لبناء الذات والمستقبل؟ وهل استطاعت الرياضة المدرسية أن تنتج أبطالا في الرياضات المقررة؟ وإذا كنا نروم حقًا “تنويع العرض”، فهل اختبرنا حدود ما يتيحه المسرح والسينما التربوية والفنون التشكيلية؟ أوليست هذه التعبيرات أولى بالدعم والتكوين، بالنظر إلى قدرتها على صقل الحس الجمالي والتفكير النقدي معًا؟
إن هذه المبادرة “الهبهوبية” تبدو كعملية تمويه أو كعملية قلب للأولويات التربوية، لا تخلو من العبث. ففي مدرسة تقاوم الهدر المدرسي، وتفتقر إلى أبسط الوسائل البيداغوجية، وتئن تحت وطأة الاكتظاظ، يبدو الحديث عن تكوين في “الهيب هوب” أقرب إلى نكتة منه إلى مشروع إصلاحي.
ومن جهة أخرى، يظل السؤال الكبير معلقًا: أين موقع دعم التلميذ في المواد الأساسية — خصوصًا اللغات — من هذه السياسات “الاستعراضية”؟ ففي زمن انهيار مستويات التعبير اللغوي والكتابي، فإنه من الغريب أن تُعطى الأولوية لتكوين مكونين في “البريكينغ”، فيما الفجوة في التعلم اللغوي والقرائي تتسع يومًا بعد آخر.
سياسات وزير من خارج حقل التربية والتكوين.
ثمة ما هو رمزي في هذه الحكاية كلها. الوزير المشرف على هذا القرار لم يأتِ من حقل التربية، ولم يسبق أن اشتغل في مجاله، من قبل وعلى شتى مستويات تدبير حقل التربية والتكوين، بل إن الرجل آت من عالم التجارة، وبالضبط من مجال الحلويات والقطاع الدوائي، بالإضافة إلى استثماراته الواسعة في الصناعات الغذائية، والأشغال العمومية. وهذا – في حد ذاته – ليس تهمة، لكنه يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تتسلل إلى السياسات التربوية والتعليمية تصورات تسويقية تَخلِطُ بين التلميذ والمستهلك، وبين القسم ومنصة العروض. وهكذا، بدل أن يُنظر إلى المدرسة باعتبارها فضاء للتكوين الفكري والتربوي، تُختزل إلى خشبة لعرض “فقرات استعراضية” عابرة، تحت غطاء “الإدماج” و”الانفتاح” و”تنويع العرض”. فهل نحن فعلاً أمام سياسة تعليمية جادة؟ أم أمام محاولة لتسويق صورة “مُعولمة” لمدرسة لا تملك بعد مقومات التربية الوطنية الأصيلة؟
الهيب هوب ليس “جديدًا” بل دخيلا
من السهل اتهام كل معترض على إدخال الهيب هوب في المدرسة المغربية بالتحجر أو رفض كل جديد. لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا: الهيب هوب، في جوهره وشكله الحالي كما يُطرح، ليس تعبيرًا تربويًا محليًا ينبع من الواقع المغربي. كما أن التجديد التربوي الحقيقي لا يعني الانسياق وراء صيحات ثقافية عابرة أو استيراد مباشر للمواضيع الفنية دون دراسة معمقة لحاجات المتعلم وظروفه. على العكس، يتطلب تطوير المدرسة المغربية بناء جسور بين الموروث الثقافي المحلي ومتطلبات العصر، مع مراعاة الهوية الوطنية والحس الاجتماعي.
إن إدخال الهيب هوب كعنصر تعليمي جديد، دون مراجعة كيف يمكن أن يتفاعل هذا التعبير مع قضايا التلميذ المغربي النفسية والاجتماعية، قد يكرس الفجوة بين المدرسة وواقعها، ويفتح الباب أمام مبادرات تبدو وكأنها عملية تجميل شكلي للمنظومة التعليمية، لكنها في جوهرها لا تلامس عمق التحديات البنيوية التي تواجه التعليم. إن الجديد في التربية لا يُقاس بحداثة الظاهرة أو غرابتها، بل بمدى انسجامها مع الهدف الأساسي للمدرسة: تكوين الإنسان القادر على التفكير النقدي والتعبير الحر وبناء هويته في محيطه الثقافي والاجتماعي. وأي تجديد لا يراكم على هذا الأساس يصبح مجرد شذوذ زائل، يستهلك موارد دون فائدة مستدامة.
ما نحتاجه ليس رقصًا بل إصغاءً
لسنا ضد الفن، إذا ما اعتبرنا الهيبهوب فنا،، ولسنا ضد انفتاح المدرسة على تعابير جسدية جديدة. لكننا نطمح أن يكون هذا الانفتاح نابعًا من فكر تربوي حقيقي، لا من نزوة تسويقية عابرة. إن الطفل المغربي، قبل أن يتعلم حركات “البريكينغ”، يحتاج أن يتعلم كيف يقرأ، وكيف يسأل، وكيف يتواصل وكيف يستقل بذاته في عملية التعلم. إنه يحتاج إلى أن يُسمع له، لا أن يُعلّب في نسخة مُشوهة من ثقافة لا تعنيه. ومن المؤلم أن يتحول الفصل الدراسي إلى “حلبة استعراض” بدل أن يكون فضاءً لبناء الإنسان.
ويبقى السؤال الأخير مفتوحًا على المرارة: من الذي سيرقص فعلاً؟ التلميذ… أم صانع القرار؟



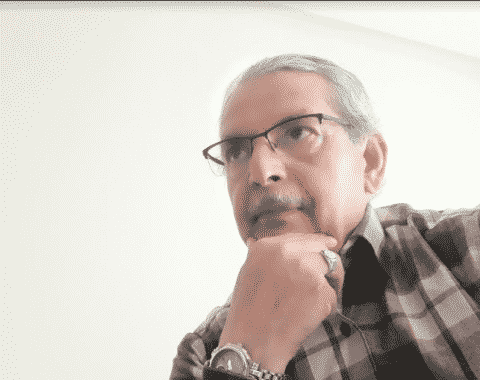

اترك تعليقاً