الفساد ومحاربة الكفاءات في المغرب: بين مأزق الدولة الوطنية وإرادة الإصلاح والتغيير

يطرح موضوع الفساد في المغرب إشكالية معقدة تتجاوز مجرد كونه اختلالًا إداريًا أو ماليًا، إلى كونه تعبيرًا عن أزمة أعمق في بنية الدولة الوطنية، وفي قدرتها على إنتاج نخب ومسؤوليات تتسم بالكفاءة والنزاهة والمسؤولية. فرغم تراكم النصوص القانونية، ووضوح التوجيهات الملكية المتكررة في الدعوة إلى محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن الممارسة العملية ما تزال تشهد استمرارًا لظواهر الزبونية، الريع، ونهب المال العام، مصحوبة بإقصاء الكفاءات، واستمرار نفس النخب في إعادة إنتاج الفشل المؤسساتي.
إن متابعة مغاربة العالم لما يجري في الوطن، ليست تعبيرًا عن حنين عاطفي فقط، بل عن إحساس بمسؤولية جماعية تجاه مستقبل بلدهم، ورغبة صادقة في رؤيته قويًا، عادلًا، ومزدهرًا. ولكن هذا الطموح يصطدم بواقع يثير أسئلة جدية عن جدوى السياسات الحالية، وعن حدود الإرادة الإصلاحية، في ظل استمرار عقلية الحصانات غير المعلنة، والتمييز ضد الكفاءات المستقلة.
أولًا: مأزق المحاسبة في الدولة الوطنية
منذ مطلع الألفية، رسخت الدولة المغربية عبر خطب جلالة الملك محمد السادس توجيهًا استراتيجيًا لا لبس فيه: ضرورة القطع مع الريع والفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشجيع المواطنين على عدم تزكية المفسدين في الانتخابات، بل والدعوة إلى يقظة المجتمع تجاه من يوظف المال والسلطة لمآرب شخصية. هذه الدعوة المتكررة تعبّر عن إدراك واضح بأن بقاء الدولة الوطنية في موقع الضامن لوحدة المجتمع رهين بتصحيح هذه الاختلالات البنيوية.
غير أن المفارقة الكبرى تكمن في أن نفس الخطاب، حين ينزل إلى مستوى المؤسسات التنفيذية، غالبًا ما يُفرغ من مضمونه الإصلاحي، بفعل تغلغل شبكات مصالح وبنيات تقليدية ما تزال تتعامل مع المحاسبة كخيار سياسي ظرفي، لا كآلية بنيوية دائمة. والنتيجة أن أسماء معروفة بارتباطها بملفات فساد، تستمر في مواقع القرار، أو تعود إليها بأسماء ووجوه جديدة.
هنا يُطرح سؤال جوهري: إلى أي حد يمكن للدولة الوطنية، التي ما تزال أجهزتها الإدارية مأهولة بنفس العقليات التي أسست للفساد، أن تُصلح ذاتها حقًا؟ وهل يمكن تفكيك شبكات الريع دون إحداث قطيعة حقيقية مع منطق الحماية والولاءات؟
ثانيًا: الفساد كأداة إقصاء للكفاءات
بعيدًا عن الخسائر المالية المباشرة، فإن أخطر ما في الفساد تحوله إلى معيار ضمني لاختيار النخب في الإدارة والمؤسسات العمومية. فالمسؤول الفاسد لا يكتفي بنهب المال العام، بل يعمد إلى محاربة الكفاءات المستقلة والشريفة، لأنه يرى فيها تهديدًا لمنظومة مصالحه. وتترسخ بذلك سياسة «الإقصاء الممنهج» التي دفعت العديد من الكفاءات الوطنية، في الداخل والخارج، إلى الانكفاء أو الهجرة أو الاصطدام مع المؤسسة.
إن استمرار هذه الممارسات يهدد مشروع الدولة الوطنية في الصميم، لأنه يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، ويفرغ شعار «المحاسبة» من معناه، ويعيد إنتاج دورة الفشل الإداري.
ثالثًا: المجتمع المدني: بين الدعم والولاء
يمتد منطق الزبونية أيضًا إلى الحقل الجمعوي، إذ يلاحظ أن الدولة تستمر في تمويل جمعيات في الخارج بمبالغ كبيرة، رغم غياب أثر واقعي أو برامج حقيقية تخدم الجالية. بينما يتم إقصاء جمعيات ذات مصداقية ونشاط فعلي، فقط لأنها لا تنخرط في شبكات الولاء أو لا تحسن «التطبيل».
إن تحويل المجتمع المدني إلى واجهة شكلية، بدل أن يكون شريكًا فعليًا في التنمية، يُضيّع فرصة ثمينة لتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة تحديات الهوية والانتماء والتنمية.
رابعًا: أين تكمن المسؤولية؟
في ظل هذا الواقع، تظهر الحاجة إلى مساءلة بنيوية للإرادة الإصلاحية الحقيقية:
• هل نحن أمام أزمة رؤية سياسية شاملة؟
• أم أن الإشكال يكمن في عجز المؤسسات التنفيذية عن تنفيذ التوجيهات الملكية؟
• وهل يكفي خطاب إصلاح من الأعلى لتفكيك منظومات المصالح المتغلغلة إداريًا؟
• أم أن الأمر يتطلب إرادة شجاعة لدى النخب، وقضاء مستقل، ورقابة مجتمعية يقظة؟
خامسًا: توصيات عملية
انطلاقًا من التحليل أعلاه، نقترح جملة من التدابير العملية القابلة للتنفيذ على المدى المتوسط:
1. تعزيز الرقابة والمحاسبة
– تقوية صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات مع ضمان إحالة الملفات ذات الطابع الجنائي فورًا على القضاء.
– حماية استقلالية القضاء، وتوفير الحماية القانونية للقضاة المكلفين بملفات الفساد الكبرى.
2. إصلاح التعيين في المناصب العليا
– إلزام الإدارات والمجالس بإعلان معايير التعيين والمباريات لشغل المناصب، مع نشر النتائج للعموم.
– اعتماد تقييم دوري للأداء، وربط بقاء المسؤولين بنتائج ملموسة.
3. إصلاح منظومة الدعم العمومي للجمعيات
– اعتماد دفتر تحملات صارم، وربط الدعم بمؤشرات أثر ميداني، مع إقصاء الجمعيات الصورية وتشجيع الجادة.
4. حماية الكفاءات الوطنية ومغاربة العالم
– إنشاء مرصد وطني للكفاءات يربط بين حاجيات الدولة وقدرات المغاربة في الداخل والخارج.
– إقرار تشريع لحماية المبلغين عن الفساد من الانتقام المهني أو الإداري.
5. تعزيز الوعي المجتمعي
– إطلاق حملات وطنية للتحسيس بمخاطر تزكية المفسدين، وأثر الفساد على التنمية.
– إدماج قيم النزاهة في المناهج التعليمية والبرامج الجامعية.
6. خطة وطنية محددة الأفق الزمني
– إعداد خطة وطنية متعددة السنوات (2025–2030) بأهداف كمية ومؤشرات قياس، مع تقييم دوري علني.
* خاتمة القول:
إن محاربة الفساد ليست خيارًا إداريًا ظرفيًا، بل رهان وجودي للدولة الوطنية المغربية، لضمان كرامة مواطنيها وتعزيز مشروعيتها الرمزية. إن الإصلاح يحتاج إلى قرارات واضحة، وآليات شفافة، وجرأة مؤسساتية لتفكيك شبكات المصالح، مع تثمين الكفاءات الوطنية ومنحها مكانتها المستحقة.
مغاربة الداخل والخارج لن يكفوا عن الحلم بمغرب عادل، نظيف، حر، تسود فيه العدالة الاجتماعية والمحاسبة، وتُرفع فيه كرامة المواطن فوق أي اعتبار. لكن هذا الحلم لن يتحقق بالتمنيات، بل بالقرارات والشجاعة.
إننا في النهاية، ما زلنا نثق أن التوجيهات الملكية الواضحة ستجد طريقها إلى التنفيذ الحقيقي، حين تتحمل المؤسسات التنفيذية مسؤوليتها أمام ضمير المجتمع والتاريخ.


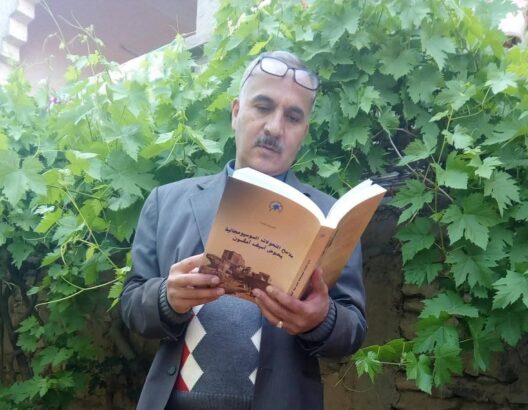

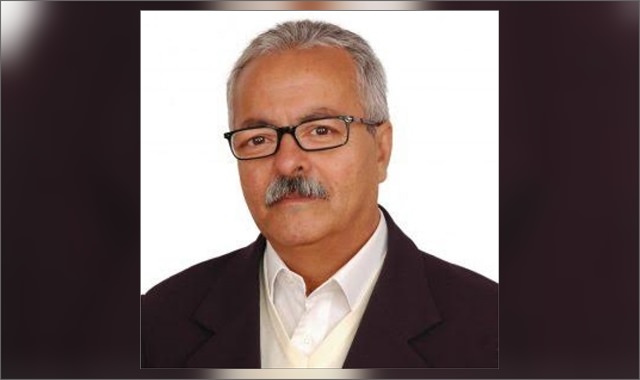
اترك تعليقاً