الجامعة المغربية بين الغش الأكاديمي وتدهور البحث العلمي: مقاربة نقدية مقارنة

مقدمة
تواجه الجامعة المغربية في الوقت الراهن تحديات بنيوية ومعرفية متشابكة، تتجاوز مسألة ضعف التمويل أو نقص البنية التحتية، لتمسَّ جوهر العملية التعليمية والبحثية ذاتها. من التفشي الواسع للغش الأكاديمي إلى التدهور الملحوظ في جودة التكوين، وصولاً إلى ظاهرة السرقات العلمية، تتشكل معالم أزمة مركبة تهدد مصداقية المؤسسة الجامعية برمتها، وتدفع نحو مساءلة فلسفة التعليم العالي في المغرب وموقعه ضمن سياقه الإقليمي والعالمي.
أولاً: الغش الأكاديمي كعرض لانهيار المعنى التربوي
لم يعد الغش مجرد سلوك فردي معزول، بل تحول إلى ظاهرة بنيوية تعكس أزمة عميقة في التمثلات الجماعية لدور الجامعة. في ظل ضعف التكوين الأساسي، وغياب التحفيز الفعال، وانفصال البرامج الدراسية عن متطلبات الواقع، أصبح النجاح يُطلَب بأي وسيلة كانت، مما يفرغ العملية التعليمية من مضمونها التكويني والقيمي. وتشير تقارير أكاديمية، كتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (2018)، إلى أن الغش تحول إلى “مؤسسة موازية” داخل عدد من الكليات، تُدعم أحياناً بتواطؤات صامتة من مختلف الأطراف.
ثانياً: السرقات العلمية وتآكل أخلاقيات البحث
تشهد البيئة الأكاديمية المغربية تدهوراً ملحوظاً في نزاهة البحث العلمي. فقد أشارت دراسة لموقع إلكتروني متخصص¹ إلى أن مؤشر النزاهة العلمية صنّف معظم الجامعات المغربية ضمن الفئة ذات المخاطر المرتفعة، بسبب ارتفاع نسبة المقالات المنشورة في المجلات الوهمية²، وسحب عدد من الأبحاث المنشورة دولياً بسبب مخالفات علمية واضحة. وهذا يعكس أزمة أخلاقية بحثية عميقة.
ثالثاً: أزمة التكوين وتفكك المشروع البيداغوجي
في ظل الاكتظاظ الطلابي، وضعف التأطير، وتقادم المناهج، أصبح التكوين الجامعي أقرب إلى عملية إنتاج للكم منه إلى بناء للكفاءات الحقيقية. ويُلاحَظ غياب برامج التكوين المستمر للأساتذة، وندرة البرامج التي تدمج بين المعارف النظرية والمهارات العملية والتقنية، مما يفرغ الشهادة الجامعية من مضمونها المهني والمعرفي، ويخرج أجيالاً لا تستجيب لمتطلبات سوق العمل.
رابعاً: مقارنة إقليمية: المغرب، مصر، والخليج
في مصر، ورغم المعاناة من بيروقراطية التمويل وتضخم النشر على حساب الجودة، فقد تمكنت المنظومة المصرية من تحقيق حصيلة كمية معتبرة، إذ احتلت المرتبة الأولى إفريقياً من حيث عدد المنشورات العلمية
سنة 2020، وفقاً لتقرير صادر عن منصة بحثية³، مما يعكس كتلة بحثية حرجة رغم التحديات.
أما في دول الخليج، فتعتمد الجامعات على وفرة الموارد المالية واستقطاب فروع لمؤسسات أجنبية مرموقة، غير أن الاعتماد المفرط على النماذج المستوردة لم يُفضِ بعد إلى بناء منظومة بحثية محلية مستقلة، كما تشير دراسة منشورة في مجلة علمية عربية⁴.
أما المغرب، فقد تبوأ مكانة متدنية في مؤشرات جودة التعليم، إذ احتل المرتبة 101 من أصل 139 دولة، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى اقتصادي دولي⁵، مما يضع أداءه في سياق إقليمي يتسم بالتراجع العام.
خامساً: نحو إصلاح أكاديمي متعدد الأبعاد
لا يمكن تجاوز هذه الأزمة المركّبة عبر حلول تقنية أو ترقيعية محدودة، بل يقتضي الأمر إعادة تعريف جذرية لوظيفة الجامعة المغربية وهويتها المعرفية والاجتماعية. إنّ إصلاح الجامعة يجب أن ينطلق من رؤية شمولية تجعل من النزاهة الأكاديمية محورًا أساسيًا في بناء الثقة داخل المجتمع الجامعي. ويُفترض أن يتم ذلك من خلال ترسيخ أخلاقيات البحث العلمي في المناهج الدراسية، وجعلها مكوّنًا إلزاميًا في التكوين الأساسي والتقييم الأكاديمي على السواء.
كما يستدعي الأمر إعمال آليات صارمة لمكافحة الغش والانتحال العلمي، عبر اعتماد برامج إلكترونية متخصصة لكشف الانتحال⁶، وربط نتائجها بعقوبات واضحة ورادعة، بما يعيد الاعتبار للجدارة والاستحقاق داخل الحقل الجامعي.
وفي السياق نفسه، لا بد من تحديث التكوينات الجامعية لتواكب التحولات التكنولوجية وسوق الشغل المستقبلية، عبر إعادة هيكلة التخصصات وتنويع المقاربات البيداغوجية.
ويُعد تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعات خطوة محورية تمكّنها من تطوير مشاريعها البحثية والتربوية بحرية وفعالية، كما يتطلب الإصلاح الحقيقي تأهيل الأساتذة والباحثين من خلال برامج تكوين مستمر ودعم مادي ومعنوي يربط بين الأداء الأكاديمي والتحفيز.
وأخيرًا، فإنّ أي إصلاح بيداغوجي ناجع لا يمكن أن يتحقق إلا عبر بناء مشروع متكامل يربط بين المعارف النظرية الراسخة والمهارات العملية والقدرات النقدية، في انسجام مع قيم النزاهة والانفتاح والإبداع. بهذه الرؤية التكاملية وحدها يمكن للجامعة المغربية أن تستعيد رسالتها التاريخية كفضاء للعقل الحر والإنتاج المعرفي الأصيل.
خاتمة
الجامعة ليست مجرد فضاء للتدريس ونقل المعرفة، بل هي مؤسسة لإنتاج المعنى، وتشكيل الوعي، وبناء المستقبل. وأي إصلاح لا ينطلق من هذا التصور الجذري والشامل، سيظل حبيس الحلول الترقيعية والعاجزة عن مجاراة عمق الأزمة. إن الحاجة اليوم ماسة إلى إرادة سياسية وأكاديمية حقيقية لبناء مشروع جامعي مغربي أصيل، يجمع بين العمق المعرفي، والالتزام الأخلاقي الرصين، والانفتاح الواعي على التحولات المجتمعية والعلمية العالمية.
المراجع (باللغة الأصلية)
¹ Biblipresse (2022). “Research Integrity Index (RI²)”.
² Predatory Journals.
³ SciVal Report (2020).
⁴ Araa Journal (2021). “Arab Research and Academic Analysis Journal”.
⁵ World Economic Forum (2020). “Global Competitiveness Report”.
⁶ Turnitin.



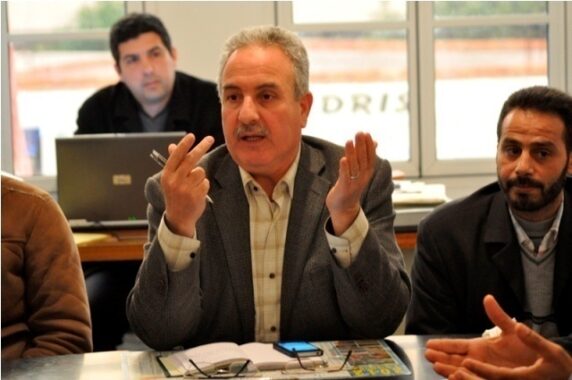

اترك تعليقاً