عصيد وإشكالية العلاقة بين الدين والعلم

في مقطع نشر حديثا على صفحته في الفايسبوك،بعنوان: “الدعاة المغاربة وأسلمة العلوم”،خرج الناشطالحقوقيأحمد عصيد مرة أخرى؛ليمارس كعادته شغبه الفكري، ويواصل التعتيم على الحقائق بتدليس فج، وتلبيس مفضوح، لا يمكن أن يقبله من له مسكة من عقل، فضلا عنمن ينتمي إلى فضاء لعلم والمعرفة. غير أن هذا كله لا يستغرب من رجل كرس حياته ووقته وجهده لخدمة إيديولوجيا مقيتة تحت غطاء الفلسفة والعلم، وهو في الواقع لا يعدوا أن يكون مجرد مدلس يمارس فن الخطابة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي،في محاولة للتأثير على أولئك الذين تستهويهم مثل هذه الخرجات والشطحات، التي تتدثر بدثار العلم، وهي أقرب ما يكون إلى ممارسة الدجل والخرافة منها إلى الممارسة العلمية التي تتطلب التجرد الكامل عن كل الأهواء والنزعات الذاتية، لتحقيق الإنصاف والموضوعية وقول الحقيقة دون مواربة أواعتساف.
عصيد اعتبر أن حديثه في هذا الموضوع جاءفي سياق الرد على التشويش الذي أثاره بعض الدعاة الذين يدعون إلى تدريس العلوم بتأطير إيديولوجي عاطفي ديني، مشددا على أن المعرفة العلمية تقف على الطرف النقيض من الفكر الديني،الذي هو قناعة شخصية وجدانية وعاطفية لا علاقة لها بالمعرفة العلمية.
وبعيدا عن هذا الادعاء الباطل، وفي سياق محاولته التأسيسية لإثبات عدم إمكانية تدريس العلوم البحتة وفق المنظور الديني،استند أحمد عصيدعلى قضية مهمة كانت ولا زالت مثار نقاشبين المهتمين بالشأن الديني والفلسفي على حد سواء، وهي قضية العلاقة بين الدين والعلم أو العقل والنقل كما هو معروف في تراث الفكر الإسلامي، غير أن ما لفت انتباهي هو عدم التزام المتحدث بالموضوعية في طرحه لهذه القضية، والتحلي بالجرأة العلمية الكافية لقول الحقيقة كاملةغير منقوصة، سواء من حيث الحسم العلمي في هذه القضية، إذ لا يوجد اتفاق يحسم الجدل فيها سلبا أو إيجابا، أو من حيث القائلون بهذا الرأي أو ذلك، فليس كل من قال بالوصل سلفيا متزمتا ولا كل من قال بالفصل فيلسوفا متنورا، بل الواقع التاريخي يسجل عكس ما ذهب إليه عصيد كما سنرى.
لقد اعتبرأحمد عصيدأن منطق تدريس العلوم مختلف عن منطق تدريس الدين،ذلكأن الدين والعلم،مختلفان تماما، ولا يمكن،بل ولا يجوز الخلط بينهما، لأن الخلط بينهما يؤدي إلى نشر الجهل ولا يؤدي إلى العلم.ونحن نتساءل في هذا السياق،هل العلم والدين مختلفان تماما كما يدعي أحمد عصيد، أم بينهما توافق وانسجام؟ أم أن القضية على الأقل ما زالت تحتاج إلى بحث ونظر وتدقيق؟
بالعودة إلى تاريخ الفكر الإسلامي نجد أن إشكالية العلاقة بين الدين والعلم، قدطرحت منذ العصور الأولى للإسلام، ونوقشت نقاشا علميا مستفيضا،لاسيما بعد دخول الفلسفة اليونانية إلى فضاء الفكر الإسلامي فيما يعرف بجدلية العقل والنقل. وقد حاول عدد من العلماء والمفكرين والفلاسفة، منذ ذلك الحين، أن يقدموا إجاباتحول هذه الإشكالية، حيث ظهرت محاولات كثيرة للتوفيق بين العلم والدين، وذلك من خلال تلمس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على التفكر والتأمل؛ لإثبات أن الشريعة لا تعارض التفكير العقلي. وقد سلكوا في ذلك مسالك متعددة. فمنهم مَنْ ألَّف رسائل موجزة تشرح كيف يصل العقل إلى الحقائق الكبرى التي ورد بها الدين، كرسالة “الاعتبار” لابن مسرة (ت: ۳۱۹هـ). ومنهم من اتخذ أسلوب القصص كقصة حي بن يقظان لابن طفيل. ومنهم من تناول بالمقارنة العامة القضايا الأساسية لكل من الفلسفة والشريعة، كابن رشدمن خلال كتابه فصل المقال.
وسنكتفي هنا بإيراد بعض النماذج من أقوال هؤلاءالذين حاولوا التوفيق بين العلم والدين أو بشكل أخص بين الفلسفة والشريعة، في فضاء الفكر الإسلامي، سواء من المتقدمين أوحتى من المتأخرين. والغرض هو محاولة تقويض الأسس التي أقام عليها أحمد عصيد تصوره للعلاقة بين الدين والعلم، في محاولة منه لسحب الدين خارج فضاء المعرفة العلمية.
1- موقف بعض المتقدمين من العلاقة بين العلم والدين/العقل والنقل
يتجسد موقف المتقدمين من إشكالية العقل والنقل فيما خلفوه من آثار علمية حول علاقة الفلسفة بالشريعة على الخصوص، ويعد الكندي أول من تكلم في هذا الموضوع، حيث أوضح أنه لا تناقض بين الفلسفة والشريعة، فبعد تعريفه للفلسفة، ذكر أنها من أشرف الصناعات الإنسانية؛ لأن غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق، وفي عمله العمل بالحق، وفي هذا العلم علم الربوبية، وعلم الوحدانية، وعلم الفضيلة، وجملة علم كل نافع والسبيل إليه، والبعد عن كل ضار والاحتراس منه، واقتناء هذه جميعاً هو الذي أتت به الرسل عن الله تعالى، فواجب إذن التمسك بهذا العلم، فإن قال قائل: إنه لا يجب التمسك بهذا العلم، وجب عليه أن يقدم على ذلك البرهان، وتقديم البرهان هو من أصول الفلسفة، فواجب إذن طلب هذا الأصل بألسنتهم والتمسك بها اضطرارا عليهم.
وجاء بعد الكندي فلاسفة كثر تحدثوا في هذه القضية،وقدموا إجابات علمية رصينة، ولعل من أبرزهم:الفيلسوف ابن رشد، الذي يعدمن الفلاسفة الذين تناولوا في مؤلفاتهم إشكالية العلاقة بين الدين والفلسفة، ففي كتابه “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال” ذكر ابن رشد أن الفلسفة إذا كانت تعني النظر في الموجودات، فإن الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات وحثَّ على ذلك في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: (فاعتبروا يأولي الابصار) [الحشر: 2] وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي…وكما أن الفقيه يستنبط من الأمر بالتفقه في الأحكام وجوب معرفة المقاييس الفقهية، فكذلك يجب أن يستنبط من الأمر بالنظر في الموجودات وجوب معرفة القياس العقلي وأنواعه.
ويضيف أيضا: وإذا كانت هذه الشريعة حقا وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق، فإنا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له.
وهكذا ينتهي ابن رشد إلى أن الحكمة هي صاحبة الشريعة، والأخت الرضيعة، وهما المصطحبتان بالطبع، المتحابتان بالجوهر والغريزة.
ومن المفارقات العجيبة والتناقضات الصارخة أن أحمد عصيد تحدث في هذا المقطع عن ابن رشد بكثير من التبجيل،واعتبره رائدا للعقلانية الإسلامية،لأنه دعاإلى ضرورة إعمال العقل والبرهان العقلي وإلى استعمال هذا البرهان في النظر في الموجودات،لكنه غيب تماماموقفه الصريح من إشكالية العلاقة بين الفلسفة والدين، لأنه يعلم يقينا أن ذكر موقف ابن رشدفي هذه القضية من شأنهأن ينسف البناء الذي هو بصدد تشييده من أساسه.
2-موقف بعض المعاصرين من العلاقة بين العلم والدين/ الفلسفة والشريعة
لقد حظيت إشكالية العلاقة بين الدين والعلمباهتمام كثير منالمعاصرين،لاسيما بعد الانفجار المعرفي والثورة العلمية التي شهدها المجتمع المعاصر في جميع مجالات الحياة الإنسانية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة طرح السؤال حول طبيعة العلاقة بين العلم والدين، وهل المجتمعات المعاصرة ما زالت بحاجة إلى الدين أصلا في ظل هذا التطور العلمي الذي كشف كل أسرار الطبيعة والكون، بحيث لم يعد الإنسان بحاجة إلى مصدر آخر للمعرفة غير العلم، وهكذا بدأت تظهر بعض الأصوات التي تنادي بفصل الدين عن المعرفة العلمية، بل وعن الحياة بشكل عام، لأن الدين في نظر هؤلاء أصبح يعرقل التقدم المعرفي والتطور الحضاري، فكان من الطبيعي أن يخرج بعض العلماء والمفكرين لتفنيد هذه المزاعم، وتقرير أن الدين لا يعارض المعرفة والتقدم العلمي، بل يدعمه ويوجهه الوجهة الصحيحة التي ينبغي أن يسلكها، ولعل من أبرز هؤلاء الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه الفلسفة القرآنية، حيث يقول: إن العقيدة الدينية هي فلسفة الحياة بالنسبة إلى الأمم التي تدين بها، وإنها لا تعارض الفلسفة في جوهرها، وأن الفلسفة تصلح للاعتقاد، كما تصلح العقيدة للفلسفة. ويقول أيضا: إن القرآن الكريم يشتمل على مباحث فلسفية من جملة المسائل التي عالجها الفلاسفة من قديم الزمن، وأن هذه الفلسفة القرآنية تغني الجماعة الإسلامية في باب الاعتقاد، ولا تصدها عن سبيل المعرفة والتقدم.
وممن انتهج هذا المنحى التوفيقي بين الفلسفة والدين من المعاصرين،الفيلسوف التونسي أبي يعرب المرزوقي، حيث يرى هذا الأخير أن المنطق الداخلي الذي حكم الفكر العربي الإسلامي، لتجاوز إشكالية العداء بين الفكرين الديني والفلسفي، يتأسس على حقيقة أن هذين الفكرين متحدان في الجوهر بعيداً عن مغالاة الفكر الفلسفي، وتسطيح الفكر الديني؛ إذ سعى الفكر العربي الإسلامي إلى التوحيد بين الفكرين منذ صياغته في صورته النسقية وأصنافه المتعددة. ويبرز ذلك في اجتماع ما سماه بالرحم الأعم (القرآن الكريم)، وهو يشمل أربعة أنواع من العلوم، العلم النظري بضربيه: الطبيعي والإنساني، وما نتج من تداخلهما (الفكر الفلسفي)، والعلم العملي الذي يقصد به الفقه وضروبه: فقه السياسة، وفقه الحياة المدنية، وفقه المعاملات، وفقه الحياة الخلقية (الفكر الديني) وعلم الكلام بضروبه المتعددة وأصوله الفلسفية، وعلم التصوف بضروبه الذاتية والموضوعية ومردّه الفكر الديني.
وتأسيسا على ذلك، فإن التحليل التاريخي للفكرين الديني والفلسفي بحسب أبي يعرب، يثبت أنهما متحدان في الجوهر، ويردُّ التقابل بينهما إلى جانبين، معرفي وتوظيفي: أما الجانب المعرفي فيتمثل في الغلو الذي يمارسه من يأخذهما من جانب واحد، مُتنكّراً للمعرفة الإنسانية بعمومها. وأما الجانب التوظيفي فيتمثل في توظيف كل من الدين والفلسفة لغير ما جاءا لأجله؛ الشيء الذي حرفهما عن المسار والوجهة الأصيلة لكل منهما.
وهؤلاء الذين ذكرناهم بالاسم والذين لم نذكرهم اختصارا،هم فلاسفة ومفكرون،وليسوا دعاة سلفيين ولا إخوانيين على حد تعبير عصيد،ورغم ذلك لا يرون أي غضاضة في الجمع بين الدين والعلم، بل يرون أن التوفيق بين العلم والدين، هو الموقف العلمي السليم الذي ينبغي أن يلتزم به كل من ينتمي إلى حقل المعرفة الإنسانية، بل إن الواقع يؤكد على أن الدعاة والسلفينهم أكثر الناس رفضا لفكرة التوفيق بين العلم والدين، على عكس ما قرره صاحبنا أحمد عصيد، شأنهم في ذلك شأن العلمانيين المعاصرين أمثال عصيد نفسه، فكلا الاتجاهين يرفض مسألة التوفيقبين الحقلين، وإن بدوافع مختلفة،وهذا ما ذهب إليه الفيلسوف التونسي أبو يعرب المرزوقي حين اعتبربأن إشكالية الوحدة بين الديني والفلسفي تكمن في أمرين: أولهما: رؤية بعض الأصوليين الإسلاميين المتمثلة في استحالة التوفيق بين الفكر الفلسفي والفكر الديني، ما دفعهم إلى الحكم بإلغاء الفلسفة وتحريمها. ثانيهما: الأصولية العلمانية التي قضت بإلقاء الديني؛ لعدم توافقه مع منطق العقل، فكلاهما يقول بالتنافي، وقولهما هو جوهر الاختلاف.
وإذا كان هذا الخلط بين العلم والدين غريب وخطير،ويعاكس أسباب النهضة، من منظور أحمد عصيد، فإن فصل العلم عن الدين أخطر منه بكثير، وهذا ما لم ينتبه إليهعصيد وأمثاله ممن يوافقونه في هذا الرأي.صحيح أن العلم استطاع أن يحقق في حياة البشرية أشياء لم يكن يحلم بها البشر في يوم من الأيام، لكن لا ننسى أن هذا العلم نفسه الذي حقق كل هذه الفتوحات المعرفية،والثورات العلمية غير المسبوقة، قد فتح على البشريةأبوابا من الشر كثيرة، بدءا من صنع الأسلحة المدمرة التي لا تبقي ولا تذر، مرورا بالتلاعب بجينات الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وصولا إلى تدميرالبيئة وتلويثها واستنزاف كل ثرواتها الحيوية. ولا شك أن ما نشهده اليوم من كوارثطبيعية، وتقلبات مناخية خطيرة، إنما هو نتيجة حتميةلإطلاق العنان للعلم دون قيد أو شرط،وبسبب فصل العلم عن الدين،والقيم الروحية عن الحياة المادية الغريزية.
الهوامش:
-الأثر الفلسفي في التفسير، بكار محمود الحاج جاسم.
-فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ابن رشد.
-الفلسفة القرآنية، عباس محمد العقاد
-وحدةالدينيوالفلسفيفيمشروعأبييعربالمرزوقيالحضاري،حنانفيضاللهالحسيني.



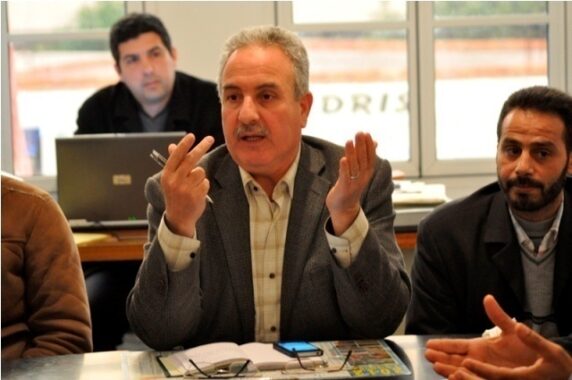

اترك تعليقاً