التماسك بين السياسات والقيم.. محاولة في الرأسمال الاجتماعي المغربي

في موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الإنسانية والفلسفة، التي أعدها الراحل محمد سبيلا والباحث نوح الهرموزي، يُعرف التماسك الاجتماعي باعتباره حالة من التساند والتعاضد تعرفها جماعة أو مجتمع ما، بفعل الروابط الاجتماعية والثقافية المشتركة.
النص القصير والمكثف للتعريف المقترح، كان لابد أن يعرج على الإسهام التأسيسي لإيميل دوركايم في “تقسيم العمل الاجتماعي”، وهو يميز بين التماسك الآلي داخل الجماعات الصغرى، وبين التماسك العضوي داخل الجماعات الحديثة حيث تتعارض المصالح وتتناقض القيم.
المنجز الذي تم تأليفه في الأنفاس الأخيرة من القرن 19، من طرف هذا الباحث الفرنسي الذي يعد أحد مؤسسي علم الاجتماع، سيضع منذئذ موضوعة التماسك الاجتماعي على أجندة البحث في العلوم الاجتماعية، كسؤال مركزي للدراسات السياسية والاقتصادية والسوسيولوجيا، على أنها ستصبح كذلك واحدة من بؤر اهتمام السرديات الكبرى التي طبعت القرن العشرين وفورة الإيديولوجيات المحمولة على جلبة الصراع والتجاذب والتقارب والتقاطع بين فكرتي الحرية والمساواة.
في هذا القرن الإيديولوجي الصاخب، كانت المعارك النظرية تدور كذلك حول أي من الفكرتين أقرب لتحقيق غايات التماسك، قبل أن تبرز إغراءات طريق ثالث يجمع فضائل الحرية ومآثر المساواة، ثم يطوي التاريخ صفحة القرن العشرين على إيقاع انتصار مشهدي للفكرة الأولى.
داخل ذاكرة هذا المفهوم، تحضر مضامين المنجز البحثي الواسع حول قضايا العدالة الاجتماعية وأسئلة التضامن وجدليات الإقصاء والإدماج، لكن تحضر كذلك أدبيات السياسات العمومية، التي باتت منذ التسعينات من القرن الماضي أكثر اهتماما في نصوصها المرجعية بسُبل تفعيل التماسك على صعيد مُخرجات الأداء العمومي، سواء على مستوى الحكومات أو المؤسسات الاقتصادية والمالية.
حيث سمح انتقال هذا المفهوم إلى سجل السياسات، ببلورة مقاربات مبنية على تحليل الفعل العمومي للحكومات بناءً على شبكة من مؤشرات قياس أثر التماسك في ديناميات المجتمع وروابطه.
إن التماسك الاجتماعي غاية فضلى للسياسة، وهدف أسمى للسياسات، لذلك فإنه ليس معطى جاهزا، ولا حالة طبيعية. إنه بالأساس بناء سياسي وقيمي ورمزي، وهو بذلك مشروع جماعي، وأفق للمستقبل في حاجة إلى الرعاية المتواصلة والتغذية المسترسلة.
إنه كذلك ليس مجرد حزمة سياسات عمومية اجتماعية، أو مجرد منظومة مؤسسات، بل هو في الأصل مرجعية قيمية تمنح المعنى للروابط الاجتماعية، وترسخ إرادة العيش المشترك، وتعطي للنسيج المجتمعي لحمته الحيوية، وتمكّن الانتماء الوطني من مضمونه الاجتماعي.
لهذا يحتاج التماسك الاجتماعي إلى فعل عمومي قائم على فلسفة الإدماج، وركيزة التضامن، وثقافة العدالة والإنصاف، لكنه يحتاج لكي يترسخ إلى تقاسم مفعم بمشاعر الانتماء الوطني، وإلى إيمان فطري بالسرد الوطني الجامع، وإلى تملك جماعي للرموز والعلامات والمؤسسات التي صنعت الذاكرة التاريخية، وإلى تماهٍ صادق مع المشتركات الوطنية، كما يحتاج إلى حد أدنى من السلوك المدني الذي يجعل العيش المشترك مغامرة يومية ملهمة.
كل ذلك يعني أن الروح العامة للتماسك الاجتماعي، لا يمكن أن تُصنع إلا داخل المدرسة الوطنية كمنتجة أساسية لقيم المشروع المجتمعي ولمعايير العيش المشترك.
وإذا كان بناء التماسك الاجتماعي ينهض على سياسات مدمجة ومؤسسات فاعلة، فإنه يتوقف كذلك على القدر الذي تستبطن به هذه السياسات والمؤسسات قيم التضامن والعدالة والمساواة والإنصاف.
ينتج التماسك الاجتماعي آثارا ومنافع الرأسمال الاجتماعي كأحد عناصر قوة الأمم، لكنه يحتاج في ذلك إلى فضائل الثقة: بين المواطنين وبينهم وبين المؤسسات. لذلك كثيرا ما تبدو مفاهيم التماسك والرأسمال الاجتماعي والثقة كمترادفات تحيل إلى نفس المضمون: إسمنت المجتمعات وروح الجماعة السياسية.
مغربيا، تنهض إشكاليات التماسك على خلفية عامة، ليست سوى التحولات الاجتماعية الكبرى التي ترتبط بالزمن الطويل الممتد منذ لحظة اصطدام المجتمع المغربي بالظاهرة الاستعمارية، وما أنتجته من آثار لم تُستنفذ بعد، بعد تفكك البنيات التأطيرية للمجتمع، والدخول في مرحلة انتقال ثقافي وقيمي معقد، تحت تأثير ثلاث تحولات حاسمة: التحول الديمغرافي من ديمغرافيا هشة إلى انفجار سكاني كبير، شكل حالة مدرسية لما يسميه الباحثون بظاهرة التحولات الكمية التي تخفي وراء الأرقام ركاما من التحولات النوعية، على مستوى القيم والتمثلات، خاصة من خلال تطور الأسر النووية وبروز الشباب كقوة واضحة.
ثم التحول الحضري من مغرب قروي إلى مغرب تهيمن على مجالاته الساكنة الحضرية، مع ما يتبع ذلك من تحولات في نمط العيش والعلاقة مع السلطة والقانون.
وأخيرا التحول الثقافي – أو ما يسميه الأستاذ محمد الصغير جنجار بالإقلاع الثقافي – الذي أحدثه ارتفاع نسب التمدرس وولوج مقاعد التعليم.
كل هذه التحولات، وهي تعيد هيكلة المجتمع في اتجاهات الفردانية والتشبيب والتأنيث، لا تصنع ذلك بمنطق خطي بسيط – كما كانت قد افترضت بسذاجة نظريات التحديث – بل تفعل ذلك ضمن سياق من التردد القيمي والتوترات الإيديولوجية، وإشكاليات الانسجام بين منطق البنيات الاجتماعية ومنطق القيم المهيمنة، وقضايا الموائمة بين المرجعيات القيمية المتنافسة بين دوائر التأطير المختلفة (الأسرة، المدرسة، الإعلام…).
على مستوى مرجعيات الأداء العمومي، تكرس خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس فكرة التماسك الاجتماعي كغاية مثلى للتنمية البشرية والنجاعة الاقتصادية، فيما تبرز على الصعيد المعياري جملة من الغايات الدستورية مثل: العناية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي (الفصل 31 من الدستور).
فيما لا تغيب نهائيا الإحالات على أفق التماسك الاجتماعي عن نصوص السياسات العمومية، إذ سبق للتقرير العام للجنة النموذج التنموي أن اعتبر تعزيز فرص الإدماج وتوطيد الرابط الاجتماعي كأحد المحاور الاستراتيجية للتحول السوسيو-اقتصادي المأمول لبلادنا.
التفكير في موضوعة التماسك، من منطلق العلوم الاجتماعية، يقتضي الانتباه إلى إرادوية مرجعيات الأداء العمومي في التشبث بطموح اجتماعي ملحوظ، وإلى رمزية التكريس المعياري للتماسك الاجتماعي كغاية كبرى للمجموعة الوطنية، كما يتطلب الانفتاح على أدبيات السوسيولوجيا المغربية لتلمس اتجاه الديناميات المعقدة للواقع المجتمعي، ولمسائلة مضمون الرأسمال الاجتماعي لبلادنا، بوصفه مجموع الإمكانات التي توفرها حيوية الروابط الاجتماعية المهيكلة للنسيج الوطني.
وهنا فإن تأويل تقاطعات مُخرجات بعض الأبحاث الميدانية المُحينة، حول اتجاهات القيم داخل المجتمع المغربي: [الدراسة الوطنية حول القيم وتفعيلها المؤسسي (مجلس النواب 2023) – البحث الوطني حول الرابط الاجتماعي، نسخة 2023 (المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية) – مؤشرات الثقة في المؤسسات، موجة 2024 (المعهد المغربي لتحليل السياسات)..] ومقارنتها مع نتائج الباروميتر العربي والمسح العالمي للقيم، يرجح الفرضية التالية: الموارد الرئيسة للرأسمال الاجتماعي المغربي لا تخرج عن هذا الثالوث المهيكل؛ الأمة المُوحدة، ثم الدولة، والأسرة الراعيتين.
في بيان ذلك، توضح خلاصات الدراسات المذكورة الارتباط الصميم للمغاربة بهويتهم الوطنية، ورسوخ قيمة الأسرة لديهم، حيث يبدو الرابط العائلي أقوى الروابط التي ينتظم داخلها المغاربة.
أما مؤشرات الثقة العالية في المؤسسات السيادية، والتفضيل القيمي للمساواة على الحرية، ومادية الطلب الاجتماعي (هيمنة المطالب الاقتصادية على المطالب ما بعد المادية)، فكلها عناوين تحيل على حقيقة توازي الطلب المكلف على الدولة – في تدبير السياسات وتوزيع الموارد وتأمين الرعاية – بالثقة الراسخة في أدوارها ومهامها.
ليبقى السؤال عما إذا كانت هيمنة الثقة في الأسرة والدولة كمؤسستين للرعاية، تعني أن المجتمع المدني – بالمفهوم الهيغيلي – كشبكة الانتماءات والتضامنات التي تفصل الأسرة عن الدولة – بعد أن كان قد تجاوز منذ سنوات كونه مجرد فرضية بحثية – لا يزال لحد اليوم مشروعا للمستقبل.
من جهة أخرى، فإن اهتمام جزء من الدراسات الميدانية المذكورة، والأبحاث السوسيولوجية، بأثر جائحة كوفيد وغيرها من أزمنة اللا يقين على ديناميات التماسك الاجتماعي، يؤكد أن لحظة “كورونا” لن تكن فقط اختبارا للاستجابة الصحية واللوجستية والاقتصادية والتدبيرية للدولة، لكنها كانت كذلك اختبارا قاسيا للمنظومة القيمية، وأن المغاربة أعادوا – في النهاية تحت وطأة الأزمة – اكتشاف فضائل التضامن الأسري والثقة المؤسساتية.
حيث يعتبر، مثلا، الأستاذ عمر بنعياش، أن سياق الجائحة قد عزز داخل المجتمع دينامية التوليد الذاتي للثقة في الدولة، كجزء من مصفوفة القيم المغربية، وأن ما حدث هو أن المغاربة استطاعوا تحويل خلاصتي “الثقة والتوافق” بوصفهما “تفاهمات سياسية” تنتمي إلى سجل التاريخ الراهن، إلى مصاف القيم المؤسسة للتعاقد الطويل الأمد والمدى بين الدولة والمجتمع.
تبقى الإشارة إلى أن التماسك الاجتماعي، بناء يومي تغذيه قيم العيش المشترك وفكرة الدولة الوطنية، قبل أن تفعل ذلك السياسات.
على أن الانتباه لمُفارقات وتفاوتات جغرافيا خريطة الثقة، كما تتوزع داخل الرأسمال الاجتماعي المغربي، يستلزم العناية بعناصر القوة؛ من خلال الحرص على جعل الأسرة موضوعا مركزيا للسياسات العمومية، والاهتمام برعاية السردية الوطنية لتأطير المشاعر المتدفقة للانتماء الهوياتي للمغاربة، كما يستلزم في المقابل تعزيز الروابط الاجتماعية الأقل صلابة؛ من خلال تعابيرها السياسية والمدنية القائمة على فكرة المواطنة.


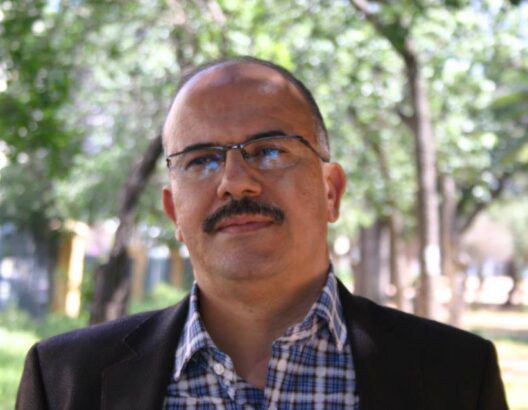


اترك تعليقاً