هل يقرب وباء كورونا نهاية العولمة وبداية تحقيب تاريخي جديد؟ (الحلقة 3)
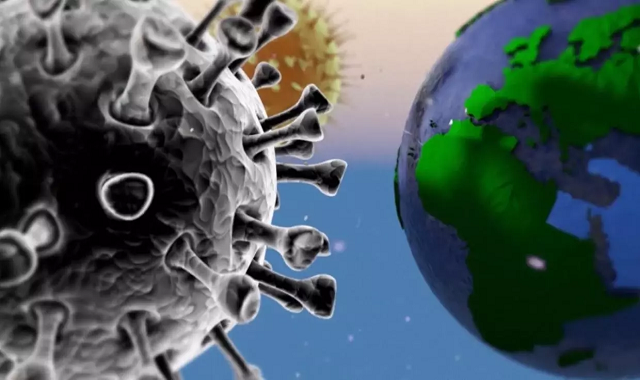
* الحلقة الثالثة: عالم ما بعد كورونا: الصعود الناعم للشرق وإعادة التفكير في نظام عالمي بديل
انتهينا في الحلقة الثانية إلى توصيف نقط ضعف العولمة، ووقوفها لحد الآن بسبب منظومتها الصحية الربحية المتوحشة، عاجزة عن التصدي لوباء كورونا الذي ساهم في إسقاط هيبتها، وكشف فجاجية نظرياتها المتأدلجة. بل أحدث لها انسدادا ما فتئ يدفع البشرية إلى إعادة طرح السؤال الوجودي، وموقف الإنسان من الحياة والموت في ظل نظام يعيش على تناقض مع كينونة الإنسان، وبالتالي صار يبحث عن نظام كوني جديد لا نزعم أنه سيحدث تغييرا جذريا في نظام العولمة الحالي، أو أنه سيجبر الولايات المتحدة على ترك مربع القيادة والمجد على المدى القصير، لكنه سيسفر على الأقل عن تغيير قواعد اللعبة، وتعديل في خرائط التحكّم، وبالتالي ظهور عولمة “معدّلة” وأكثر توازنا، واستحضارا للأمن الصحي، وسيكون للشرق، وخصوصا التنين الصيني الدور المؤثر في هندسته.
قراءتنا للسيناريوهات المحتملة لعالم ما بعد كورونا هي قراءة مركّبة، تتأسس على التوليف بين الأفكار التي طرحها المتخصصون والمفكرون الذين استطلعت آراؤهم حول مستقبل العالم بعد وباء كورونا في مجلة Foreign policy . كما ستستند إلى آراء بعض الفلاسفة، فضلا عن جملة الأحداث المتسارعة التي لا تزال تجري أمام أعيننا، مع تطعيمها ببعض الاجتهادات الخاصة التي تمتح روحها من سياق المنظور الحضاري للتاريخ، وبفرضيتنا القائمة على أن الأوبئة تساهم في تسريع حركة التاريخ وتكثيف تحولاته، واقتناعنا بأن العالم فضاء متحرك دائم التغيير، يتجدد باستمرار، خاصة في ظل الانتقال من المفهوم التقليدي للحضارات القائم على قاعدة الأمم والحدود، إلى حضارة الشبكات العالمية القائمة على بنيات الاتصال وسلاسل التوريد التي توحّد الشعوب، وهي ما يسميها “باراخ خانا” بالكونكتوجرافيا Connectography (الجغرافية الاتصالية) الذي تحل فيها القدرة على الاتصال مقام القوة العسكرية .
قبل وباء كورونا، كانت الأصوات تنادي بضرورة تغيير نظام العولمة باعتباره نظاما يفتقر لعلاقات اقتصادية عادلة، وأنه لا يعبّر عن مصالح السواد الأعظم من سكان الأرض، بقدر ما يعبّر عن مصالح الشركات العملاقة متعددة الجنسيات التي كرّست الفقر في دول الجنوب، وألحقت الضرر بالبيئة والمناخ، مما يفسر تصاعد الحركات الاحتجاجية ومناهضي العولمة من مثقفين ومنظمات حقوقية ونقابات مناضلة وتجمعات أخرى من قبيل منظمة “العالم ليس سلعة ” و”الطريق الفلاحي” و”أتاك”، وما في سلالتها من التنظيمات التي تصدّت للعولمة وفلسفتها البراجماتية.
لكن بعد استشراء وباء كورونا، وعجز الترسانة الصحية للنظام الرأسمالي الذي ترعاه العولمة، وتسارع ارتفاع أرقام عدّاد الموت، بدأت البشرية – جمهورا ونخبا- تطرح سؤالين سيكونان بمثابة القوة الدافعة لإعادة النظر في نظام العولمة بوصفها نظاما أحاديا، ومدى مشروعية القيادة الأمريكية للعالم:
1-لماذا أخفقت الدول المنضوية في فضاء العولمة في التنبؤ بوباء كورونا، ثم تخبطت بعد ذلك في أساليب تدبير الأزمة ، وعجزت عن الاحتواء السريع للجائحة؟
2-لماذا غاب التضامن الدولي؟ وهو سؤال مستأنف لسلسلة الأسئلة التي طرحها العقل البشري عبر التاريخ حول معنى الإنسانية، ومعنى الوجود الإنساني، وعن جدوى العلاقات بين البشر في ظل انعدام الروح الجماعية وانفلات دائرة التآزر. كما أعاد مراجعة ثنائية مفهوم الخير والشرّ، وأسباب تخلي الغرب عن القيّم التي بشّرت بها الأديان، وأفرزها عصر الأنوار، وكيف السبيل للرجوع للرشد وتصحيح المسارات الخاطئة للبشرية؟
السؤالان معا يشيان بأن ردّ فعل تحوّلي قادم لا محالة. وإذا كان من غير المتوقع أن يحدث هذا التحول بضربة ساحر، فإن خطوطه الأولية بدأت في التشكّل، فكيف يمكن توقّع المشهد المرتقب؟
تصبّ معظم التوقعات لعالم ما بعد كورونا في أن الولايات المتحدة ستفقد موطأ قدم في الزعامة العالمية بسبب الرجّة التي أحدثها وباء كورونا في النظام العالمي. ولم يكن من باب الصدفة في هذا السياق أن يستخلص شيخ الدبلوماسية الأمريكية هنري كيسنجر، وهو الرجل الخبير المحنك، الذي مخر عباب السياسية العالمية وقرأ بإمعان مستقبلها أن (( عالم ما بعد كورونا لن يكون مثل ما قبل كورونا)). ولم يكن غريبا كذلك ان يخرج عالم الاجتماع الفرنسي “ألان توران” عن صمته الذي فرضه عليه ثقل السنين والهدوء العلمي ، ليصرّح تعقيبا على تداعيات كورونا بالقول: (( لقد انسحبت الولايات المتحدة من لعب دور زعيم العالم )). ولم يبتعد الرئيس الفرنسي ماكرون ذاته عن هذا المنحى حين تنبأ في قمة السبع المنعقدة بفرنسا في 24 غشت 2019 بتراجع الهيمنة الغربية لفائدة القوة الشرقية. وحتى أصوات النشار التي تعاكس احتمال الانحسار الأمريكي، فإنها ما فتئت تدعو إلى مراجعة مفهوم القوة والزعامة انطلاقا من التغيرات التي تشهدها بنية المجتمع الدولي، وهو ما عبّر عنه بتفصيل جوزي.إس ف نايJoseph.S.Nye في كتابه “مستقبل القوة”، مما يشي بضرورة إعادة النظر في زعامة جديدة تكسر منظومة الأحادية القطبية القائمة على القوة العسكرية التي أثبتت فشلها في بناء نظام عالمي مستقر، والاتجاه رأسا نحو البحث عن نظام بديل نعتقد أنه سيكون متقاسما، أو على الأقل ستشارك في توجيه دفّته الزعامات الشرقية والقوى الاقتصادية الناعمة مثل الصين، تايوان، ماليزيا، سنغفورة وكوريا الجنوبية والهند، فضلا عن القوى التقليدية كاليابان، وما في نظيرتها من دول الشرق الأنيقة التي أثبتت كفاءتها في تدبير الأزمات، وضمنها أزمة كوروناـ
ويبدو أن آسيا في ظل الاقتصاد العصري المؤسس على تطوير البنية التحتية وسلاسل التوريد والمدن الضخمة، والتكنولوجيا وموارد الاتصال، قد بدأت في تحقيق قفزة نوعية من حيث التخطيط لشبكات السكك الحديدية الفائقة السرعة للربط بين المدن الآسيوية، مما ساهم في تسويق مواردها الزراعية ومخرجاتها الصناعية، ونجحت في تجميع سلسلة المدن الضخمة الآسيوية في فضاء حضاري أنيق نعته “باراج خانا” بالسلام الآسيوي” Pax Asiana. غير أن الصين تشكل قطب الرحى في هذه الزعامة الاقتصادية الشرقية الجديدة في تقديري. لماذا الصين؟
يتأسس تفسيري لذلك على ثلاثة معطيات تشكل اليوم المطالب الأساسية للبشرية وهي: الأمن الصحي الذي كلما انعدم اهتز استقرار المجتمع، ودبّ فيه الخوف والهلع، والبحث العلمي الذي يخدم البشرية، ثم الإنتاج الاقتصادي القليل التكلفة الذي يحصّن حاجيات الإنسان الضرورية وأمنه الغذائي.
1-بخصوص الأمن الصحي، يبدو – وأنا بصدد الدفاع عن أطروحتي القائمة على تأثير الأوبئة في سقوط حضارات وصعود حضارات أخرى- أن الصين تعدّ ولو مؤقتا الجواد الرابح في الحرب الكونية ضد كورونا، بما أثبتته من دور مرموق في مكافحة الوباء، وإدارة محكمة في تدبير المعالجة والتصرف، وتضييق الخناق عليه، حتى أن المدينة التي ظهر فيها ” ووهان” عادت لحياتها الطبيعية، ودبّت الحياة في شرايين المجتمع الصيني من جديد. وجاءت زيارة الرئيس الصيني لها مباشرة بعد انحسار الوباء، حدثا محمّلا برسائل بليغة للعالم، وبدلالات عميقة على مناعة الصين، وقوة منظومتها الصحية نسبيا وجاهزيتها للزعامة. ولم تكتف بذلك، بل زادت من تلميع صورتها “القيادية” من خلال تقديم المساعدات للدول المتضررة من انتشار وباء كورونا بما في ذلك الولايات المتحدة ذاتها، فكسبت أيضا معركة التضامن العالمي، وساهمت بذلك بنصيب في التخفيف من تخوفات العالم ، وإظهار نفسها في صورة البطل المنقذ، مما يحيل على جدارتها في التربّع على عرش الزعامة العالمية.
2- على مستوى البحث العلمي: لا تزال المختبرات الصينية منكبّة ليل نهار على إنتاج لقاح يهدئ من روع العالم، ويقضي نهائيا على فيروس كورورنا العدو المشترك للإنسانية. هذا دون إغفال تصدّر الصين للائحة براءات الاختراع العلمي؛ مصداق ذلك ما ذكرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 7 أبريل 2020 أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة في عدد براءات الاختراع لأول مرة منذ سنة 1978. وهذا الصعود السريع للصين، يؤكد تحوّل بوصلة مركز الابتكارات العلمية نحو الشرق.
3-أما على المستوى الاقتصادي الذي يتيح لها الأخذ بناصية الزعامة، فقد حققت الصين المعجزة الاقتصادية كما يشهد بذاك انتقالها من المركز السادس دوليا بناتج كان يقدر ب1.6 ترليون دولار سنة 2003، إلى المركز الثاني بعد الولايات المتحدة بناتج 14 مليون دولار. وتشير مؤسسة كولدمان ساكس” في هذا الاتجاه أن الاقتصاد الصيني سيحتل المرتبة الأولى في أفق سنة 2027 ، مع محاولة إقامة نظام مالي بديل يقزّم سلطة الدولار، ويقلّص من هيمنته على شرايين الاقتصاد العالمي.
وحسب توقعات بعض الخبراء، فثمة إمكانية تعويض عملتي الدولار والأورو بعملة عالمية جديدة تتماشى مع المنهج الاقتصادي الجديد الذي ستقوده الصين مستقبلا.
ويبدو أن الصين فطنت إلى ما عرفته شبكة الحضارات العالمية من تغيرات تحت تأثير الجغرافيا الاتصالية التي عوّضت مفهوم الحدود والدول، بمدى فعالية شبكة المواصلات وخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي، وكابلات الإنترنت وتقنيات الاتصال؛ وتمكّنت في هذا الصدد من تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يسعى بالتعاون مع منظمات أخرى إلى إنشاء شبكة طريق الحرير الذي من المنتظر أن يمتدّ من شانغهاي الصينية إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، ويكرّس تمدّد التنين الصيني.
حدثت هذه اليقظة الاقتصادية الصينية في وقت بدأ العالم يشهد تحولا في طبيعة الاقتصاد المعولم الذي تتابعت أزماته ولحقت به دورات من الركود، لعلّ أهمها أزمة 2008، والأزمة الحالية. ويرى المتخصصون أن العالم بدأ يلج مرحلة الكساد العظيم، وأن الأسوأ على الأعتاب، مما يندر بعواقب وتداعيات اقتصادية خطيرة، بدأت ملامحها من خلال تأكيد صندوق النقد الدولي أن النتائج المترتبة عن وباء كوفيد المستجد ستكون أفظع كارثة اقتصادية عرفها التاريخ منذ سنة 1929، وأن أكثر من 170 دولة ممن الدول الأعضاء في الصندوق ستشهد انكماشا في الدخل الفردي.
وفي داخل هذا المشهد الكارثي للاقتصاد العالمي، اتضح لدى الخبراء الاقتصاديين من خلال متابعة ومراقبة المستجدات التي أحدثتها جائحة كورونا التي انتشرت في الصين خلال المرحلة الأولى، أن التوقف الجزئي للصناعة الصينية، أحدث شرخا في الاقتصاد العالمى، بحكم أن النصيب الأوفر من متطلبات السوق العالمية يأتى من الصين، مما شكّل ثغرة لم تتمكن أي دولة من سدّها.
ومما زاد الطين بلّة في ظل هذا الاقتصاد العالمي المتدهور، ظهور مؤشرات تنطق بوجود حرب باردة بين أمريكا والصين لم تسكتها وخزة فيروس كورونا. فاتباع استراتيجية أمريكية عقابية تجاه الصين قبيل جائحة كورونا بفرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار، وردّ الصين عليها بإجراءات مماثلة على منتجات أمريكية، عكست الوضع الاقتصادي المتردي.
وجاء وباء كورونا ليصبّ الزيت على النار، وتجلت مشاهد هذه الحرب الأمريكية- الصينية في التلاسن والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وصلت إلى حدّ وصف الرئيس ترامب فيروس كورونا بأنه “فيروس صيني”؛ ونصّب نفسه هذه الأيام خلال الندوات الصحفية شبه اليومية التي يعقدها قائد حرب ضد عدوين: فيروس كورونا والصين التي حمّلها المسؤولة عن تفشيه، والدعوة لمحاسبتها دوليا. كما لم تتوان الصين عن رد الصاع بصاعين، من خلال كيل التهم لأمريكا بأنها المسؤولة عن تصنيع الفيروس في أفغانستان. ولعلّ التقرير الذي أورته صحيفة “نيويورك تايمز”، يبيّن مدى هذا الصراع “الكوروني” الذي يضمر وراءه حربا اقتصادية، منها تصريح المستشار الاستراتيجي السابق لإدارة ترامب، ستيف بانون، أكّد فيه (( أننا في خضم حرب اقتصادية ساخنة )). وتعكس هذه الاتهامات المتبادلة صراعا على كرسي الزعامة العالمية، إذ أن كل طرف يروم من خلال اتهاماته الاستمرار في الزعامة، أو احتلال موقع إلى جانب الزعيم، أو إبعاد المنافس على الزعامة.
غير أن الصين أتقنت فنّ العوم في هذا البحر الهائج، وخرجت من محنتها الوبائية بأقل الخسائر. وفي ذات الوقت نجحت في الهيمنة على الشركات الأمريكية التي انسحبت من الصين بعد ظهور الوباء، فاشترت الأسهم التجارية، واستفردت بعائدات الأرباح، لتعوض الخسائر المادية التي تكبدتها خلال الجائحة، بل حولت هذه الخسائر إلى مكاسب اقتصادية بفضل حاجة الأسواق العالمية الملحّة للبضائع الصينية. وبعيد انحسار الوباء، تضاعف الإنتاج الصناعي الطبي للصين عشر مرات، وغدت المصانع تصل الليل بالنهار في إنتاج أجهزة التنفس والمضادات الحيوية، في الوقت الذي لم تستطع أمريكا توفير هذه الأجهزة، لا بسبب قلة اليد، بل برغبة مقصودة، وهو ما تؤكده المعطيات التي أثبتت أن إدارة ترامب لم تعمل بتوصيات مخابراتها التي تنبأت منذ مطلع يناير بأن أمريكا توجد في مربع الخطر الوبائي.
فضلا عن ذلك، اثبتت الصين ذكاء سياسيا في التواصل مع دول العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، والظهور بخمار إنساني من خلال تقديم المساعدات الطبية للبلدان المتضررة من وباء كورونا المستجد. ففي الوقت الذي أدارت أمريكا ظهرها لدول الاتحاد الأوروبي، تاركة إياها تترنح تحت ضربات الوباء، كانت الطائرات الصينية تشقّ الأجواء الدولية، محمّلة بالأجهزة والأطر الطبية، مدعمة هذا الدور الدولي بدعاية مكثفة مررتها عبر الوسائط التكنولوجية، لتقدم نفسها كمحور أساسي في نقل المعطيات والتجارب الصينية حول مكافحة وباء كوفيد 19.
هذا الحضور المكثف للصين في كيان العالم المعولم، سيكون له انعكاسات لا على المستوى الجيو- سياسي ودورها العالمي فحسب، بل في انخفاض منسوب ثقة الرأي العام في كفاءة القيادة الأمريكية، والتشكيك في قدرتها على مواجهة فيروس كورونا، وهزالة مخزونها الاستراتيجي من الإمدادات الطبية، مما خلخل صورتها القيادية. كما قزّمت بتلك المساعدات هيبة المؤسسات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي، بل حتى المؤسسات الأممية التي فقدت الشعوب الثقة فيها بسبب عجزها، مقابل لمعان صورة الصين كقوة اقتصادية قادرة على تدبير الأزمات الوبائية كما اشار إلى ذلك كاتبا مقال نشرته مجلة Foreign Affairs” .
ومع كل هذه المؤشرات التي تدّل على أن الصين مهيأة للقيام بدور القيادة العالمية، لا يبدو أنها تطمح في منصب الزعامة العالمية كما يؤكد ذلك الخبراء. وبحكم أن الولايات المتحدة غير مستعدة في المدى القريب على الأقل على التنازل عن قيادتها للعالم، فهي ستسعى لتصعيد حربها الاقتصادية مع الصين، لا بهدف اقتلاع أضراسها العصية، بل لفرض شروطها عليها، ( كما يتجلى ذلك من تصريحات ترامب المضمرة). لذلك فالسيناريو المحتمل بعد الحرب ( المحدودة) أن يكون المتفاوضان الكبيران هما من يقود سفينة العالم، بعد أن اقتنعت أمريكا أن العولمة أصبحت تترهل وتتآكل تحت ضربات المنظومة الصحية التي تديرها الشركات الرأسمالية بطريقة لا أخلاقية، وأن الحركات الاحتجاجية تقض مضجعها، وبالتالي يمكن أن تتعاون مع الصين ومع بعض القوى الاقتصادية الأخرى الصاعدة في الشرق لإعادة ترتيب نظام عالمي جديد أكثر توازنا، وربما أكثر عقلانية. لكن المفارقة الكبيرة هي كيف يمكن التوليف بين نظام ليبرالي ديموقراطي ونظام حزبي شمولي تتبناه الصين؟ هل يمكن الالتقاء بين الماء والنار؟
من بين الآراء التي جذبتني في هذه ” النازلة الاستفهامية”، الرأي الذي عبّر عنه عالم الاجتماع الفرنسي ألان توران حين قال:(( الآن ربما سنعيش في عالم صيني))، قبل أن يضيف:(( تريد الصين ممارسة الشمولية الماوية من أجل تدبير عالم رأسمالي))، ولكنه اعتبر هذا السيناريو ” انتقالا وحشيا” لم يكن معدّا، ولا مفكرا فيه. هذا استنتاج صحيح، لكن ما ينبغي استحضاره في هذا الصدد أن الصين لا تشكل اللاعب الخصم الفريد الذي تتبارى معه الولايات المتحدة، بل ثمة منظومة الدول الشرقية الآسيوية الأخرى التي تعاكس التفرد الأمريكي بالزعامة، مع أن أنظمتها مختلفة عن الصين، مما قد يدفع نحو مربع التوافق. ومن جهة أخرى إذا تجنّبت القوتان تسييس القضايا الحاسمة مثل قضية كورونا، والتنافس الاقتصادي المفتقر إلى القواعد الأخلاقية، يمكن توليد نظام عالمي يتسم بالتعقل الذي يتجاوز المواقف الحدية، ويكون جوهره الإنسان، نظام يمتح من المبادئ الأنوارية للنظام الرأسمالي كالحرية والديموقراطية، ومن مبادئ النظام الاشتراكي القائم على حق الإنسان في الطعام والصحة دون تمييز طبقي، وتطعيمه بمبادئ الأديان الروحية والأخلاقية القائمة على العدالة، وعلى مبدأ التداول الحضاري، وتسخير العلم لخدمة الإنسان كما هو واضح في النص القرآني، بهدف العبور نحو حقبة أخرى تتسم بنزعة إنسية، يتم فيها إعادة توزيع الثروات، ورسم خريطة طريق لتنظيم استغلالها والتصرف فيها بحكمة وأداء حضاري راق، بعيدا عن الإسراف والترف.
يبدو أن العالم في هذه اللحظة المفصلية في مسيس الحاجة إلى تحبيك خيوط نظامه، وإدارة جيدة تجعل من التعاون الدولي المشترك حجر الزاوية التي يتأسس عليها، نظام يتسم بالمصداقية والقدرة علي الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث، خاصة كوارث الأوبئة. نظام يتأسس على اقتصاد غير موجه للاستهلاك والرفاه فحسب، بل يسير على هدي قاعدة الإنفاق بقدر الحاجة، أو حسب الحاجيات الأساسية للإنسان وبأقل تكلفة لكي يعيش الفقراء، وهذا ما يتيحه الاقتصاد الصيني القليل التكلفة، المنخفض السعر. فما أحوج العالم اليوم إلى نظام ينظر إلى الحياة والإنسان والبيئة برحمة ورفق، وفق منطلق كوني يجنح به نحو غايات أسمى وأرقى.
ومع أن هذا التحول المرتقب يبدو مثاليا على المدى القصير على الأقل، لكن في ظرفية الأزمة العالمية الحالية، وما خلفه وباء كورونا من فضح لأخلاقية النظام العولمي، ومتاجرته بصحة البشر، والإخلال بحقهم في الوجود، تبقى كل السيناريوهات محتملة. ربما تكون هذه التوليفة بين الغرب المتراجع، والشرق الصاعد، في سياق منظومة تعاونية وتكاملية، بعيدا عن أي تنافس محموم أو صراع، هو ما عبّر عنه كيسنجر في مقال له بصحيفة “وول ستريت جورنال” حين انتقد بشدة التعامل الأحادي لكل دولة من دول العالم في مواجهة فيروس كورونا، وأوصى بضرورة إيجاد “برنامج لتعاون دولي”. ولبلوغ ذلك يكفي تعديل المنهج الاقتصادي العولمي، القائم على الجشع والنهب وحصار الشعوب وتجويعها، ومراجعة القانون الدولي، وتعديل بعض بنوده المتعلقة بالأمن الصحي العالمي، وتكثيف التعاون في مجالين أساسيين:
أولهما مجال البحث العلمي، وخاصة العلوم الصحية بهدف تأمين صحة الإنسان التي غدت بعد كورونا تتسنم سلّم الأولويات، وهذا ما يبشّر به مشهد الرئيس الفرنسي وهو يسارع الخطى من باريس إلى مارسيليا ليجلس مصغيا باحترام للطبيب “راؤول”، ويستلهم منه الدرس حول دواء الكلوروكين، وكذا مشهد ترمب هذه الأيام محاطا بخبراء أثناء عقد ندواته الصحفية، على رأسهم طبيب علم الأوبئة. فالحقبة التاريخية الجديدة صارت تملي ضرورة إصغاء الحكام للعلماء، أو على الأقل كما قال الفيلسوف الألماني هابرماس في مقابلة له مع جريدة لوموند الفرنسية يوم 10 أبريل الجاري أن على الحكام(( اتخاذ قرارات بوعي واضح بحدود معرفة علماء الفيروسات الذين يقدمون لهم المشورة)).
أما المجال الثاني فهو مجال الأخلاق، أي أخلقة مجال البحث العلمي والطبي ذاته، وتطهير العلوم من المافيات المتاجرة بأرواح البشر، وجعله تحت توجيه النخب العالمة التي تراعي كرامة الإنسان وتحرص على حق الأرض والبيئة في العيش في طهرانية.
وإذا أردنا الاستفادة من دروس ماضي البشرية الطويل أو ماضي الغرب القريب، أو تجارب دول الشرق الصاعدة للخروج من حالة الانسداد، وتأسيس حقبة تاريخية جديدة لعالم راشد، وحضارة بشرية ناضجة، فإننا نستنتج أن البقاء سيبقى للأمم والحضارات التي تطور هذين المجالين، وتسييجهما بسياج سميك من العدالة والمساواة.
على سبيل الختم:
قد يعترض معترض أن حدث كورونا لم ينضج بعد، وبالتالي ينبغي التسلح بالاحتراز والتأني وعدم الوقوع في القراءات المتسرعة. كما قد يقول البعض أن هذه الكارثة التي حلت بالبشرية مجرد أزمة عابرة ستنقشع بعد حين، وستسترجع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عافيتهما، وتعود الأمور إلى طبيعتها، ويعود النظام العالمي بخريطته الجيو- سياسية كما كانت تحت الهيمنة الأمريكية. وهذا في تقديري هو السناريو الأسهل الذي لا يجعل أي مفكر يتعب قلمه للتفكير في مصير عالم ما بعد كورونا أو حتى القبول المبدئي بأن حقبة تاريخية جديدة ستتشكل. لكننا على عكس هذا المجرى، حاولنا من خلال الحلقات الثلاث تقديم الاحتمالات الممكنة تأسيسا على معطيات بارزة اتضحت حتى قبل جائحة كورونا، ولم تقم هذه الأخيرة سوى بالتسريع بها، وهو ما سعينا أيضا إلى تدعيمه انطلاقا من بناء سؤال الوباء في التاريخ، وما يفرزه من تغيّرات في الأنظمة وتداول الحضارات، وما يرتبط بذلك من أسئلة الراهن لاستبصار ما يلوح في المنظور الاستشرافي للعالم، من خلال رسم الخطوط الأولية لمجموعة من المؤشرات التي تجعله ينحو نحو حقبة تاريخية جديدة، يصبح فبها التفرد الأمريكي يعيش لحظات خريفه. صحيح أن القضاء على فيروس كورونا سينتهي يوما ما، لكن – وهذا هو الأهم – فإن تداعياته التي قد تستغرق عقودا، ستؤدي في النهاية إلى التحولات التي تصدينا لمعالجتها، وستعيشها الأجيال القادمة. أستشهد هنا بفحوى ما حبّره كيسنجر في صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الانعكاسات الوخيمة التي خلفها وباء كورونا في المجال الصحي قد تكون مؤقتة، إلا أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية المتمخّضة عنها ستستمر لأجيال متتالية ، وهي إشارة مضمرة إلى ما سيعرفه نظام العولمة من شروخات وتناقضات ستشكل وقودا لحزمة من التحولات، ليدخل العالم في حقبة تاريخية جديدة من غير المنتظر أن تكون على المدى الراهني، بل ستمتد على مدى عقود، وسيكون للشرق نصيبه في هذه التحولات بناء على القرائن التي حاججنا بها، ووفقا لقانون التداول الحضاري كما علمنا التاريخ.
* إعداد: إبراهيم القادري بوتشيش أستاذ التاريخ الوسيط الإسلامي بجامعة مولاي إسماعيل في مكناس





تعليقات الزوار
الحرب العالمية الثانية التي كانت أشد هولا من فسحة كورونا. هذه الحرب غيرت كل الأنظمة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية .رغم ذلك لم تغير العقليات الاستعمارية، فقد تحركت الجيوش الاستعمارية لإعادة السيطرة على المستعمرات متناسين أن أبناء المستعمرات ساهموا في تحرير أوروبا من النازية. نفس الشئ سيحصل بعد كورونا. ستعود السلطة المستبدة لإعادة السيطرة على الميادين، و الشركات للسيطرة على الأسواق، و الفئات المهيمنة للسيطرة على المواقع. وسوف تتكلف الشعوب بتسديد فاتورات الخسائر. وإذا كان التغيير الذي تتحدث عنه سيحدث بعد قرون فما زلنا في العصور الحجرية