الــبــهــائــيـة:

أثناء العدوان الأمريكي/الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ظهرت أخبار عن مجموعة من الجواسيس ينتمون في أغلبهم للطائفة البهائية، ومن المعروف أن هذه الفئة لا تشكل أي وزن في إيران إلا أنها في عهد شاه إيران كانت مقربة لنظام الشاه، حتى أن عباس هويدا كان رئيسا للوزراء لمدة طويلة في عهد الشاه، وقد حُوكم عباس هويدا وأعدم في سنة 1979، فما هي الطائفة البهائية هذه؟
لم يعد للبابية وجود فعلي فقد انتهت منذ زمن، لكنها تطورت إلى ما يسمى البهائية التي تعرف حاليا وجودا في بعض مناطق العالم، ولها محافل في بعض دول العالم، خاصة في الهند وفلسطين المحتلة. وتعود البابية إلى شخص يدعى الشيرازي نسبة إلى مدينة شيراز الإيرانية عاش في القرن 19م. وحسب بعض الدراسات التي كتبت عنه فهو ليس إيرانيا بل عراقي اسمه علي محمد الباب، انتسب في البداية إلى زاوية تدعى”الشيخية” وتنسب إلى شخص يدعى أحمد الأحسائي فلم يقتنع بها، وانتقل إلى شيراز حيث حضر دروس شخص يدعى كاظم الشيرازي، فانتسب إليه وهو الذي أوهمه أنه صاحب كرامة. ولم يلبث أن ابتدع عقيدة جديدة (بعد أن أصيب بعارض صحي) وصار يردد «أنا مدينة العلم وعلي بابها»، ولاشك أن اسمه علي محمد لعب دورا في ادعائه النبوة، والانتساب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد جرت محاكمته واعترف بأنه يكذب وأعلن التوبة. ويبدو أن الاستعمار الإنجليزي و السفارة الروسية في طهران لعبتا دورا هاما في تشجيعه، وإعلان نفسه نبيا. وقد وضع كتابا بعنوان “البيان” امتلأ بالشطحات، وقد أعدم في 1850م هو وأحد أتباعه. عاش علي محمد في مرحلة هجوم الغرب على الشرق وعلى ديار الإسلام. وكانت العديد من الدراسات الاستشراقية قد دعت إلى وجوب تدمير الإسلام عبر اختلاق عقائد جديدة مثل البابية و القاديانية. وكان علي محمد أحد تجليات هذه الأفكار الاستشراقية، التي رأت أنه لتدمير المجتمعات الإسلامية يجب تدمير العقيدة واللغة. وبوفاة الباب انتهت البابية، لكن أحد تلاميذه يدعي الميرزا حسين تبنى ما جاء فيها وحولها إلى عقيدة أخرى، وألغى شخص وعقيدة علي الباب محمد، ونصب نفسه إلها وأورث الألوهية لابنه. وقد تبنت بريطانيا أصحاب هذه العقيدة، وفيما بعد الكيان الصهيوني ومنحوهم أرضا في مدينة عكا بفلسطين المحتلة، حيث أسس مركز للدعاية لهذه الديانة، التي جعلت اليهودية على رأس عقائدها مع الإضافات التي أضافها هذا الداعي. بعد إعدام الباب في 1850م، ادعى أتباعه أنه رفع إلى السماء! وقيل إن جثمانه أخذ فيما بعد إلى عكا حيث دفن بعد أن أخفيت جثته في إيران لسنوات عديدة تربو على الخمسين، وكل ذلك مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة. وبعد موت الباب الميرزا الحسين 1817-1892م، جاء ابنه عبد البهاء الذي تصارع مع أخيه صبح الأزل على الزعامة فانتصر عليه، وبرغم أن البهائية عرفت انشقاقات عديدة، فقد انتقل عبد البهاء إلى بغداد ومناطق أخرى، وتدخل السفير الروسي في طهران لصالحه، بعد أن كاد يعدم بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال شاه إيران. وقد كلف هذا السفير أو المترجم بالسفارة الروسية عند البعض واسمه «كتياز غوركي» من طرف عبد البهاء مع آخرين لوضع دستور البهائية، الذي يشترك مع الماسونية في عدة أهداف منها أن لا عقيدة تمنع الانخراط فيهما، والواقع أن العضو يتحول بعد مراحل عدة إلى شخص لا يؤمن بشيء إلا بالبهاء. ويعتقد عبد البهاء أنه كليم الله، وأنه قام برحلة إلى السماء وكلف بعدة مهام، ثم تجاوز هذه المرحلة بعد مدة وادعى أنه هو الله، وقد خاطب ابنه في إحدى الرسائل التي وجهها إليه، قائلا: من الله الخبير إلى الله الحكيم.
لقد جمعت البهائية أموالا طائلة من المساعدات التي قدمت لها من الإنجليز، ومن الوظائف العديدة التي منحت لأعضائها، مما جعلها مطمعا للعديد من ضعاف النفوس الذين باعوا أنفسهم بالمال أو الوظيفة. وقد ساعدت الحركة اليهودية هذه النحلة وقدمت لها المآوي والأموال في عكا، حيث دفن البهاء أو الميرزا الحسين بعد موته، ولازالوا يوزعون أسطواناته وخطبه المسجلة. ولهذه النحلة أتباع في مصر وتونس و المغرب وإن كانوا قلة، فعددهم في المغرب لا يتعدى 400 حسب تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، وتحميهم واشنطن والدول الغربية ويعمل عدد منهم في سفارات وقنصليات هذه البلدان، أو مؤسساتها بدعوى حماية الحرية الدينية، وذلك لابتزاز البلدان في قضاياها الوطنية. والعضوية في البهائية تستلزم المرور من تسع مراحل، تبدأ بأن البهائية لا تختلف مع الإسلام وتنتهي بأن يصبح العضو مؤمنا بأن البهاء هو الإله. وكل محفل يسيره تسعة أعضاء، والمحفل المركزي يوجد في عكا، وقد تحولت البهائية إلى تنظيم مغلق تقريبا مثل الماسونية. وشيدت مبنى في دلهي، نقلا عن دار الأوبرا في سدني، وتعتقد أن أجنحته لها طابع إيحائي ماورائي، في حين أن الأمر يتعلق ببناء ليس إلا، لأن البهائية تتميز بالكذب والخداع.
تقدس البهائية رقم 9 و 19، وتمارس عبادة ثلاثية في الصباح والظهيرة والمساء…ومن خلال استقراء تاريخ البهائية، فهي نتيجة العقائد الوثنية والمسيحية، وفكرة المهدي المنتظر والتقمص الهندوسي الذي يؤمن بالتناسخ، وكون الإله يتجسد في مراحل معينة في الإنسان. وقد حاولت البهائية مع البابية -في بدايتها- أن تتقمص مظاهر إسلامية، ولكن بعد أن خرجت إلى أحضان اليهود والهندوس تحولت إلى طائفة لا علاقة لها بالإسلام حتى في رمزيته، فقد أخذت البهائية فكرتها من عقائد عدة في سبيل إرضاء و استقطاب أي شخص من أي عقيدة كان.
وعندما مات البهاء في 1892م، عين ابنه عبد البهاء ليتولى إمارة الطائفة باعتباره إلها (وفق قاعدة: “من الله العزيز الحكيم إلى الله اللطيف الخبير”)، رغم الخلاف بينه وبين أحد إخوته على الزعامة. وكان اسمه أثناء ولادته في 1844م عباس أفندي، وقد أعلن أن كل الأديان متساوية وحصل على لقب “ابي يهوه” من اليهود، ولقب فارس من بريطانيا، وقبل وفاته في 1921م، عين حفيدا له من ابنته “نيا” يسمى شوقي أفندي، الذي مات في ظروف غامضة فانتقل تسيير الطائفة إلى محفل يتشكل من تسعة أعضاء يسيرون الطائفة التي تضم بضعة آلاف من المنتسبين في أنحاء العالم والتي تستخدم في إطار الترويج للفتنة، وتدمير الوطن العربي و الإسلامي، كما تستعمل غيرها من المنظمات والطوائف تحت ذريعة حقوق الإنسان وحرية الاعتقاد وغيرها من الادعاءات التي لا مجال هنا لمناقشتها.
رأي الإسلام في البهائية:
أجمع علماء الإسلام على كون نحلة البهائية كفرا، والبهائيين كفارا، لا يجوز معاشرتهم، أو الزواج منهم، أو الانتساب إليهم، وأن الأمر يتعلق بمحاولات المستشرقين وأجهزة المخابرات وطلائع الاستعمار تدمير اللحمة الإسلامية، وذلك باختراع وتشجيع الهرطقات في كل أنحاء العالم الإسلامي.
الدروز أو الموحدون:
لا يقبل الدروز هذه التسمية، لأنها مرتبطة بشخص “دراز” ليس له أهمية في عقيدتهم وإنما اتهموا به، وهذا الشخص هو نشتكين محمد بن إسماعيل، وهو غير محمد بن إسماعيل حفيد جعفر الصادق كما هو واضح، وقد يكون الاسم مجرد تزوير و ادعاء لخلق البلبلة، فهم يقولون إنهم موحدون أي من معتقدي التوحيد الإلهي.
يعود ظهور طائفة الدروز، إلى محاولة قام بها شخص يدعى -كما سبق- نشتكين في أحد مساجد القاهرة، عندما اعتلى المنبر في حوالي عام 1016م، وأعلن أن الله تجسد في الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، وقد هم المصلون بقتله لكنه هرب إلى قصر الخليفة مستنجدا. وقد يكون هو الذي أمره بذلك. وهناك روايتان حول مصيره، الأولى: أن نشتكين عندما فر من المسجد إلى القصر، تم قتله بأمر من الحاكم لإيقاف الغضب الذي ثار نتيجة خطبته وادعائه ألوهية الحاكم.
الثانية: أن الحاكم زوده بالمال، وأمره بالذهاب إلى الشام لنشر الدعوى، وفيما بعد قتل على يد حمزة بن علي، المؤسس الحقيقي لأفكار الدروز أو الموحدين، لأنه رفض رئاسة حمزة. ويبدو أن الحكاية الأولى هي الأقرب إلى الصواب، لأن حمزة هذا عندما ذهب إلى الشام في 1020م، قتل شخصا آخر نافسه على الرئاسة غير نشتكين، الذي لم يبق له أثر سوى أن الجماعة أصبحت تسمى بمهنته وباسمه، رغم رفضهم الدائم لهذه التسمية، لكن العادة غلبت كما يقال.
يزعم الدروز أن الكون مر بسبعين مرحلة، وأن الإله ظهر وسيظهر في إحدى عشرة مرة بهيئة بشرية، لكن التجسيد يكون شبحيا. فقد تجسد الإله -في رأيهم- في إله الهنود كريشنا وأرسطو والحاكم بأمر الله، وباختفاء هذا الأخير تم اكتمال العقيدة لمن دخلها سابقا فقط. وكما تجسد الإله في شخصيات معينة عبر التاريخ، فإن حمزة مؤسس العقيدة، تجسد هو الآخر عبر التاريخ في هيئة المسيح عيسى وفي هيئة سلمان الفارسي. وهناك خمسة أشخاص يحضون بالتقديس عند الدروز: حمزة بن علي، الذي يمثل العقل، ومقداد الأسود الذي يمثل النفس، ومحمد بن وهب يمثل الكلمة، وبهاء الدين يمثل العلم، والألوهية يمثلها أحد وزراء الحاكم بأمر الله المسمى سلامة، وهو شخص غامض، ويظهر أنه هو من أوحى للحاكم بأنه إله. ومن الواضح أن العقيدة الإسماعيلية ثم نسخها من جديد أو جزء منها مع تغيير في الأشخاص والأفكار بالنسبة للدروز ومراتب الشخصيات. ويزعم الدروز أن الدنيا تعيش الزمن ما قبل الأخير، وأن الإله سيظهر لآخر مرة في الزمن النهائي في هيئة بشرية، وأن الشرق الأقصى سيتحد مع الشرق في بلاد العرب، وتبدأ رحلة الجميع نحو مدينة هجر في البحرين، ثم إلى مكة ثم إلى القدس. وسيُسمح للجميع بأن يكون درزيا أو موحدا، وسيتحول الجميع إلى تجسيداتهم السابقة، خصوصا المتميزين بالعدل والطيبوبة – دون تحديد لمعناه قد يكون القصد الدين اعتنقوا الدرزية- الذين سيعيشون في سعادة. أما الأشرار -دون تحديد وقد يكونون الذين أنكروا الدرزية- فسيتعرضون للعقاب الذي مابعده عقاب.
فشلت الدعوى الدرزية في استقطاب الجماهير الإسلامية، باستثناء قلة ضئيلة تتوزع الآن بين لبنان وفلسطين المحتلة. ورغم أن الدروز طائفة لا تؤمن بالإسلام، فإن بعض أعضاءها حاولوا أن يظهروا الإيمان للحفاظ على المظاهر الإسلامية، وتفاديا للرفض العام وأشهرهم في هذا الباب: شكيب أرسلان المتوفي عام 1946. ومن الملاحظ أنه عندما أُنشئ الكيان الصهيوني منع العرب المسلمين والمسيحيين من الانخراط في الجيش والأجهزة الأمنية، بينما أوجب الخدمة العسكرية على الدروز، الذين استخدموا في ميادين التجسس نظرا للغتهم و أصلهم، ومن أشهرهم عزام العزام. ونظرا للخلفية الهندوسية كانت المعابد أو الأشرم متعبدا لهم في الهند. وكان كمال جنبلاط يقضي شهرين كل سنة في معبد هندوسي للتأمل، ولا يمارس الدروز أي فريضة، ولا يقومون بأي واجب ديني إسلامي، إلا أنهم يدعون الإسلام إذا سئلوا. وينقسمون إلى: عقال، وهم الذين درسوا أصول العقيدة، ويشرفون على المتنسكين الذين زهدوا في الدنيا وعلى الأجاويد وعلمهم قليل. ثم الطبقة العريضة المسماة جُهالا، وهم الذين لا مسؤولية لهم ولا واجب عليهم ولا فهم لهم بأمور العقيدة باستثناء أنهم منتمون للطائفة التي تؤمن بالحاكم بأمر الله الذي سيعود يوما. ولو رجعنا إلى الطبقات في العقيدة الهندوسية لوجدناها تتألف من أربع طبقات: البراهما وهم رجال الدين، و الشيسترا و الفزيا و الشودرا بنفس التراتبية مع الدروز، مع اختلاف الظروف الذي فرضتها الجغرافيا و الخلفيات الدينية.
يتواجد الدروز أساسا في لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة، وينتشر بضع مئات منهم في مختلف أنحاء العالم وعددهم الإجمالي حوالي 300 ألف نسمة ، وهم لا يبشرون بعقيدتهم ولا يصاهرون غيرهم بصفة عامة، وهم في السبيل نحو الانقراض أشبه بالطائفة الزراديشتية في الهند، التي هاجرت في القرن السادس الميلادي من إيران وهي طائفة ثرية ومغلقة. وقد تناقص عددهما إلى حوالي 140 ألف نسمة.
النصيرية:
النصيريون مثل الدروز، يرفضون هذه التسمية التي ارتبطت بشخص المؤسس نصير بن محمد. وقد أطلقوا على أنفسهم العلويين ليس نسبا، وإنما انتماءا. ويبدو أن هذه التسمية ليست قديمة جدا، فهي تعود لبداية الحروب الصليبية في القرن الثاني عشر وبداية الاستشراق، حيث ثم التعرف عليهم من طرف الصليبين وطلائعهم المستشرقين، الذين أطلقوا عليهم العلويين نسبة إلى علي بن أبي طالب، لأنهم يعتقدون تجسد الإله في شخص الإمام علي ويعبدونه.
والنصيرية خرجت بدورها من كنف الإسماعيلية على يد نصير بن محمد، الذي زعم أنه كان الباب للإمام الحسن العسكري المتوفى في 874 م، وأن الإمام الحسن الحادي عشر من الأئمة الإثنا عشرية خلف محمدا المهدي صغيرا، فقام نصير هذا برعايته، وكان بابا له مثلما كان لوالده، وهي ادعاءات -كما يلاحظ- كاذبة ومختلقة، إذ لم يك نصير بن محمد من رفاق الحسن العسكري. ومسألة أن هذا الإمام خلف ابنا فيها خلاف، وحتى الأئمة الإثنا عشرية تقول إنه غاب إلى حين الرجعة، وبذلك لا أساس لادعاء نصير بن محمد رعايته له، لأنه غير موجود كذات. وقد هاجم الإثنا عشريون النصيريين، وأكدوا أنهم خارج العقيدة الإسلامية وإباحيون. وقد كتب سعد القمي (=نسبة إلى قم المدينة الإيرانية المقدسة) المتوفى في 914 م، وهو من كبار فقهاء الأمامية الإثنا عشرية، عدة رسائل في نقد النصيرية، باعتبارها عقيدة كاذبة وباعتبار أهلها منحلين وخارجين على العقيدة الإثنا عشرية. لكن نصير بن محمد واضع أسس المذهب بما فيها وحدة الوجود ومذهب التناسخ والحلول، لم يك هو المؤسس الحقيقي لهذه العقيدة، بل كان شخصا يدعى الحسين بن حمدان درس رسائل إخوان الصفا والفلسفة اليونانية، وادعى أن الإمام عليا تجلى فيه الإله، وأن الروح تبدل بعد فناء الجسد الأول أجسادها، وهي عقيدة هندوسية واضحة، يقول كتاب المعرفة الهندي -ڤيدا-: “كما يعدل الصائغ قطعة الذهب يحولها إلى شكل جديد أكثر جمالا، كذلك تتحول الروح بعد أن تترك الجسد وتتحرر من الجهل و تتخذ لنفسها شكلا أكثر جمالا لمن يرغب…”.
لقد اتهم الشيعة الإثنا عشرية على لسان الفقيه القُمى النصيريين بالإباحية. وكما أن حمزة بن علي مؤسس العقيدة الدرزية أشار إلى ذلك في تحذيره للدرزي قائلا:” لا تكن كالنصيري لا يمسك نفسه عن شقيقته”، ويؤكد النصيريون أن هذا كذب في حقهم.
والنصيريون يؤمنون بربوبية علي بن أبي طالب و بالتناسخ، ولا يمارسون الفرائض باستثناء صلاة في الصبح وصلاة في المساء وهم وقوف، ويحاولون لأسباب جلية ادعاء أنهم مسلمون. ومن المهم الإشارة إلى أن الحرب الأهلية في سوريا وليدة سيطرة النصيريين على السلطة منذ 1970م، بقيادة اللواء حافظ الأسد المتوفي عام 1997م. وقد أفتى علماء الإسلام سواء السنة أو الإثنا عشرية، بكون طائفة النصيرية خارجة على الإسلام. وعندما وقعت نكسة 5 حزيران 1967 واحتلت الجولان، كان حافظ الأسد وهو نصيري، وزيرا للدفاع بصفته عضوا في حزب البعث وفي القيادة القطرية، وقد أمر الجنود بالانسحاب من الجولان بدون قتال. وكان عدد الشهداء لا يتعدى 170 شخصا، فاجتمع قادة الحزب على رأسهم نور الدين الأتاسي وصلاح جديد، وقرروا إدانته وعزله بعد المؤتمر، لكنه كان قد هيأ نفسه جيدا، فانقلب عليهم قبل أن ينقلبوا عليه، وحسب المصادر السورية فإنه لم يستطع تولي الرئاسة، نظرا لعقيدته الموسومة بالكفر، فجاء برئيس نقابة المعلمين واسمه أحمد الخطيب ليتولى الرئاسة شكليا، ثم استدعى الإمام موسى الصدر من إيران (قيل إنه قتل في ليبيا التي نفت المسؤولية عن قتله) فأصدر الإمام موسى الصدر فتوى تؤكد أن النصيرية أحد فروع الإمامية الإثنا عشرية. وبذلك استطاع حافظ الأسد تولي رئاسة دولة شعبها 80% منه سنة، وهي فتوى كما يلاحظ أحادية، لم يجرؤ أي فقيه على إجازة ما أجازته سواء من أهل السنة أو من الإثنا عشرية باستثناء الإمام الصدر، الذي قد يكون قتل لهذا السبب إذ لم يعثر له على أثر منذ 31-08-1978. وكانت قضيته ضمن القضايا التي ابتز بها النظام اللليبي بزعامة معمر القذافي منذ 1978 حتى 2011، واستعملته مع قضايا أخرى، لحرب نفسية أدت إلى انهيار النظام، ولحد الآن لا يعرف من قتل الإمام موسى الصدر، حتى بعد نهاية نظام الراحل معمر القذافي بسنوات.
يتواجد النصيريون في سوريا وتركيا، بسبب استيلائها على قطاع الإسكندرون السوري. فأصبح مواطنوه جزء من الدولة التركية وأغلبهم نصيرية. وحكم الإسلام في النصيرية مثل الحكم في الدروز بكونها جماعة لا علاقة لها بالإسلام.
يشكل النصيريون في سوريا حوالي 8%، بينما يشكل المسيحيون 7%، والإسماعيليون أقل من واحد في المائة، بينما الباقي مسلمون سنة، مما يفسر الحرب الأهلية في سوريا. فالنصيريون رغم أقليتهم في المجتمع، شكلوا حوالي 20% في الجيش والقوات الجوية والمخابرات. وبذلك استطاعوا تجميد الجبهة العسكرية مع الكيان الصهيوني خلال الأربعين سنة الماضية، بدعوى التوازن العسكري مع العدو. ولكن الذي تقوى في المجتمع هو الجهاز البوليسي وعبادة الشخصية في الداخل دون أي ممارسة جدية فعلية لتحقيق هذا التوازن، فقد تم تأهيل الجيش لمحاربة الداخل أكثر من محاربة العدو الخارجي.
البورغواطيون:
قليلة هي المصادر التي تناولت دويلة البورغواطيين بالمغرب، التي تأسست في المنطقة الجغرافية الواقعة بين الرباط و الجديدة أو أزمور. كما أن عقيدتهم غير واضحة إلا لما كتب عنهم خصومهم. ولكن من الواضح أن الأمر يتعلق بجماعة مجدفة لها علاقة بأفكار الإسماعيلية في الشرق. فمن خلال ما جاء في بعض الدراسات التي استندت إلى مراجع تاريخية، خاصة المرابطين، يتبين أن بعض البورغواطيين أو بعض زعمائهم عاشوا مدة في الشرق، وتأثروا بالصراع المذهبي هناك، فأنشأوا دويلة البورغواطيين، التي دامت تاريخيا من سنة 842 م إلى غاية 1059 أو 1062 م، وتم القضاء عليها في المراحل الأولى لتأسيس دولة المرابطين بزعامة عبد الله بن ياسين، الذي قرر سحق هذه الجماعة، واستشهد وهو يقاتلهم في 1059 م. كان عبد الله بن ياسين أشبه بالشيخ أحمد بن تيمية، الذي استشعر خطورة الباطنية في الشرق والشام على وجه الخصوص، لكن الفرق أن ابن تيمية لم يكن يملك السلطة، وإن كان يملك ناصية الدين، بعكس عبد الله بن ياسين الذي كان يملك كليهما. لذلك فشل ابن تيمية و لم يُفهم من طرف مجايليه. وكما قيل:”ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن…” وينسب إلى عبد الله بن ياسين قوله عن البورغواطيين: “جهادهم أفضل من جهاد غيرهم”.
كان البورغواطيون متأثرين بما عرف بالمهدوية في الشرق العربي، وحولوا اسم المهدي إلى صالح، لذلك يلاحظ أن أغلب الأمراء الذين حكموا بورغواطة يحملون اسم صالح وآخرهم صالح بن عيسى، فقد زعموا أن مؤسس العقيدة سيعود من جديد وهو يونس بن صالح أو صالح بن مالك الذي توفي عام 884 م، ليحكم و ينشر العدل. وقد واجهت الدويلة حروبا ضدها من طرف القبائل المجاورة، ثم القضاء عليها من طرف المرابطين.
يذكر المؤرخون أن البورغواطيين لم يعلنوا الكفر، ولكنهم حوروا فرائض الإسلام. فجعلوا الصلوات عشرا منها: الليلية و النهارية، وحولوا شهر الصيام إلى رجب، وصلاة الجمعة إلى يوم الخميس. يقال إنهم حرموا أكل الدجاج، وسمحوا بأكل الخنزير، وقد يكون التحريم والتحليل عائدا إلى ضرورات اقتصادية هي حاجتهم إلى البيض، إذ منعوا ذبح الديك بدعوى أنه يؤذن، وسمحوا بأكل الخنزير لأنه يعتدي على مزروعاتهم.
أما في علاقتهم بالدول المجاورة، فقد ارتبطوا بأمراء بني أمية في الأندلس، الذين يبدو أنهم لم يكونوا على دراية بالعقيدة البورغواطية، لأن البورغواطيين –كما سلف- كانوا يظهرون الإسلام، ولذا رأى حكام الأندلس فيهم إزعاجا لحكام المغرب بصفة عامة حتى يبقوا بأمان منهم. والمفارقة أنه بعد القضاء على البورغواطيين من طرف المرابطين انتقلوا إلى الأندلس، وهو ما كان يخشاه حكامها!
إن أهم مصدر تاريخي تحدث عن البورغواطيين، هو كتاب أبي العباس المراكشي المشهور بابن عذاري «البيان المقرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب» والذي ألفه في 1312 م، وهناك شذرات متفرقة عنهم هنا وهناك في مصادر أخرى. وقد اختلف في تاريخ سقوط دولتهم هل في سنة 1029 أو 1060؟ والواضح أن القضاء على دويلة البورغواطيين كان في منتصف القرن الحادي عشر على يد المرابطين، ويرى البعض أن الإجهاز على بقاياهم تم في عهد الدولة الموحدية، إلا أن هذا القول لا أساس له ، فالمرابطون -خصوصا مع مقتل زعيمهم عبد الله بن ياسين في هذه الحرب في 1059 م- لم يتهاونوا في القضاء المبرم على هذه الدويلة، حتى أنهم ساعدوا في انتقال قبائل عديدة إلى المنطقة التي قامت عليها وهي منطقة خصبة، وبذلك انتهت إمارة البورغواطيين وآثارها في عهد المرابطين الذين وحدوا المغرب أرضا ومذهبا ، الشيء الذي لم يقع في الشرق العربي، لذلك لا زالت أقطار الشام، وتركيا، و العراق، ومصر تعيش الآثار السلبية للتردد وعدم الحسم التاريخي في الموضوع ، مما أدى إلى البلقنة الدينية والمذهبية للمنطقة.
السيخية والدين الإلهي:
السيخ لغة: هم المريدون، والسيخي المريد والمؤسس لهذه العقيدة هو غوروناناك 1469-1538م، الذي كان من مريدي الزوايا الإسلامية في الهند، والتي لعبت دورا هاما في نشر الإسلام وسط الهندوس بتعاملها و احتضانها للجميع سواء كانوا نخبا أو جماهير، مسلمين أو من عقائد أخرى. كما كانت تقدم الطعام لزوارها وتجير المغضوب عليهم من طرف السلطة.
وقبل أن نتحدث عن السيخ ومؤسس عقيدتهم والتطورات التي عرفتها تلك العقيدة لا بأس من الإشارة ولو بإيجاز إلى تاريخ الإسلام في الهند، لكون السيخية قامت بجمع الهندوس والمسلمين في عقيدة واحدة كما سنرى. لقد استطاع البعض في العهد الأموي، نشر الإسلام في الهند بعد محاولات في عهود الخلفاء الراشدين لم تنجح، وقبل سنة 711 م تاريخ الفتح الإسلامي للسند بقيادة يوسف الثقفي.
كان الإسلام قد أصبح عقيدة إيران و أفغانستان، وقام ملوك أفغانستان بغزو الهند لنشر الإسلام، خاصة السلطان محمود 1000-1030م، إلا أن تأسيس مواقع إسلامية متقدمة في الهند، كان زمن السلطان الغوري شهاب الدين عندما تم فتح لاهور في 1186 م، ودلهي في 1193 م، وتأسست سلطنة دلهي الإسلامية في 1206 م، التي استقلت عن سلاطين أفغانستان، وبدأ نشر الإسلام في الهند بين فئات المنبوذين ˃=الباربا˂ الطبقة الأدنى في السلم الطبقي الهندوسي مع “الشودرا”. وكان للزوايا الإسلامية دور هام في نشر الإسلام خلال القرون التي تلت الفتح الإسلامي، خصوصا ما بين القرن الثالث عشر والسابع عشر الميلاديين. وقد انتهت دولة الأفغان الإسلامية في 1526م. وتأسست دولة المغول الإسلامية بقيادة السلطان بابور 1526 – 1530 م. ثم جاء السلطان هما يون شاه 1530– 1556م، وبعده السلطان محمد جلال الدين أكبر 1556 – 1605م، الذي لم يكن له حظ في التعليم، إذ قضى طفولته وشبابه منفيا يمارس العمل العسكري. وعندما تولى السلطنة توسع في الفتوحات حتى كادت الهند بكاملها تصبح تحت سلطته، وارتبط بالهندوس الذين كانوا جزءا من بلاطه وصاهرهم. ثم أعلن في سنوات حكمه الأخيرة، أنه توصل إلى الدين الإلهي، في محاولة لجمع المسلمين والهندوس خاصة، وحتى المسيحية في دين جديد ابتدعه، وكان يعقد مجالس وندوات لأتباع الديانتين، أغلب الحاضرين فيها إما خائفون أو منافقون، لذلك سرعان ما فشل مشروع الدين الإلهي، الذي كان الهدف منه توحيد الهندوسية والإسلام.
ويبدو أن هذه الفكرة انتقلت إلى غوروناناك 1469-1539م، الذي كان عمره سبعة عشر عاما، عندما توفي السلطان “أكبر”، ومازاده شغفا بتلك العقيدة هو انتماؤه للزوايا الإسلامية وتجاوبه مع الأوراد، وإعجابه بطريقة التسيير في تلك الزوايا التي لم تك تفرق بين الناس، كما أن طريقة الإطعام العام فيها استهوته ولازالت قائمة في معابد السيخ حتى اليوم، وكانت مداخيل الزاوية تصرف على جمهور المريدين والزائرين، حيث يأكلون معا بعكس الهندوسية التي تعتبر الأكل الجماعي مع الطبقات الهندوسية الأدنى مثل الباربا والشودرا نجاسة. كان غورو ومعناها المُرشد أو المُعلم يكتب الأشعار الصوفية أو الروحانية، وكان له صديق مسلم يدعى “ماردانا” يلحن هذه الأشعار التي شاعت بين المريدين في تلك الفترة. كان “الغورو” هندوسيا، ينتمي إلى طبقة الكاشتريا في العقيدة الهندوسية التي تتألف من أربع طبقات: البراهما و الكاشتريا و الفزيا و الشودرا. وكان ظهور عقيدته أو مذهبه في عهد الدولة الإسلامية الثانية في الهند، وبالضبط في عهد الإمبراطور محمد نور الدين جهان 1605 – 1627، وانتشرت في عهد خليفته محمد شهاب الدين المشهور بشاه جهان 1627 – 1657، ثم صارت قوة عسكرية بعد أن كانت مجرد مذهب يدعو إلى توحيد الهندوسية و الإسلام بالموعظة. فقد تحولت عند كل غورو إلى سعي لتأسيس إمارة أو دولة خاصة، اتخذت من المظاهر العسكرية شعارا لهما، ودخلت في حروب مع الدولة الإسلامية في الهند ومع الهندوس أيضا. تأثر “ناناك” بالإسلام خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الناس والزوايا و وحدانية الله، ويرى البعض ويؤكد أن سيطرة البراهما الطبقية على الشعب الهندوسي، كانت أيضا أحد الأسباب التي أدت بنناك إلى ابتداع هذا المذهب الذي أكد فيه وحدانية الله ورفض الأوثان، وقد ضمن ترانيمه في هذا الصدد سورة الإخلاص. وقد درس ناناك علم الكلام على يد عالم يسمى السيد الحسن، وفي كتاب غورو ناناك الأهم “غرانت صاحب” نجد ألفاظا ومفاهيم عربية إسلامية عديدة منها : الله – رسول- رحمان- رحيم- آدم- أولياء- تسبيح- حاج- حديث- حق – خالق- رمضان- زكاة- مالك- سبحان- سجدة- سلام- سماع- شريعة- صدقة- شيخ- صوفية- طريقة- عرض- عزرائيل- عبد- فقر- قادر- كلمة- مريد- مسجد- مسلم- مصلى – معرفة- مكة- ملك الموت- موسى- مولانا- نعمة- وضوء- وظيفة – صلوات……
وفي مجال التعبير عن وجود الله، استعمل جملة “حاضر ناظر” وردد في ترانيمه: “معكم أينما كنتم”. ومن أهم الذين تأثر بهم ناناك الشيخ فريد الدين مسعود المتوفى في 664 هـ. والسيخ كلهم يزورون قبر هذا الشيخ الموجود في باكستان، بل إن أوراده تمثل جزء من كتب السيخ المقدسة.
بعد وفاة غوروناناك تولى منصب الغورو على التوالي 9 غوروات هم: انكند، وعمر داس، ورام داس، وارجان ديڤ، وهركند، وهراري، وهاري كريشان، وبهادور، وغوبند سينغ وكان أخرهم وتوفي في 1807. ومع مرور الزمن تحولت السيخية إلى عقيدةعسكرية عنيفة، بل إن الغورو الأخير غوبند سينغ وضع شروطا أخرى منها التعميد الذي بموجبه يتحول السيخي إلى سنغ وتعني الأسد. والمرأة السيخية مانكا وتعني لبؤة، وقَسَمُ الخالصة أي الإخلاص أصبحوا ينعتون دولتهم بالخالصة، ثم الكافات الخمس وهي : الكنش أي عدم قص الشعر، و كرا: حمل الرجال سوارا حديديا، وكنغا المشط، وكجة سروال قصير للرجال، وكريان: التمنطق بالسيف أو الخنجر. وقد أعلن السيخ الصراع مع الدولة الإسلامية أثناء مرحلة الأباطرة: جهان كير، وشاه جاهان، وأورانجزيب 1605-1707م، وقاموا بمذابح كبرى ضد المدن الإسلامية، وتولى زعامتهم في القرن الثامن عشر قائد يدعى “بندا”، يعتبر من السفاحين الكبار في تاريخ الهند، وفي نفس الوقت دخلوا في صراع مع الهندوس في محاولة لتأسيس دولة منفصلة. وعندما سيطر الاستعمار الإنجليزي على الهند بعد 1857م، انضموا إليه وساعدوه، ثم حاربوه خصوصا في 1919. وقد انضم غالبية السيخ بعد الاستقلال، وانفصال باكستان عن الهند في 1947 إلى الجانب الهندي، حيث تم تقسيم البنجاب بين باكستان و الهند، ويوجد أغلبهم في البنجاب الهندية وفي بعض نواحي دلهي. وقد خاضوا صراعا مع الدولة المركزية في الهند وأعلنوا دولة خالصتان، وجعلوا المعبد الذهبي في مدينة أمريستار مركزا لتصنيع السلاح، وقد هاجمته القوات الهندية في عهد أنديرا غاندي، رئيسة الوزراء 1966-1984. التي اغتالها اثنان من السيخ في أكتوبر من نفس السنة، واتضح لهم أن مطلب الاستقلال غير مقبول في الهند، وقد قتل الآلاف من السيخ بعد مقتل أنديرا غاندي لدرجة أن جميع السيخ في دلهي حلقوا شعورهم، وتخلوا عن كل ما يشير إلى أنهم سيخ، حتى لا يثيروا الغوغاء الهندوس الذين انتقموا لمقتل السيدة أنديرا غاندي. وقد تولى مانهومان سنغ رئاسة الوزراء 2004-2009، كما تولى زايل سنغ رئاسة الجمهورية قبل ذلك وكلاهما من السيخ، ويشكل السيخ 1% من مواطني الهند، ولكنهم لطبيعتهم العسكرية يشكلون 12% من الجيش الهندي. وتشكل ولاية البنجاب %1,5 من مساحة الهند، وهي أهم ولاية هندية في إنتاج القمح، إذ تساهم ب 65% من سلة الغذاء الهندي.
القاديانية أو الاحمدية:
قاديان: هي مدينة أو قرية كبيرة من قرى البنجاب الهندي – والبنجاب، تعني خمسة أنهار. وعندما استقلت باكستان عن الهند في 1947 قسم البنجاب بين الهند وباكستان، فصار الجزء الشرقي إلى الهند، وهو حاليا ولاية السيخ البنجاب، وصار الجزء الغربي إلى الدولة الجديدة باكستان. ويشكل البنجابيون 65% من سكان باكستان الذين يبلغ تعدادهم حوالي 220 مليون نسمة. لذلك فإن القاديانية ليست بعيدة عن “السيخية” أو على الأقل فإن فكرة التجديد في الهندوسية والإسلام التي نادى بها غوروناناك والباب غير بعيدة عن القاديانية، رغم أن هذه الأخيرة حاولت الاستفادة من الأخطاء القاتلة للبابية والبهائية، التي أدت إلى نفور المسلمين منهما ومن الباطنية أيضا. كما أن ظهور القاديانية لم يكن بمنأى عن الاستعمار الإنجليزي وعن سقوط الدولة الإسلامية في الهند انتهت نهائيا في 1857 بالثورة التي قادها سلطان سلطنة دهلي “دلهي حاليا” مظفر شاه ضد الوجود الانجليزي، والتي انتهت بهزيمة جيشه ونفيه إلى بورما حيث توفي ودفن. فالاستعمار الانجليزي كان واعيا بخطورة الجهاد عند المسلمين الذين كانوا يشكلون إذ ذاك نسبة الثلث من سكان الهند، ثم إن الهند أصلا تستوعب مثل هذه الأفكار فلازال لحد الآن يظهر “أنبياء” جدد في الهندوسية ويجدون لهم أتباعا. فإيجاد مليون أو مليوني تابع في الهند لفكرة جديدة ليس بالأمر الصعب، والهند التي يظهر فيها “أنبياء و آلهة” جدد، وأدعياء حلول آلهة الهندوس فيهم، تحتضن بالمقابل جمعيات “صيادي مدعي النبوة و الألوهية” تحاربهم أينما حلوا وارتحلوا. أما ميرزا غلام أحمد القادياني نسبة إلى مدينة قاديان، فيقال إنه عاش في بيت علم، وكان مصابا بالصرع، وقد جهُر بأنه المهدي المنتظر ثم كونه نبي في 1889 وذلك بعد وفاة والده منتصف الثمانينيات من القرن 19، إذ لم يجرؤ على ادعاء ذلك في حياته. ادعى غلام أحمد (وتعنى عبد النبي) أنه نبي ورسول، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس آخر الأنبياء والرسل.
وقد أخذ الاستعمار البريطاني دعوى ظهور المسيح الجديد في قاديان على محمل “الجد”، إذ أن الرجل كان من الطائفة الإسلامية التي تجهر بعدائها لبريطانيا، حيث الدعوة للجهاد ضدها سارية بين المسلمين في ظل الارتباط بالخلافة الإسلامية في الأستانة، أعلن القادياني أن الجهاد ضد الانجليز حرام، وبذلك أبطل الركن الأساسي الذي يخافه الانجليز وهو النضال ضد الاستعمار، ولم يغير شيئا من الصلاة والصوم والشهادة، وزعم أن المسيح عليه السلام توفي، وأنه هو المسيح جاء ليملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا، وهي فكرة قريبة من المهدوية. وزعم أيضا أن الوحي نزل عليه. وكانت بداية الوحي العجيب هذه الكلمات: (يا أحمد بارك الله فيك. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرحمان علم القرآن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ليتسنى سبيل المجرمين قل إني أمرت وأنا أول المسلمين) وواضح أن هذه الكلمات مأخوذة شكليا بالتحريف من الآيات القرآنية الكريمة ومركبة، وأخرى شبيهة بها “قل عندي شهادة من الله، فهل أنتم مؤمنون؟ قل عندي شهادة من الله فهل أنتم مسلمون؟” كما ادعى أن بعض الكلمات والأحلام تأتيه بلغات أخرى مثل :”إيلي لما سبقتني إيلي أوس”. وكانت له تفاسير عجيبة شبيهة بالكلمات “الحرة” التي كانت “تأتي” الباب و البهاء، وسرعان ما تنكر غلام أحمد للمسلمين الذين رفضوا دعاواه، فمنع الزواج منهم والصلاة معهم وأوجب أداء كل قادياني مبلغ 6% من دخله للجماعة. وقد زعم في عام 1890م أن الوحي هبط عليه مخبرا أياه بوفاة المسيح، وأن تجسده الثاني تحقق قي شخصه “لقد مات المسيح ابن مريم وجئت أنت في صفته حسب الوعد وكان وعد الله مفعولا” والتجسد أو كارما، هي إحدى عقائد الهندوس، فالإنسان، في رأيهم، لا يموت إلا وعاؤه أو جسده، ويتجسد في حياته المقبلة في جسد طيب أو منبوذ حسب أفعاله في حياته السابقة أو حجارة أو شجر، لكن غلام أحمد مزج بين التجسيد وبين المسيح عليه السلام وما جاء به القرآن الكريم حتى يستقطب الأتباع من المسلمين ومن غير المسلمين، لم يكتف بذلك بل ادعى أن كثيرا من آيات القرآن الكريم التي نزلت في الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت في حقه هو “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين” الآية و “ماينطق عن الهوى” الآية.
كانت بريطانيا التي واجهت عداءا شديدا من الطائفة الإسلامية ورفضا صريحا من المسلمين، قد وجدت في “القاديانية” – التي واجهت نفس العداء- فرصة لمحاربة باقي المسلمين مثلما وجدت في الطوائف الأخرى كالسيخ الذين اندمجوا في أجهزة الأمن الاستعمارية، فرصة لنجاح سياستها التي تعتمد مبدأ فرق تسد، وكانت القاديانية تحتاج بإلحاح إلى الاستعمار الانجليزي ولازالت، أمام الرفض العام للمسلمين لها ومحاربتها بشدة، لذلك أعلن القادياني غلام أحمد، أن محاربة الانجليز حرام، وعندما بدأت معركة الاستقلال التي قادها حزب المؤتمر الهندي والجماعة الإسلامية، وانتهت باتفاق لاهور في 1941، وإعلان التفاهم على تأسيس دولة جديدة تجمع المسلمين في الشرق والغرب حسب مناطق الكثافة الدينية، وبعد 1947 أصبح شرق البنجاب جزءا من الهند وانتقل القاديانيون الذين بلغ عددهم بضعة آلاف إلى الدولة الجديدة باكستان وأسسوا مقرا للحركة وجامعة. مات غلام أحمد المتنبئ في 1908، وخلفه بشير الدين محمود الذي توفي في 1965، فخلفه ناصر أحمد حفيد غلام أحمد فمات في 1982، وخلفه طاهر أحمد الذي مات عام 2004 فخلفه مسرور أحمد.
خلال جميع هذه المراحل أصدر علماء باكستان فتاوى عديدة بتكفير هذه الجماعة واعتبارها نحلة خارجة عن الإسلام. وكانت الحكومات المتعاقبة -خصوصا مع الضغط الغربي- تغض النظر عن ذلك حتى 1977 في عهد الرئيس ذو الفقار علي بوتو (أعدم في 1979) عندما أصدر البرلمان الباكستاني قرارا باعتبار القاديانية نحلة كافرة. وعندما تولى الجنرال ضياء الحق السلطة أصدر قرارا في 1984 بمنع هذه الجماعة فهرب قادتها إلى لندن وعلى رأسهم الخليفة الرابع كما يسمي نفسه طاهر أحمد إلى أن مات في 2004، وتولى قيادتها مسرور أحمد. وقد أسسوا مسجدا صغيرا في لندن وقناة تلفزيونية ومطبعة ضخمة تطبع وتوزع المنشورات بكل اللغات.
تزعم الجماعة أن لها 12 مليون تابع، وهو رقم جد مبالغ فيه، فالأمر لا يتعدى بضعة آلاف من الأفارقة الذين استفادوا من المستشفيات والمدارس التي شيدتها الحركة، وبعض الأوروبيين في ألمانيا والدانمارك خاصة –الذين لا يعرفون مبادئ وتاريخ الإسلام- حيث هاجر القاديانيون بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى هناك و بنوا بعض المساجد. وهناك بضع مئات من الأتباع في الهند خاصة في ولاية أوريسا. إلا أن الحركة عرفت بعض الأسماء اللامعة في تاريخها مثل السيد ظفر الله خان، الذي كان وزيرا للخارجية في أول حكومة باكستانية برئاسة مؤسس الدولة الباكستانية محمد علي جناح –توفي في 1948- والذي ترأس – أي ظفر الله خان- المحكمة الدولية كما ترأس الدورة 17 للأمم المتحدة، وكان يقول “اعتبروني وزيرا مسلما لدولة كافرة أو موظفا كافرا لدولة إسلامية” كما أن البروفيسور عبد السلام الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء (وهو تتويج ملغوم) عام 1979 من أتباع الحركة، والأمر لا يعدوا كون بعض العلماء والمثقفين في مختلف المجالات والتخصصات أعضاء في جماعات معينة، مع العلم أنه لا مجال للمقارنة بين الحركات الصوفية الإسلامية، والجماعة القاديانية التي صدر فيها وبإجماع علماء المسلمين فتوى الكفر مثلها مثل البابية و البهائية والنصيرية والدرزية .
احتضنت بريطانيا القاديانية منذ نشوئها، بل إنها لها يدا في هذا الإنشاء، إذ منعت أي مساس بها. وقد صدر حكم بالإعدام في 1938 ضد أبي الأعلى المودودي زعيم الجماعة الإسلامية (المتوفى في 1979) في الهند أثناء الاستعمار البريطاني، لأنه عارض القاديانية، وإن لم ينفذ هذا الحكم. وعندما أعلنت القاديانية نحلة غير إسلامية في باكستان، فإن بريطانيا من جديد احتضنت أكثر من 20 ألف قادياني. وجميع قادة هذه النحلة، سواء من الصف الأول أو الثاني أو الثالث يقيمون في بريطانيا ولهم معابد ومؤسسات اجتماعية، ومن خلال التسهيلات البريطانية ينتقل القاديانيون إلى افريقيا لتقديم بعض المساعدات الغذائية. ولما كانوا لا يعلنون حقيقتهم فالجمهور العادي يعتقد أنهم مسلمون، خصوصا أنهم يقرأون القرآن ويقيمون الصلوات. ويتلقى القاديانيون مساعدات مالية من بريطانيا والدول الغربية. وقد احتضنهم الكيان الصهيوني أيضا، وعقدوا عدة مؤتمرات في مدينة حيفا بفلسطين المحتلة والقاديانيون ليس لهم أي موقف سياسي أو نضالي أو إسلامي ضد أعداء الإسلام كيفما كانوا، فهم يقدمون أنفسهم لليهود و المسيحيين وغيرهم، على أنهم مسلمون مسالمون وليس لهم قضية أو موقف سياسي ما، وفي هذا يلتقون مع البهائية .
وقد شيد القاديانيون معابد يسمونها مساجد في بعض البلدان الغربية كالولايات المتحدة، واسبانيا، و ألمانيا، في محاولة تشجيعية من الغرب للاتصال بالمسلمين المهاجرين الذين قد يخدعون بهذه النحلة، خصوصا أن القاديانيين يظهرون غير ما يبطنون، وقد غيروا اسمهم إلى الأحمديين لمزيد من التضليل؛
*باحث




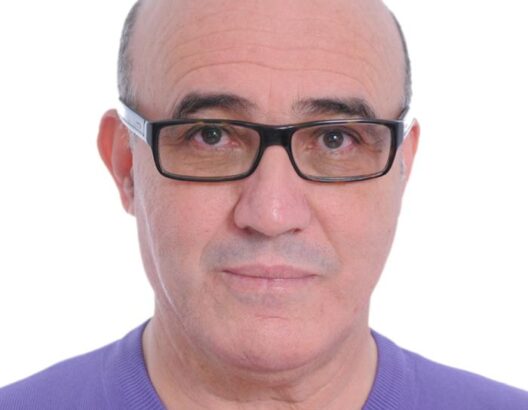
اترك تعليقاً