المقاربات التربوية في معالجة العنف داخل المؤسسات التعليمية فاشلة ومتجاوزة

اشتد العنف في الوسط المدرسي وخارج البنايات التعليمية، وفشلت المقاربات التربوية البديلة في معالجة الظاهرة. وتعقدت مساطر المتابعة القانونية بسبب شموليتها، بينما تعددت حالات الضحايا بين الموظفين والمتعلمين.
الاختلالات بدأت تنمو، والهوة بين المتعلم والمدرس اتسعت، وطرق المعالجة تتعدد يوما بعد يوم بين المحلل التربوي، والقانوني، والمرشد النفسي والاجتماعي، والسوسيولوجي. وبين كل هذه التوجهات والمواقف، يضيع الحق في الانتظار. فالانتكاسات النفسية تلاحق الأطر التعليمية، ولها أثر كبير على التعلمات وعلى المجتمع ككل، باعتبار المدرسة حلقة وصل فعالة بين الأسرة والمجتمع.
عجزت الأسر عن مصاحبة أبنائها، وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في إذكاء الظاهرة، فكثر تداول العناوين بين المهتمين، من قبيل: “النقابات تدين”، “الأطر في وقفات احتجاجية”، “المتعلمون يزدادون هيجانا”، ولا يُسمع إلا ما يفتق السمع: “تلميذ يرسل أستاذا إلى المستعجلات”، “اعتداء على أستاذة”، “تلميذ يعنّف مديراً”، “تلميذ يكسر أنف أستاذه”…
الوضع مقلق، ولا راحة بال للمدرس. نفسيته منكسرة، مهددة، منهزمة. التهديدات مستمرة، ورابطة التعلق بالدراسة توترت. الرقيب التربوي لم يعد كافياً، والمقاربة الزجرية تُثير حفيظة رجال القانون، احتراماً للمواثيق الدولية. وقد تنازل العديد من الموظفين عن المتابعة القانونية، وتدخّل “ناس الخير والبر”، مما ساهم في تنامي العنف.
الأمر يستوجب تغيير إجراءات مجالس الانضباط، بل يتطلب – في نظر البعض – عسكرة المؤسسات التعليمية عبر إحداث مكاتب للقوات المساعدة داخلها، في إطار تنسيق لتعزيز الأمن والسلامة، وبث الثقة، وتأمين الظروف الملائمة لقيام المدرسة بوظائفها الأساسية، مما يقتضي التشبيك والتقائية في عمل جميع القطاعات الحكومية والمدنية والفاعلين المعنيين قصد ضمان الاستمرارية.
رغم أن الفكرة كانت مرفوضة سابقاً (ولا تزال مرفوضة من البعض) من منطلقات حقوقية وديمقراطية وانفتاحية، إلا أن السياق تغير؛ فالقيم التي كانت تتحكم في السلوكيات قد انهارت. وكما رُفض حضور “الأواكس” داخل الجامعات بداية الثمانينيات، ثم أصبح الأمر مألوفاً، فإن إرساء الأمن بالمؤسسات التعليمية اليوم أصبح ضرورة.
فزاوية الرؤية مختلفة بين من يمارس التعليم، ومن يراقب من الداخل، أو من الخارج، أو من المتفرجين الذين يتملّكهم شعور بالانتقام من الأشخاص، ومن المدرسة، ومن الوطن.
مراكز الاستماع داخل المؤسسات التربوية، وتنظيم الأنشطة التوعوية، لا تجدي نفعاً في كثير من الأحيان، والكثير من المتعلمين لا يحضرونها أصلاً. لا يمكن أن نطلب من الأستاذ أن يغيّر العالم، ولا يمكن تحميله وحده مسؤولية حماية المتعلمين. فالمسؤولية في هذا الصدد مشتركة بين الدولة، والمجتمع، والمدرسة.
فالقيم المجتمعية تعرف متغيرات طارئة، وعنف المدرسة هو انعكاس لعنف المجتمع ككل، وليست المدرسة معزولة عن هذا الواقع. العلاقة بين الأستاذ والتلميذ تفككت. والأستاذ اليوم يعاني من مختلف أشكال العنف: الجسدي، واللفظي، والرمزي.
وهذا لا يعني تعميم الظاهرة؛ إذ توجد فئات عريضة من المتعلمين والمتعلمات يتميزون بأخلاق عالية واحترام كبير لأطرهم. لكن “طينة” معينة تُفسد الكل، ويضيع معها التعلم.
وإن لم تُعالج هذه الظواهر، فإن الوقت سيأتي قريباً حيث لن يقوم الأستاذ بمهامه، وسيتخلى عن دوره، وستعم الفوضى أكثر، وسيزداد العنف، داخل المؤسسة وخارجها، لأن آليات التحكم تغيّرت.
يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، توقفت الأطر التعليمية بمختلف شرائحها عن العمل في العديد من المؤسسات التعليمية بالمغرب، تنديداً بسلوك العنف، في رسالة موجهة إلى الآباء، والأمهات، والمجتمع، والسلطة، ورجال القانون، من أجل التدخل – كل من موقعه – لإصلاح الوضع.
فالاستقرار نعمة للجميع، والسلم الاجتماعي هو المطلب المنشود، ولا استقرار تربوي في هذه الأيام إلا بالزجر، وبتدخل الأمن لإعادة الهيبة للمؤسسات التعليمية.
زايد جرو – كاتب وإعلامي من الرشيدية




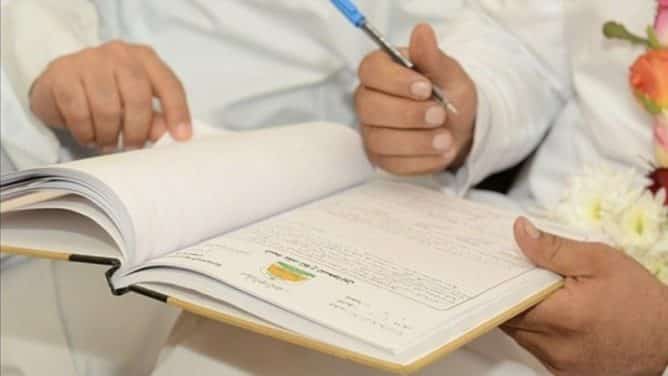
اترك تعليقاً