فوزين أفيرز: البيانات هي النفط الجديد والذكاء الاصطناعي يعزز الاستبداد
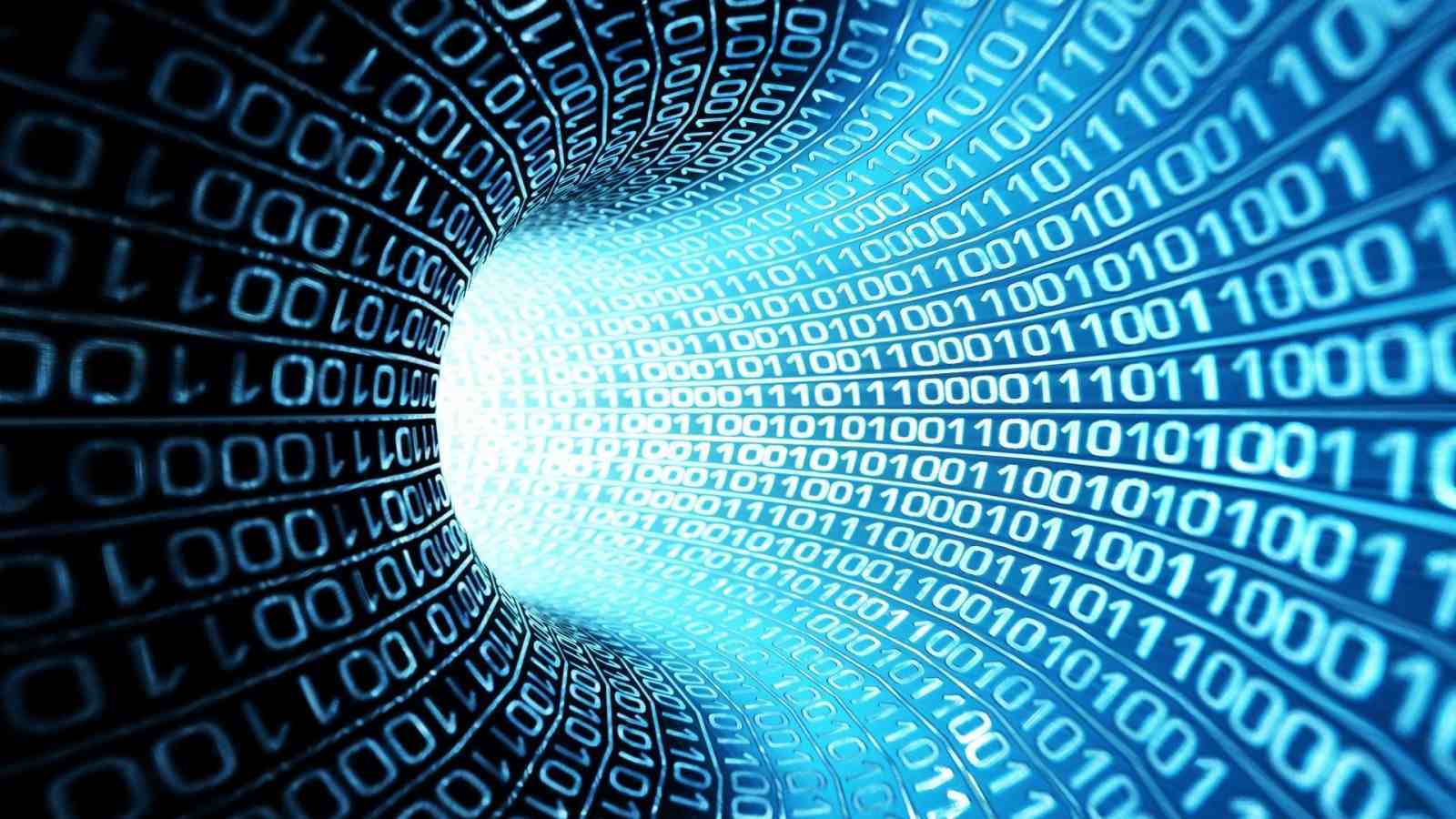
يعيد الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة مقولة أن “الشعب مصدر السلطة” في بعد جديد، وإذا كانت تلك المقولة من الناحية السياسية تتعلق بالأساس بالرأي العام وصناعته وتوجهاته والتحكم فيه، فإنها فيما يتعلق بالصراع حول التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي ترتكز على البيانات.
ويحتدم الصراع بالأساس بين الولايات المتحدة والصين، ليس فقط في التسابق إلى امتلاك وتطوير تكنلوجيا الذكاء الاصطناعي، بل على مستوى مصدر البيانات، والتي تعد الصين بأزيد من مليار ونصف نسمة منافسا شرسا في هذا المجال.
ولأن الصراع يدور حول البيانات، فالذكاء الاصطناعي يتحول إلى أداة حاسمة للصراع بين الديموقراطية والاستبداد والطغيان.
ومسألة الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول الذكاء الاصطناعي في بعده المتعلق بالبيانات نشرت مجلة “فورين أفيرز”حوله (Foreign Affairs) ، حسب الجزية نت، مقالا يبين دوره في “تشويه” صناعة القرار، وسيناريوهات التنافس بين القوتين العظميين، ودوره في تعزيز الاستبداد.
“البيانات هي النفط الجديد”
وحسب نفس المصدر، جاء في المقال أن النقاشات والحوارات داخل الدوائر السياسية حول الذكاء الاصطناعي تضع دوما الصين في سباق مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي.
وإذا كان المصدر الرئيس الذي يعتمد عليه ذلك الذكاء هو البيانات، فإن الصين بتعداد مواطنيها الذي يتجاوز مليار نسمة، وتساهلها إزاء معايير الجودة العالية؛ يبدو أنه مقدّر لها الفوز في ذلك السباق، وفق تعبير المقال الذي شارك في كتابته 3 من الأكاديميين البارزين في الولايات المتحدة.
والأكاديميون هم: هنري فاريل أستاذ الشؤون الدولية بجامعة جونز هوبكنز، وأبراهام نيومان أستاذ نظم الحكم بجامعة جورجتاون، وجيرمي والاس أستاذ نظم الحكم بجامعة كورنيل.
وينقل هؤلاء الأساتذة الجامعيون عن عالم الكمبيوتر الشهير كاي فو لي القول إن البيانات هي النفط الجديد، وهي للصين بمنزلة “أوبك” أخرى.
فإذا كانت التكنولوجيا الفائقة هي التي ترجح الكفة في مثل هذا التنافس، فإن الولايات المتحدة بما تملكه من نظام جامعي عالمي وقوى عاملة ماهرة لا تزال لديها فرصة للتفوق على نظيرتها الصين.
ويفترض الخبراء أن الغلبة في مجال الذكاء الاصطناعي ستؤدي بطبيعة الحال إلى تفوق إحدى الدولتين على الأخرى اقتصاديا وعسكريا بشكل أوسع.
لكن التفكير في الذكاء الاصطناعي من منظور التنافس على الهيمنة يغفل الطرق الأكثر جوهرية التي يتبعها الذكاء الاصطناعي لإحداث التحول في السياسة الدولية، فالذكاء الاصطناعي لن يغير طبيعة التنافس بين القوى بقدر ما سيغير المتنافسين أنفسهم، كما يعتقد كُتّاب المقال.
ويقارن المقال بين الولايات المتحدة التي تنتهج الديمقراطية نظاما للحكم، والصين التي تتبنّى نظاما “استبدادي” الطابع، ويشكل التعلم الآلي (بمعنى قدرة الآلة على التعلم) تحديا للنظامين السياسيين كل بطريقته الخاصة.
ولعل التحديات التي تواجه الأنظمة الديمقراطية -مثل الولايات المتحدة- واضحة تماما، وقد يفاقم التعلم الآلي من ظاهرة الاستقطاب من خلال إعادة هندسة عالم الإنترنت لتكريس الانقسام السياسي.
كما أنه سيزيد على وجه اليقين من نشر المعلومات المضللة في المستقبل، ويولِّد خطابا مزيفا مقنعا على نطاق واسع.
تحديات الأنظمة الاستبدادية
إن التحديات التي تواجه الأنظمة الاستبدادية أكثر دقة، ولكنها ربما تكون أشد ضررا. ومثلما يعكس التعلم الآلي الانقسامات الديمقراطية ويعززها، فإنه قد يربك الأنظمة الاستبدادية، ويخلق مظهرا زائفا للإجماع ويخفي الانقسامات المجتمعية الأساسية حتى بعد فوات الوقت.
وقد أدرك رواد الذكاء الاصطناعي الأوائل، كالعالم السياسي هربرت سيمون، أن ثمة قاسما مشتركا بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأسواق والبيروقراطيات والمؤسسات السياسية، أكثر مما بينها وبين التطبيقات الهندسية البسيطة.
ويعرِّف نوربرت وينر -أحد الرواد في هذا المجال- الذكاء الاصطناعي بأنه نظام “إلكتروني يمكنه الاستجابة والتكيف مع الملاحظات وردود الفعل”، أو ما يطلق عليها التغذية الراجعة.
ووفق مقال “فورين أفيرز”، تستخدم شركتا “غوغل” و”فيسبوك” التعلم الآلي كمحرك تحليلي لنظام التصحيح الذاتي، يقوم باستمرار بتحديث فهمه للبيانات اعتمادا على تنبؤاته إذا كانت ستنجح أو ستفشل. هذه الحلقة بين التحليل الإحصائي وردود الفعل من البيئة هي التي جعلت التعلم الآلي قوة هائلة.
على أن الأمر غير المفهوم جيدا -برأي كتّاب المقال- هو أن الديمقراطية والدكتاتورية نظامان إلكترونيان أيضا، إذ بموجبهما تسنّ الحكومات سياساتها ثم تسعى لمعرفة إذا كانت تلك السياسات قد نجحت أو فشلت.
ولدى الحكام الطغاة، فإن تقنية التعلم الآلي تمكنهم من معرفة إذا كان رعاياهم يحبون ما يفعلونه من دون حاجة إلى استطلاعات الرأي أو التعرض لمخاطر سياسية تتسبب فيها الحوارات والمناظرات المفتوحة والانتخابات.
ولهذا السبب -كما يرى الأكاديميون الثلاثة في مقالهم- انتاب العديد من المراقبين القلق من أن التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلا إلى تقوية يد الطغاة وتمكينهم من السيطرة على مجتمعاتهم.
وعلى عكس الاعتقاد السائد، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوّض الأنظمة الاستبدادية بشكل خطير؛ من خلال تعزيز أيديولوجياتهم وأوهامهم على حساب فهم أدق للعالم الحقيقي.
وقد تكتشف الدول الديمقراطية أن الأمر عندما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فإن التحدي الرئيس في القرن الحالي لا يكمن في الفوز بمعركة الهيمنة التكنولوجية، بل في الاضطرار إلى التباري مع الدول الاستبدادية التي تجد نفسها في خضم دوامة الوهم التي يغذيها الذكاء الاصطناعي.
ويمضي المقال إلى أن الحكام الطغاة استخدموا المقاييس الكمية كبديل صارم وغير كامل لمعرفة ردود فعل الجمهور. فالصين -مثلا- حاولت على مدى عقود الجمع بين اقتصاد السوق اللامركزي والإشراف السياسي المركزي على عدد قليل من الإحصاءات المهمة، لا سيما الناتج المحلي الإجمالي.
ويزعم المقال أن المسؤولين الصينيين تلاعبوا في كثير من الأحيان بالإحصاءات، أو انتهجوا سياسات زادت من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير مع ترك المشاكل طويلة الأجل لمن سيخلفونهم في المناصب؛ وليس أدلّ على ذلك من استجابة الصين الأولية لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
هل يحابي الذكاء الاصطناعي الاستبداد؟
إن السؤال الأكثر إلحاحا ليس إذا كانت الولايات المتحدة أو الصين ستفوز أو تخسر في السباق على هيمنة الذكاء الاصطناعي، بل في الكيفية التي سيغير بها عمليات استقاء ردود الفعل المختلفة التي تعتمد عليها الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية لحكم مجتمعاتها.
ويوحي العديد من المراقبين أن الانتشار الواسع لتقنية التعلم الآلي سيضرّ حتما بالديمقراطية، وسيساعد ذلك بالمقابل النظم الاستبدادية.
ومن وجهة نظر هؤلاء، قد تؤدي خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل على تحسين المشاركة -على سبيل المثال- إلى تقويض الديمقراطية من خلال الإضرار بجودة تعليقات المواطنين وردود فعلهم.
فعندما ينقر الأشخاص على مقطع فيديو تلو الآخر، تقدم خوارزمية “يوتيوب” (YouTube) محتوى “صادما ومثيرا للقلق” للإبقاء على تفاعلهم، وغالبا ما يتضمن هذا المحتوى نظريات المؤامرة أو الآراء السياسية المتطرفة التي تجذب المواطنين إلى عالم “مظلم” حيث تنقلب فيه الأشياء رأسا على عقب.
وعلى النقيض من ذلك، من المفترض أن يساعد التعلم الآلي الأنظمة الاستبدادية من خلال تسهيل سيطرة أكبر على شعوبها، حتى إن مؤرخا مثل يوفال هراري ومجموعة من العلماء الآخرين يزعمون أن الذكاء الاصطناعي “يفضل الاستبداد”.
ووفقا لأصحاب هذا الرأي، فإن الذكاء الاصطناعي يعمل على تركيز البيانات والسلطة، وذلك يسمح للقادة بالتلاعب بالمواطنين العاديين من خلال تزويدهم بمعلومات محسوبة “لاستثارة عواطفهم الجياشة”.
وقد يتحول الاستبداد المتكئ على “البيانات المؤتمتة بالكامل” إلى فخ لدول مثل الصين التي تركز السلطة في مجموعة صغيرة معزولة من صانعي القرار.
بالمقابل، تملك الدول الديمقراطية آليات تصحيح عبارة عن أشكال بديلة من ردود فعل المواطنين التي يمكن أن تكون ضابطا لأداء الحكومات إذا خرجت عن المسار الصحيح، وهو ما تفتقر إليه الحكومات الاستبدادية.
إن النظرة الفجة -حسب “فورين أفيرز”- تقوم على أن تقنية الذكاء الاصطناعي سلاح اقتصادي وعسكري، وأن البيانات تخفي في طياتها كثيرا من الحقيقة.
على أن أكبر الآراء السياسية المترتبة على الذكاء الاصطناعي تتمثل في آليات ردود الفعل، أو ما يعرف بالتغذية الراجعة التي تعتمد عليها الدول الديمقراطية والاستبدادية على حد سواء.
وينصح كتّاب المقال حكومات الدول التي تفكر في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي بأن تدرك أننا نعيش في عالم مترابط، حيث من المرجح أن تتسلل مشاكل الحكومات الاستبدادية إلى الديمقراطيات.





اترك تعليقاً