أهم التحديات المستقبلية: تحدي التعقيد

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم لم يعد عالماً بسيطاً يمكن فهمه عبر أدوات تقليدية أو من خلال منطق خطي مباشر، وبالتالي لقد انتقلنا من ظواهر بسيطة يمكن التنبؤ بها، إلى ظواهر مركبة تزداد عناصرها لكنها تبقى من نفس الطبيعة، وصولاً إلى الظواهر المعقدة التي تتكون من عناصر كثيرة ومتنوعة، تتفاعل فيما بينها ومع البيئة الخارجية بطرق غير خطية، وغير متوقعة أحياناً. وبالتالي هذا التحول البنيوي يجعلنا أمام مفارقة كبرى، وهي أن أدواتنا الفكرية والمؤسساتية ما تزال في الغالب اختزالية، بينما التحديات صارت معقدة نسقية.
إن المشكلة الأولى التي تواجهنا هي هيمنة الفكر الاختزالي التحليلي، فهذا الأخير هو فكر أعور، ينظر فقط من عين التخصص الضيق، وبالتالي فبدل أن نرى المشهد الكلي بعلاقاته وتفاعلاته، نقوم بتجزئته إلى عناصر منفصلة. وبالتالي فالفكر الاختزالي يشبه العين الواحدة التي ترى التفاصيل لكنها تفقد المشهد العام. ومنه، فهذا التفكير يشتغل جيداً مع الأنساق البسيطة أو المركبة، لكنه يفشل فشلا ذريعا أمام الأنساق المعقدة التي تتطلب فهماً عميقاً للعلاقات السببية، للتشابك، وللتفاعلات الديناميكية. وبالتالي فإن الاقتصار على التحليل الاختزالي يجعلنا أمام محدودية في الفهم، وبالتالي محدودية أكبر في التوقع واتخاذ القرار وبالتالي أزمة الفكر الاختزالي التحليلي.
في حين أن التعقيد اليوم يظهر كمعطى مستقبلي، فالعالم المعاصر يتجه نحو مزيد من التعقيد، حيث تتشابك التكنولوجيا (الذكاء الاصطناعي، البلوكشين، الثورة الصناعية الرابعة)،
بالاقتصاد العالمي (العولمة الجديدة، صدمات سلاسل التوريد)،
مع المجتمع (احتجاجات الشباب، تحولات الأجيال)، مع المناخ والبيئة (التغيرات المناخية، ندرة الموارد).
وبالتالي هذه الظواهر لم تعد مستقلة، بل تتحرك ضمن نسق متكامل دينامكي، حيث يؤدي أي تغيير صغير في عنصر ما إلى نتائج غير متوقعة في عناصر أخرى. إنها ما يسميه علماء التعقيد بـ النتائج الناشئة (Emergent outcomes).
وفي هذا الإطار، هناك نقد ضمني لسياسات ومؤسسات ما تزال رهينة “التخصص الضيق”، عاجزة عن ربط التعليم بالاقتصاد، أو الاقتصاد بالبيئة، أو التكنولوجيا بالمجتمع. وبالتالي فالرسالة الخفية هي أن العالم لم يعد يقبل الحلول البسيطة أو “الوصفات الجاهزة”، بل يحتاج إلى منهجية جديدة في التفكير.
وبالتالي هذا يعني أن المستقبل سيكون للذين يتقنون التفكير النسقي، القادرين على إدارة التعقيد لا فقط على تحليله.
كما أن الأوساط الأكاديمية والمهنية أصبحت توسع الاهتمام بـ الدراسات العابرة للتخصصات. كما ظهرت مبادرات تعليمية لتعليم “التفكير النسقي” منذ المراحل الأولى. إضافة الى اعتماد النماذج المعقدة في التخطيط للسياسات المناخية والاقتصادية.
مع توسع استخدام المحاكاة الذكية في إدارة الأزمات (جائحة كورونا نموذجاً). ناهيك أن القوى العظمى (الولايات المتحدة، الصين) تبني استراتيجياتها الكبرى على أساس إدارة التعقيد العالمي. نفس الشيء بعض المؤسسات الدولية (الأمم المتحدة، البنك الدولي) بدأت تنتقل من خطاب “النمو الخطي” إلى خطاب “التعقيد والمرونة”. وبالتالي أصبح ضروري ومصيري إدماج مفاهيم مثل المرونة، الاستباقية، إدارة الغموض في خطط الدول والشركات الكبرى.
وبالتالي فخلال (5 سنوات)، سيصبح التفكير النسقي مهارة حيوية في الإدارة والسياسة والتعليم، في مواجهة تسارع التحولات الرقمية والاقتصادية. أما خلال (10–15 سنة)، قد نشهد ظهور مؤسسات وطنية وإقليمية متخصصة في إدارة التعقيد المجتمعي، أما خلال (20–30 سنة)، سيصبح التعقيد نفسه إطارًا مرجعيًا جديدًا للتنمية، حيث ستقاس السياسات بقدرتها على التكيف والتعامل مع التشابك والغموض.
وبالتالي لابد من إعادة بناء التعليم، من التركيز على التخصص الضيق إلى إدخال العلوم البينية والنسقية، بالإضافة الى اعتماد أدوات استشرافية متقدمة، مثل النمذجة، المحاكاة، والذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بحث ومؤسسات تعنى بالتعقيد وإدارته، على غرار “مراكز الأنظمة المعقدة” في الدول المتقدمة.
واخيرا العمل على تغيير الثقافة المجتمعية، من خلال الدفع نحو القبول بالغموض وإدارته، بدل البحث عن إجابات سهلة لمشاكل معقدة.
إذا أسقطنا هذا التحليل على المغرب، فإننا نلاحظ، أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة ليست مجرد رد فعل ظرفي، بل انعكاس لتشابك بين التعليم، البطالة، الاقتصاد غير المهيكل، والخدمات الاجتماعية. كما أن التحديات الاقتصادية (الفقر المتعدد الأبعاد، القطاع غير المهيكل، الفوارق المجالية) هي أنساق معقدة تتطلب حلولاً نسقية لا قطاعية ضيقة.
ناهيك أن الفرص الكبرى (المبادرة الأطلسية، الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، الرقمنة) يمكن أن تتحول إلى روافع استراتيجية إذا تمت إدارتها عبر فكر معقد لا عبر مقاربة تجزيئية.
وبالتالي فإن التحدي الأول للمستقبل هو أن ننتقل من الفكر الاختزالي إلى الفكر النسقي المعقد، وبالتالي فالعالم لم يعد يحتمل العين الواحدة، بل يحتاج إلى رؤية مزدوجة ومتعددة الأبعاد. والمغرب، مثل غيره من الدول الصاعدة، مطالب ببناء قدرات جديدة لإدارة هذا التعقيد وتحويله من تهديد إلى فرصة.




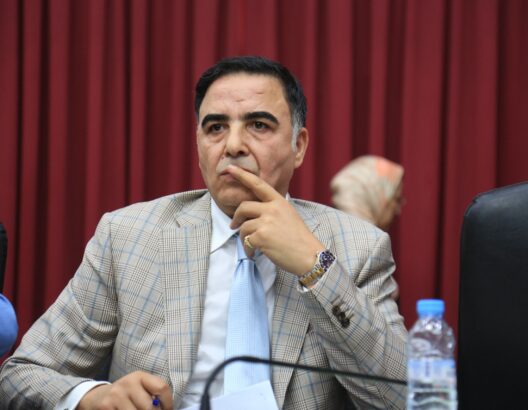
اترك تعليقاً