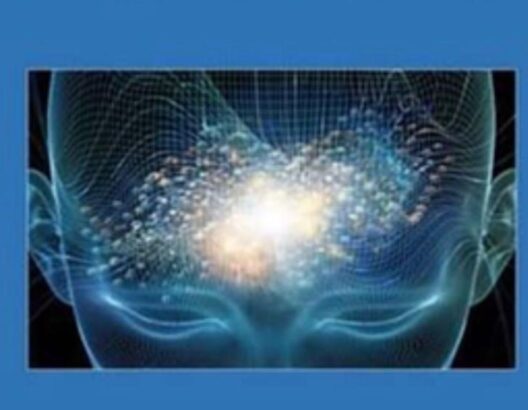فلسفة المسكنة

لقد خلق الله الكون وأودع فيه أسرارا و حقائق تحث الإنسان على اكتشافها وفهم رسائلها ، ثم جعلها نصا موازيا للنص المنزل من حيث الإعتبار و الدلالة ، فهي حسب اعتقادي تأثيت رباني له صفه الإيحاء واستجلاء وحي السماء ، فنقرؤها لنستشف سمياءها من خلال مشاهد محددة في التاريخ الإنساني أو عند تنقل النفس بين حالات متباينة ، فيتأتى لها أن ترسم الفروق عمليا بين الأعراض و الجواهر أو بين الوعي الجمعي و التصور العميق بمعيار نقدي ، وهذا الأخير لايتأسس إلا بالإنتقال من إدراك الحقيقة إلى تذوقها وإنسياب الروح داخل شكلها ، قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا و بالإسلام دينا ومحمد نبيا. فهذا المعيار الذوقي لايقبل أي قاعدة من قواعد الإجتماع التي تواضعت عليها المدنية ، وللتقريب سنأخذ عالم المسكين لنلج مفهومه بعمق ثم نقيم لها وصفا عرفانيا بعيدا عن التجريد الذي ينزع في كثير من الأحيان كنه الحقائق وجوهرها.
المسكين يدل في بعده الدلائلي على السكينة ، وهذا معنى دفين يدب في الروح دبيبا خفيا فيوقظ في العبد شعورا بأن هناك مساكن لامرئية تتوسل البحث عنها بمنهج الذوق ، فذكر الله مسكن للروح، تسري فيه سكينة المحبة و الشوق ، والتأمل العميق لتعاقب الليل و النهارمسكن للعقل يفضي به إلى استبصار علاقته بنظام الكون المتناغم و الدائب على حركة التغيير ، فتنفذ إلى قلبه سكينة الإحسان و العطاء دون حاجة إلى جزاء أو شكور من الخلق… فالسكينة هنا تربأ بنفسها عن فلسفة قارون أو فرعون فلا تستمد طاقتها من الهواجس التي ألف المجتمع على المقاربة بها ، بل مقاييسها مستقاة من العالم العلوي ، ولذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم على توطينها في النفوس كلما ناسب السياق و المقتضى ،ولعل من أعمق المشاهد التي سنحدد أبعادها هي حواره _صلى الله عليه وسلم_ مع الصحابي البدوي زاهر ، فلقد كان النبي يحل ضيفا عنده كلما خرج إلى حاشية المدينة فيقول : زاهر باديتنا ونحن حاضرته…، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سوق بالمدينة إذ رأى زاهرا فجاءه من ورائه وأغمض عينيه وقال : من يشتري العبد ، من يشتري العبد؟ فأدرك زاهر أن الرجل هو النبي ،فجعل يلصق ظهره بصدره صلى الله عليه وسلم باعتبار المحبة القائمة في نفسه ،ثم قال : إذن تجدني تجارة كاسدة. فأزال النبي صلى الله عليه وسلم يديه من عيني زاهر ليبصر النور المرئي وأتبعه بكلام نوراني آخر تمثل في قوله صلى الله عليه وسلم : ولكنك عند الله رابح.(القصة موجودة في صحيح مسلم)
إن قول زاهر للنبي صلى الله عليه وسلم : (تجدني تجارة كاسدة) لهو هاجس في النفس مقلق قد لبس قاعدة الإجتماع فصار مُؤذنا بإخلال عالم السكينة التي عهد النبي مناسمتها كلما حل عنده ، لذلك صارع صلى الله عليه و سلم إلى تحطيم هذه القاعدة و غرس معيار الذوق و استحسانه بقوله (ولكنك عند الله رابح) أي فلتلزم فلسفة المسكنة لتحيا بها ففيها السكينة رغم قلة المادة فيها ، ومنها العمق في العبودية و النسبة إلى الله تعالى دون إحساس بالدونية أو ضعف الشخصية ، وهذا يحيلنا على سر قوله صلى الله عليه وسلم : رب أشعت أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره .
والسكينة هي مادة السعادة و الهناء ، أسلوبها التعاطف و التراحم و الإيثار و الرضى ، ومسكنها أصالة الفقراء لا الأغنياء ، إذ يؤلفون نسق حياتهم ببساطة تجذب الروح إلى صفاء في الرؤية وترسم بالمحبة و الطمأنينة حدودها فلايعرفون معنى الكثرة المتلفة لفلسفتهم ،فالمسكين يدلك على قيمة الصفقات حينما تصير بين القلوب ، وإذا أراد المسلم أن يدرك جلال عالمهم فليصلي في مسجد من مساجد الأحياء المتواضعة ثم إذا قضيت الصلاة فلينظر من مسافة ليستغرق في فلسفة المسكين بطابع الإيثار ،فإنه سيبصر رجلا مسكينا في حاله وهيئته قد تصدق على مسكين مثله… فإذا حددنا هذا المشهد سيميولوجيا فإننا لن نفهمه إلا بطابع الله على قلب المسكين بنور السكينة لينبض محبة و شفقة على الآخرين ، ولذلك فرحمة الله لاتفارق المساكين ، إذ يعلل هذا مصطفى صادق الرافعي في كتابه المساكين الصفحة 9 : “ذلك بأنهم مادة الأخلاق و العواطف ،فهم في الإنسانية كالجيش يقذف به في المهالك لأنه وحده مادة النصر ، ولهذا فمن رحمة الله بالناس أنهم في الناس.” ومن هنا أيضا ندرك السبب الذي جعل أغلب الأنبياء متفيئين ظلال المسكنة و مغترفين لحياتهم من نمير فلسفتها ، فهي فصول نفسية حكمية وسمت التصورات و الرؤى بمنهج الذوق المنبثق عن الوحي ،فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه الدنيا لم يزهد فيها بإعتبار الفناء الملازم لها فقط ، وإنما أحاط علما بمكنون الروح داخل الجسد و المساكن التي تحب أن تلجها فتذوق حلاوة الأسرار الكونية ، فتكمل سفرها إلى العالم العلوي بفلسفة المسكنة متلقية مدد العرفان الإلهي و السعادة به ،ولذلك تروي لنا أمنا عائشة هذه الفلسفة النبوية في كثير من المشاهد لا للشفقة وإثارة العواطف ، ولكن للفهم و الإستيعاب…
إن جمال الكون قائم على البساطة ،و عمق النفاذ إلى شاعريتها وقدسية الألفة فيها يتأتى بتذوق الروح جلال الإخلاص بين الأرض و السماء ، فهما لا تفتران عن عملهما في نسج الحياة تحت إشراف الملإ الأعلى ، قال تعالى : “وتَرَى الأَرْض هَامِدَة ، فَإِذَا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا المَاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج” فعبق الآية تتلقاه أزاهير الروح باستحضار توقيعاته سبحانه المتناسقة و المنسجمة على مظاهر الجمال في ملكوته ، ثم بعلم مطلق أن الكون يعبر عن نفسه بخطاب التسبيح المستمد لغته من معجم الوحدانية المتفردة بالخلق و التدبير ، فتسكن الروح إلى شاعريته التي تسمو بالمرء إلى مقام الإستغراق في الذات و الوجود وهذا ما لا نستطيع الاستفاضة في وصفه إذ تنتاب النفس مواجيد متداخلة من المحبة و الخوف، و البكاء و الطمأنينة… لكنها تنير الجوانب المظلمة في الرؤى و التصورات وتحيي مواضع في الذاكرة قد طالها النسيان .
إن عُبَّادَ الدينار لايفهمون فلسفة المسكنة ،ولن يعرفوا إليها سبيلا ، فهم مقبورون داخل سرداب اللهفة و الجشع وهما أخطر القوانين التي تئد الطمأنينة و فهم عمق البساطة ، فتفسد أدنى مقاييس الذوق… ولذلك قد يسعدون بتعاستهم ، والإستدراج يفضي بهم إلى مسخ في أرواحهم بلعنة الكبر و البطر و الخيلاء ، فعلمهم متوقف على فهمهم ،وهذا الأخير يربأ بالتكافل و الإيثار و إيقاظ الوعي بالأمانة …لكن ،هل تقر نفوسهم إلى حياة ؟ وهل ترسوا سفن أيامهم على ساحل الهدوء و السكينة ؟