من يدفع ثمن فاتورة الابتزاز باسم فلسطين؟

التأمل العقلاني في قضية معقدة
في سياق يعجّ بالانفعالات السياسية والصراعات العاطفية، يهدف هذا التحليل إلى تقديم رؤية موضوعية بعيدة عن خطاب الاندفاع أو التحيز، اعتمادًا على العقلانية المنطقية والمنهجية العلمية في فحص أبعاد القضية الفلسطينية وتداعياتها على الأمن القومي المغربي.
إن تعقيدات المشهد السياسي الفلسطيني والإقليمي تستدعي ترويض العواطف وتجاوز الخطابات النمطية، لطرح تساؤلات جوهرية تثير التأمل وتفتح آفاقًا جديدة للفهم بعيدًا عن الانفعالات التي قد تعمّق الانقسامات وتقلّل من فرص الحلول البناءة.
عندما تتحوّل القضية من رمز إلى أداة
هل تستطيع قضية عادلة أن تصمد حين تُختزل إلى ورقة تفاوض في بازار النفوذ الإقليمي؟ وهل تُحفظ الذاكرة السياسية حين تُصادر إرادة الدول الوطنية باسم الولاء؟ في قلب هذا المنعطف الحاد في التاريخ العربي، تتعرض القضية الفلسطينية لتحولات عميقة في بنيتها التمثيلية ووظائفها الاستراتيجية، ما يدفع للتساؤل عمّا إذا كانت بعض الجهات، التي نصّبت نفسها وصية على هذه القضية، لا تمارس نوعًا من الابتزاز الأخلاقي والسياسي تجاه دول ساندتها طويلًا دون قيد أو شرط.
إن ما كان يُنظر إليه كقضية تحرر وطني، أصبح، في بعض تمظهراته، أداة تدخل وضغط تستخدمها قوى إقليمية لإعادة تشكيل موازين القوى. من هنا، تتعقد العلاقة بين التضامن والمساءلة، وتبدأ أزمة الثقة في التسلل إلى الخطاب العربي التقليدي حول “مركزية القضية”.
تحوّل الفاعل الفلسطيني: من موقع الضحية إلى موضع التواطؤ؟
متى يتحوّل الفاعل المقاوم إلى فاعل وظيفي؟ وهل يمكن لمن يحمل خطاب التحرر أن يتحالف مع من يمسّ بوحدة دول أخرى؟ الأسئلة تتكاثر حين نضع تحت المجهر تقاطع بعض الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة “حماس”، مع مشاريع توسعية تقودها قوى إقليمية مثل إيران، عبر شبكات تسليح وتدريب تشمل أطرافًا تُهدد الأمن القومي المغربي، كجبهة البوليساريو.
في هذا السياق، لم يعد ممكناً تجاهل التقارير المتقاطعة التي تشير إلى دعم لوجستي وعسكري لفصائل انفصالية تستهدف وحدة المغرب الترابية، بل وتجرّب قدراتها الصاروخية على تخوم مدن كـ”السمارة” و”كلميم”. فهل يمكن اعتبار هذا السلوك جزءاً من منطق “الممانعة”، أم هو انزياح خطير يُعبر عن اختلال في بوصلات المقاومة؟
التحول هنا ليس مجرد خطأ تكتيكي، بل انعكاس لبنية جديدة من الاصطفافات التي تعيد تعريف العدو والحليف، وتُنتج نسقاً تحالفيًا يتناقض مع ما ادّعته القضية في نشأتها الأولى: الدفاع عن الحرية والكرامة، لا تأبيد الازدواجية وتسييس المظلومية.
الدولة الوطنية في مواجهة منطق التوازي الاستراتيجي
هل يُطلب من الدول أن تظل رهينة لخطاب تاريخي متخشّب، بينما تُستهدف سيادتها من قبل فاعلين يُفترض أنهم في صفّها؟ هنا تدخل الدولة الوطنية، كالمغرب، في مأزق مركب: الحفاظ على التوازن بين التضامن القومي والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار من قبل جهات تُقدَّم في الخطاب العام كضحايا.
المعضلة لا تكمن فقط في صعوبة فرز النوايا، بل في ما تطرحه هذه الوقائع من تحديات نظرية: هل لا يزال ممكنًا الفصل بين القضية وكياناتها الحاملة؟ وهل تُمارس الدولة الوطنية حقّها في إعادة ترتيب أولوياتها الإقليمية دون أن تُتهم بالخيانة أو التواطؤ؟
المغرب، بإقدامه على إعادة تطبيع علاقاته مع إسرائيل، مارس فعلًا سياديًا يدخل ضمن حسابات استراتيجية داخلية وإقليمية معقدة. غير أن الردّ عليه لم يأتِ من إسرائيل، بل من أطراف يُفترض أنها “شريكة نضال”، لتُطرح بذلك مسألة جوهرية: أيهما أولى بالولاء، الذاكرة الأخلاقية أم الحاضر الأمني؟
تحولات الجغرافيا السياسية: حين يتشظى مفهوم “العدو”
في زمن تراجعت فيه الحدود الصلبة بين الجبهات، وأصبح مفهوم “العدو” نسبيًا، لم يعد مفاجئًا أن نجد تقاطعًا موضوعيًا بين من يقاتلون “إسرائيل” في غزة ومن يموّلون انفصاليين يهاجمون المغرب في الصحراء.
هل نحن أمام إعادة إنتاج لمنطق الحرب بالوكالة، تُستعمل فيه القضية الفلسطينية كبوابة لاختراق النظام العربي من الداخل؟ أم أن هذه الاصطفافات تعبّر عن انهيار المرجعيات القومية التي كانت تضبط العلاقة بين الشعوب والدول؟
التقاطع مع المشروع الإيراني ليس حدثًا عرضيًا، بل سياسة ممتدة توظف الفاعلين غير الدوليين كأدوات ضغط على الدول الوطنية. وبهذا المعنى، تصبح “حماس”، في بعض تجليات سلوكها، أقرب إلى وظيفة جيوسياسية منها إلى حركة تحرر وطنية، وهو ما يتطلب مساءلة من داخل المجال العربي، لا خارجه.
التضامن المشروط والمساءلة الأخلاقية
هل نملك، بعد اليوم، ترف الاستمرار في دعم غير مشروط، باسم ذاكرة باتت تُستغل ضد مصالحنا؟ وهل يمكن لفكرة فلسطين أن تظل عابرة للتناقضات بينما تُستخدم من قِبل بعض الفصائل كأداة ابتزاز استراتيجي؟
المطلوب اليوم ليس تنكرًا لفلسطين، بل تحريرها من التوظيف السياسي الإقليمي، وإعادة امتلاك القدرة على التمييز بين من يقاوم من أجل التحرر، ومن يتحايل على تلك المقاومة لخدمة مشاريع لا صلة لها بمصلحة الشعب الفلسطيني نفسه.
لقد تحوّل الصمت العربي عن هذه السلوكيات إلى نوع من “السكوت العميق”، يُعيد إنتاج العلاقة الزبائنية القديمة بين القضية والفعل السياسي، ويؤجل لحظة المواجهة مع خطاب لم يعد منسجمًا مع واقع التحولات.
خلاصة مفتوحة: نحو مراجعة المفاهيم لا المواقف
في لحظة شديدة الالتباس، قد لا يكون المطلوب إعلان قطيعة، ولكن لا يمكن أيضًا استمرار العلاقة على نحوها التقليدي. فالثمن لم يعد رمزيًا، بل أصبح أمنيًا واستراتيجيًا، يُدفع من استقرار الدول ووحدتها الترابية.
هل يمكن لفلسطين أن تظل “قضية جامعة” حين يُستعمل اسمها لشرعنة تدخلات مهددة لكيانات عربية؟ وهل تكون التضحية بها أقلّ فداحة من التضحية بسيادة الدول؟
ربما آن أوان المراجعة العميقة، لا في الولاءات بل في طرائق الفهم ومنهجيات الدعم. لا كي نُحدد من هو مع أو ضد، بل كي نستعيد القدرة على قول “لا”، حين تتحوّل الشعارات إلى أدوات قهر، والرموز إلى مطايا لتفكيكنا من الداخل


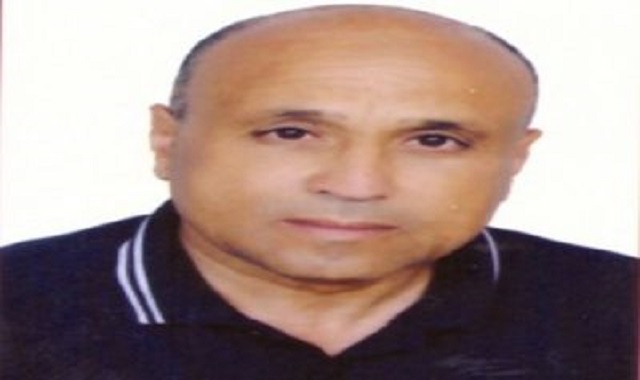


اترك تعليقاً